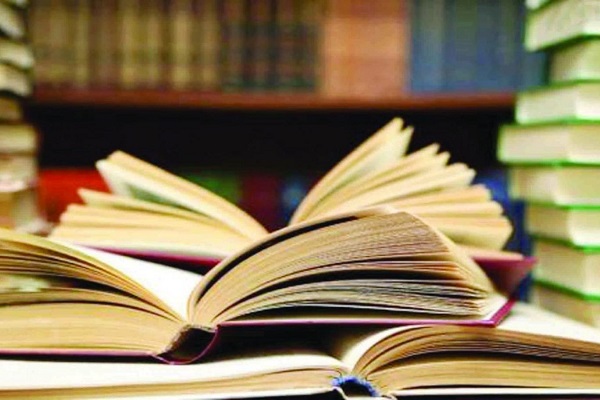
عبد الجليل الشافعي
القراءة في اللغة تعني الجمع والتوليف والضم، نقول: قرأ الشيء: أي جمعه وضمه إلى بعضه الآخر. (معجم الوسيط). ومنه قول الله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. (سورة القيامة، الآية 18).
كما تعني القراءة، أيضا، الإبلاغ والتوصيل، فإذا قال أحدهم: فلان قرأ عليه السلام، كان المقصود أبلغه إياه. (معجم الرائد).
وهناك دلالة لغوية أخرى للَّفظ تشير إلى معنى جدير بالتأمل، وهو معنى الولادة، إذ تقول العرب: (قرأت الحبلى: بمعنى ولدت. والولادة خلق، إضافة، استمرار، إنتاج..
وبتأملنا للمعاني اللغوية السابقة للفظة (قرأ) يمكن أن نستنتج التالي:
القراءة فعل يتقصَّد الجمع والضم والتوليف لتوليد المعاني، لإنتاج الأفكار والرؤى والدلالات، لتوليد حياة بديلة، أو الإضافة إليها… حياة متخيلة، موازية، محايثة، خاصة إذا تعلق الأمر بالقراءة الأدبية. ولعل ذلك، ما دفع «أمبرتو إيكو» إلى أن يعتبر أن (الطريقة التي نتصور بها العالم الواقعي لا تختلف عن تلك التي نتصور وفقها العوامل الممكنة التي يقدمها لنا كتاب في التخييل).
وبالتالي، فإن الأسئلة التي يمكن طرحها بهذا الصدد هي كما الآتي:
لماذا نقرأ الأدب؟
هل يحقق الأدب منفعة لقارئه؟
هل نقرأ الأدب للمتعة، لتجزية الوقت فقط، أم لشيء آخر؟
أسئلة متعددة يمكن أن نُصهرها في بوتقة سؤال واحد عام: ما جدوى قراءة الأدب؟
هذا السؤال يطرح كثيرا في الأوساط الأدبية والثقافية، في أكثر من مناسبة، وهو سؤال قد لا يروق الأدباء، عادة، لأنه يستبطن استنكارا لأهمية ما يفعل هؤلاء الأدباء -كتابة الأدب- لكنه، في نظري، سؤال مهم وله مبرراته الواقعية والموضوعية، في زمننا بخاصة، أكثر من أي زمن ولَّى، زمن الرقمي والتخصص والحياة المكوكية، السرعة والصراع اليومي واللانهائي من أجل العيش. وهو سؤال ينشدُ المغزى من وراء عملية القراءة المتعلقة بالأدب حصرا، وكأن هناك شبه اتفاق على أن قراءة غير الأدب: الفكر، الفلسفة، التاريخ، العلوم الحقة، هي قراءة نافعة بالضرورة. أما إذا تعلق الأمر بقراءة الأدب، هنا يتشكل السؤال، في اتهام مسبق، اتهام مستضمر وصريح: ما جدوى الأدب؟ وهل قراءته مهمة أم ثانوية؟
ما الذي سأجنيه من وراء قراءة رواية أو قصيدة أو نص قصصي…؟
هناك جواب غير متوقع وينطوي على نوع من المفارقة حين يتعلق الأمر بهذا السؤال، يطرحه «كلود روي»، إذ يقول: (لا فائدة ترتجى البتة من الأدب. إن فائدته الوحيدة تكمن في أنه يساعدنا على أن نحيا). وأي عظمة يمكن أن يقدمها فعل، شيء، مجال ما، أكثر من أن يساعد الإنسان على تقبل العالم، تقبله على عِلاته، ويحياهُ بل ويحبه!
الكثير من الناس في عالمنا العربي، وربما في العالم بأسره، يعتبرون قراءة الأدب فعلا نافلا، تكميليا، لاحقا، وبتعبير «ماريو فارغاس يوسا» هو مجرد (شيء يمكن وضعه بين الرياضيات أو الأفلام أو لعبة شطرنج، وهو نشاط يمكن أن نضحي به دون تردد حينما نرتب «أولوياتنا» من المهام والواجبات التي لا يمكن الاستغناء عنها في سعينا الحياتي الشاق).
إن قراءة الأدب، عكس ما هو شائع بين شرائح كثيرة من المجتمع، فعل غاية في الأهمية، حتى أن الذي ينفر منه، مع قدرته على ممارسته، شخص جدير بالشفقة، حسب «فارغاس» الذي يقول: (أشعر بالأسف للرجال، وللملايين ممن يستطيعون القراءة لكنهم اختاروا ألا يقرأوا. هم يستحقون الشفقة ليس فقط لأنهم يجهلون المتعة التي تفوتهم، بل، أيضا، لأني مقتنع بأن مجتمعا بلا أدب أو مجتمعا يرمي بالأدب _ كخطيئة خفية_ إلى حدود الحياة الشخصية والاجتماعية، هو مجتمع همجي الروح بل ويخاطر بحريته). فالأدب، إذن، يرقق طباع المجتمع، ويهذب نفوس أفراده، ويجعلهم أبعد عن حيوانيتهم، أقرب إلى إنسانيتهم. وهذا دور عظيم بحق.
وفي زمن الآلة والسرعة والمنطق الزئبقي الذي َينظِم مسرى الحياة المعاصرة، في زمن الانزواء والتقوقع على الذات رقميا، في زمن تخصص التخصص المعرفي الذي يزكي ويذكي الفكر الانفرادي الانعزالي، فإن الأدب يظل مجالا للمشترك، للإنساني، للكوني، للماكرو في عصر الميكرو، الأدب تجديف عكس تيار القوقعة والفكر النووي _من النواة_ تجديف ضد ‘الأنا’ المتورمة، ونحو ‘النَّحن’ الشاسعة الرحبة إذ (طالما كان الأدب وسيبقى واحدًا من القواسم المشتركة لدى التجربة البشرية، والتي يتعرف البشر من خلاله على أنفسهم وعلى الآخرين، بغض النظر عن اختلاف وظائفهم، خطط حياتهم، أماكنهم الجغرافية والثقافية، أو حتى ظروفهم الشخصية. استطاع الأدب أن يساعد الأفراد على تجاوز التاريخ، كقرَّاء لثرفانتس، شكسبير، دانتي وتولستوي. نحن نفهم بعضنا عبر الزمان والمكان، ونشعر بأنفسنا ننتمي لذات النوعية، لأن من خلال الأعمال التي كتبوها، نحن نتعلم ما نتشاركه كبشر، وما الذي يبقى شائعًا فينا تحت كل الفروقات التي تفصلنا).
الأدب، وفقا لهذا الفهم، يكتسي جدوائيته، بل وضرورته، ضرورته القصوى، من كونه: المجال القادر على التسامي على الواقع. وليست الفلسفة وحدها ما تفعل، كما يذهب إلى ذلك «غرامشي» لمَّا يقول: (الفلسفة هي تصور العالم الذي يمثل الحياة الفكرية والأخلاقية كتسامٍ لحياة واقعية عملية محددة).
كما أن الأدب قادر على تجاوز كل الفروقات الاجتماعية والدينية والعرقية والاثنية واللغوية والفكرية والثقافية… ويذكرنا، بأننا، في البدء، سبحنا من نفس الأصل، من منبع آدم، حين كان الوجود لا يزال صبيا..
هو كل هذا؟
بل وأكثر، شريطة أن يكون الأدب حقيقا، أدبا أصيلا وحفَّازا وشائكا، حيث (لا شيء يحمي الإنسان من غباء الكبرياء والتعصب والفصل الديني والسياسي والقومي أفضل من تلك الحقيقة التي تظهر دائمًا في الأدب العظيم: (حقيقة) أن الرجال والنساء من كل الأمم متساوون بشكل أساسي، وأن الظلم بينهم هو ما يزرع التفرقة والخوف والاستغلال).
الأدب، إذا نظرنا إليه من هذه القُمرة، ألفيناه قناة حقيقية تنبذ كل شر كامن في الإنسان، وتدعوه إلى أن ينمي الجانب الخير فيه، لأنه ضد الظلم بشتى تلاوينه، فالأدب هو (هذا الرابط الأخوي، الذي ينشأ بين البشر… يجبرهم على التحاور ويوعيهم بالأصل المشترك وبهدفهم المشترك، وبالتالي فهو يمحو جميع الحواجز التاريخية). كما أن له ميزة أساسية، إلى جانب ما ذكرنا، وهي أنه قادر على جعلنا نعيش حيواتٍ عديدة في الوقت ذاته، من خلال تكثيف التجارب الإنسانية والعمل على ‘توريثها’ للأجيال اللاحقة: (الأدب ينقلنا إلى الماضي، إلى من كان في العصور الماضية قد خطط، استمتع، وحلم بتلك النصوص التي وصلت لنا، تلك النصوص التي تجعلنا أيضًا نستمتع ونحلم. الشعور بالانتماء لهذه التجربة البشرية التراكمية عبر الزمان والمكان هو أعظم إنجاز للثقافة، ولا شيء يساهم في تجددها كل جيل إلا الأدب).
ومن العوامل التي تُكسب الأدب جدوائيته، أنه يعرفنا بالمجتمعات وما تتسم به من مميزات أكثر حتى من العلوم المتخصصة نفسها. لنتأمل قول «فريديريك انجلز» حول أدب بلزاك، ليتضح لنا الأمر: (في الكوميديا الإنسانية، يعطينا بلزاك التاريخ الواقعي والأكثر روعة للمجتمع الفرنسي، خصوصا المجتمع والعالم الباريسي، فهو يمسح كل تاريخ المجتمع الفرنسي. إني استطعت أن أتعلم _حتى في ما يتعلق بالجزئيات الاقتصادية «مثل إعادة توزيع الملكية الواقعية والشخصية بعد الثورة» أكثر من أي كتاب أو كتب للمؤرخين والاقتصاديين والإحصائيين المحترفين في مجموعهم).
لذلك، فمن الأخطاء التي تبخس حق الأدب، وتقزم دوره العامل في الفرد والمجتمع على السواء، دوره في التاريخ والجغرافيا، والتي تجاوزت التمثل وكادت تصير قناعة راسخة، هو قصْره على الجانب الإمتاعي الترفيهي. بالطبع الأدب فن، والفن من إشراطاته الأساس تحقيق المتعة، لكن الأدب الحقيقي، كما هو كل فن حقيقي، يتجاوز هذه الخصيصة، ليحقق ما هو أعظم وأبقى إذ (لا يوجد من يعلمنا أفضل من الأدب، إننا نرى، برغم فروقنا العرقية والاجتماعية، ثراء الجنس البشري، ولا يوجد ما هو مثل الأدب لكي يجعلنا نكافئ ونمجد فروقنا بوصفها مظهرًا من مظاهر الإبداع الإنساني متعدد الأوجه. قراءة الأدب الجيد هو مصدر للمتعة بطبيعة الحال، ولكنه أيضًا تجربة لنعرف من نحن وكيف نكون، بعيوبنا وبنقصنا، من أفعالنا وأحلامنا وأشباحنا، وحيدين وفي العلاقات التي تربطنا مع الآخرين، في صورتنا العامة الظاهرة لدى الآخرين أو في تجاويف وعينا السرية). أي أنه أداة معرفة، معرفة ماهيتنا وذواتنا، وله القدرة على تجسير العلاقة مع الآخر المغاير المكمِّل، لا الآخر العدو…
إضافة إلى كل ما سلف، لا بد أن نشير إلى عنصر مهم من عناصر تَميُّز الأدب عن باقي الحقول الأخرى، هذا العنصر يتمظهر في كونه المجال القادر على أن يجمع في حشاياه الشيء وضده، ويلحم النقائض والمتفرقات، دون أن يضع في حسبانه قضية البحث عن الحقيقي والنسبي: (هذا المجموع المعقد من الحقائق المتعارضة… تشكل جوهرًا للحالة الإنسانية. في عالم اليوم، هذا المجموع الضخم والحي من المعرفة في الإنسان لا يوجد إلا في الأدب. لم تستطع حتى فروع العلوم الإنسانية الأخرى – كالفلسفة أو الفنون أو العلوم الاجتماعية – أن تحفظ هذه الرؤية المتكاملة والخطاب الموَحَّد). بل نضيف أن العلوم الإنسانية مثل علم النفس والأنثروبوجيا وغيرهما، لولا الأدب تظل علوما جافة خالية من كل حياة، هياكل بدون روح، فالروح كامنة في الأدب…
إذا علمنا هذا، نستطيع أن نفهم لماذا اختار «سيجموند فرويد» أن يشتغل على النصوص الإبداعية، ويستنبط منها العديد من الظواهر والعقد (عقدة إلكترا، عقدة أوديب…) وأن نعرف عقدا أخرى، كالسادية والمازوشية… الأمر الذي يُسلمنا إلى الاعتقاد بأن الأدب سبيل لمعرفة مجاهل الروح الإنسانية والوصول إلى تجاويفها المواربة تحت جدار العقل أو الوعي أو المنطقي الصرف…
وهذه القدرة التي يمتلكها الأدب أكثر من غيره، تعود بالأساس إلى احتفاظه بصفة الفن، بمعنى أنه ظل عصيا على أن يوصف بالعلم. وصفته الفنية تمنحه هذه القدرة، القدرة على أن يعبر عن الكل الفسيفسائي حسب تعبير «جوليا كريستيفا»، الكل المنسجم والكل المتناقض أيضا: (بعض النقاد والمنظرين يودون تحويل الأدب إلى علم، وهذا ما لن يحصل أبدًا، لأن الكتابة التخيلية لم توجد لتبحث في منطقة واحدة من تجربة الإنسان. وُجدت الكتابة لكي تثري الحياة البشرية بأكملها من خلال الخيال، والتي لا يمكن تفكيكها، أو تجزئتها إلى عددٍ من المخططات أو القوانين دون أن تضمحل).
بين إذن، تبعا لما طرحناه في هذا المقال، أن الأدب حقل مفيد ونافع ومؤثر وضروري للفرد والمجتمع والحضارة جمعاء، مثله مثل باقي ضروب وفنون المعرفة المختلفة، ومن ثم، فإن قراءته ذات جدوى، بل هي مطلوبة. وإن نحن (أردنا أن نتجنب فقر خيالنا… فيجب أن نتصرف. وبعبارة أدق، يجب أن نقرأ) نقرأ الأدب.
//////////////////////////////////////////////////////////////////
وفي الختام نقترح ذكر أهم الوظائف التي يلعبها الأدب -إلى جانب ما تقدم- حسب الكاتب «ماريو فارغاس يوسا»، وذلك حسب الترتيب التالي:
1 الوظيفة اللغوية:
إن إحدى منافع الأدب للشخص في المقام الأول تكمن في اللغة. [و]المجتمع الذي لا يملك أدبًا مكتوبًا يعبر عن نفسه بدقة أقل، وأقل وضوحًا من مجتمع يحمي طريقة التواصل الرئيسية له، وهي الكلمة، بتحسينها وتثبيتها عن طريق الأعمال الأدبية. إنسانية بلا قراءة، ولا يصاحبها الأدب ستنتج ما هو أشبه بمجتمع صم وبكم، ناقص الفهم وذلك لعلته اللغوية. وسيعاني من مشاكل هائلة في التواصل نظرًا للغته البدائية. وهذا يقع على مستوى الأفراد أيضًا، فالشخص الذي لا يقرأ، أو يقرأ قليلًا، أو يقرأ كتبًا سيئة، سيكون لديه عائق: ستجده يتحدث كثيرًا ولكن المفهوم قليل، لأن مفرداته ضعيفة في التعبير عن الذات). كما أن الأدب يحفظ اللغة: الأدب ليس فقط متطلبا لمعرفة كاملة باللغة واستخدام أكمل لها، بل إن مصيرها مرتبط بشكل لا ينفصل بمصير الكتاب، ذلك المنتج الصناعي الذي يعتبر الكثيرون أنه قد عفا عليه الزمن.
2 الوظيفة التواصلية (والحياة الجيدة):
وهذا الأمر لا يعني وجود قيد لفظي فقط، ولكن أيضًا وجود قيد في الخيال والتفكير. هو فقر فكري لسبب بسيط، لأن الأفكار والتصورات التي يمكن من خلالها فهم حالاتنا لا يمكن لها التكون خارج الكلمات. نحن نتعلم كيف نتحدث بعمق وبدقة وبمهارة من الأدب الجيد. لن يجدي أي انضباط آخر في أي فرع من فروع الفن ماعدا الأدب في صناعة اللغة التي نتواصل بها. أن نتحدث جيدًا، أن يكون تحت تصرفنا لغة ثرية ومنوعة، أن نجد التعبير الملائم لكل فكرة ولكل شعور نود أن نتواصل به، يعني بالضرورة أن تكون جاهزًا للتفكير، أن تُعلم، أن تتعلم، أن تناقش، وأيضًا لأن تتخيل وتحلم وتشعر. بطريقة خفية، تردد الكلمات صداها في جميع أفعالنا، حتى تلك الأفعال التي لا يمكن أن نعبر عنها. وكلما تطورت اللغة، وذلك بفضل الأدب، ووصلت لمستويات عالية من الصقل والأخلاق، زادت من مقدرة الإنسان على عيش حياة أفضل.
3 الوظيفة العاطفية:
عمل الأدب حتى على صبغ الحب والرغبة والجنس بصبغة الإبداع الفني. لم يكن الشبق ليوجد بدون الأدب. الحب والمتعة سيكونان أسوأ بحيث تنقصهما الرقة والروعة. سيفشلان في تحقيق الحالة القصوى التي يمنحها الأدب. لذلك فإني لا أبالغ حين أقول إن الثنائي الذي يقرأ «بترارك، جونجورا أو بودلير» يقدران المتعة ويعيشانها… في عالمٍ أمي، لن يتعدى الحب والرغبة ما ترضى به الحيوانات، كما أنها لن تتجاوز الوفاء بالأساسي من الغرائز.
4 الوظيفة النقدية:
بدون الأدب، سيعاني العقل النقدي، وهو المحرك الحقيقي للتغيير التاريخي والحامي الأقوى للحرية، من خسارة لا تعوض. هذا بسبب أن الأدب الجيد كله متطرف، ويطرح أسئلة حادة عن العالم الذي نعيشه. في كل النصوص الأدبية العظيمة، وغالبًا دون قصدٍ من الكتّاب، توجد نزعة تحريضية.
5- الوظيفة النضالية (التغييرية):
الأدب لا يقول شيئًا لمن هم راضون بما لديهم، لمن يرون الحياة بما يعيشونها الآن. الأدب هو قوت الروح المتمردة، هو إعلان عدم الانقياد، هو ملجأ لمن لديهم القليل جدًا أو الكثير جدًا في الحياة. الشخص منا يبحث عن ملاذه في الأدب حتى لا يكون هادئًا ومطمئنًا. أن تركب جنبًا إلى جنب مع ذلك السائس الهزيل وذلك الفارس المرتبك في حقول لا مانشا، أن تبحر على ظهر حوت مع الكابتن إيهاب، أن تشرب الزرنيخ مع إيما بوفاري، أن تتحول إلى حشرة مع غريغور سامسا، هذه كلها طرقٌ اخترعناها لنجرد أنفسنا من أخطاء وإملاءات هذه الحياة الظالمة، هذه الحياة التي تجبرنا دائمًا أن نكون الشخص نفسه بينما نتمنى أن نكون مختلفين لكي نرضي رغباتنا التي تتملكنا.
6 الوظيفة التخييلية:
يهدئ الأدب هذا الاستياء الحيوي للحظات، لكن في هذه اللحظات الخارقة، في هذا التعليق المؤقت للحياة، هذا التوهيم الأدبي ينقلنا لخارج التاريخ، ونصبح مواطنين لأرض لا تنتمي للزمان، وبالتالي هي أرض خالدة. فنصبح أكثر حساسية، وثراء، وأكثر تعقيدًا وسعادة، وأكثر وضوحًا مما نحن عليه في حياتنا الرتيبة. عندما نغلق الكتاب ونتخلى عن الخيال الأدبي، نعود إلى وجودنا الفعلي ونقارنه بالأرض المذهلة التي غادرناها توًا. ويا للخيبة التي تنتظرنا! لكنَّ هناك إدراكًا هائلًا ينتظرنا، وهو أن الحياة المتخيَّلة من الرواية أجمل وأكثر تنوعًا، أكثر فهمًا وأقرب للكمال من الحياة التي نعيشها ونحن واعون، تلك الحياة التي تحدها الظروف وضجر الواقع. بهذه الطريقة، نرى الأدب الجيد الحقيقي دائمًا كهدام، كمتمرد، كمقاوم، هو تحدٍ لما هو موجود.








