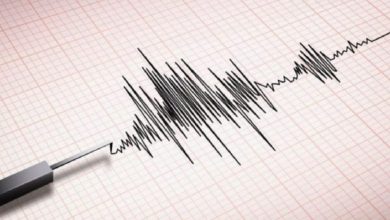سُفننا الغارقة في المُحيط
تضم معادن نفيسة وتحفا وتقدر قيمتها بملايين الدولارات

يونس جنوحي
«عندما حاصر البرتغاليون المغرب سنة 1574، وناضل المغاربة لاسترجاع المدينة، لم يتردد البحارة البرتغاليون في إغراق السفن المغربية لتجويع المغاربة وتفقير التجار، وحرمان خزينة المغرب من أموال الموانئ.
هذه السفن المغربية التي كان مصيرها الغرق، كانت محملة بالأموال والمعادن والسلع النفيسة، التي كان التجار المغاربة يحتكرون التجارة فيها على طول الساحل.
عمليات استخراج السفن الغارقة في قعر المحيط الأطلسي، والبحر المتوسط، لا تحظى بعدُ بالجدية المطلوبة. هناك وثائق أجنبية وأخرى مغربية كلها تؤكد أن السفن، مغربية وأجنبية، التي غرقت أو أغرقت في أغلب الحالات، قرب المغرب، تضم خزائن وحمولات لا تقدر بثمن.. وأغلبها تستقر في قعر المحيط منذ أكثر من أربعة قرون، وما زالت».
ملك فرنسا أمر بإنهاء أنشطة السفن المغربية.. واحتمال إغراقها كبير جدا
من الحقائق المنسية في التاريخ، أن الأسطول البحري المغربي الذي لم تكن كل سفنه وزوارقه رسمية، أتعب الفرنسيين وكبدهم خسائر فادحة في البحر.
الباحث المغربي محمد زروق، كان قد نشر سنة 1989 ورقة علمية غاية في الأهمية، اعتمد في دبجها على وثائق أرشيف المراسلات الرسمية الفرنسية في القرن الثامن عشر.
وتوصل إلى حقائق مهمة بشأن المخطط الفرنسي لوقف نشاط عمليات الجهاد البحري، التي أغرقت السفن الأجنبية في بعض الحالات.
يقول محمد زروق: «وفي سنة 1765 أصدر الملك الفرنسي لويس الخامس عشر أوامره إلى الأميرالchaffault ، للعمل على القضاء وبصفة نهائية على الجهاد البحري بالمغرب. وهكذا في 31 ماي رسا الأسطول البحري الفرنسي أمام سلا وشرع في رمي المدينة بالقنابل، انطلاقا من 2 يونيو، ورغم أحوال الطقس الرديئة آنذاك فإنه استمر في حصار المدينة، لكنه لم يفلح، وأمام فشله اتجه إلى العرائش في 27 يونيو، لكنه لقي هزيمة منكرة أياض.. وقد سجل أحمد بن المهدي الغزال هذه الحادثة بدقة كبيرة فوضعها على الشكل الآتي: «…رمى بمرمى ممن الأنفاط والبونيه ما ظن أنه يحصل به على طائل، فأجيب بضعف ذلك، فلم يلبث إلا وأجفانه هاربة تقفو أواخرها الأوائل، وخر هاربا مهزوما ساقط الألوية مذلولا مذموما، فعالج ما انصدع من أجفانه وأعاد الكرة يطلب حتفه بيده ويسعى في مذلته وهوائه، ووثب على مرسى ثغر العرائش..واقتحمها بالبنب والمدافع، وشحن القوارب العديدة بالشلظاظ والفسيان مما يزيد على الثمانمائة، ظنا أن ليس لهم بها مقابل ولا مدافع، وعبر المراسي بقواربه المشحونة بعساكره، قاصدا حرق مركب كان أخذ لهم قبل داخل الوادي، فأخلى المسلمون سبيله حيلة، حتى توغلوا في الموضع الذي لا يمكنهم الخروج منه، وركب لقطعهم من حضر من الحواضر والبوادي وقطعوهم قطعة لا يسعهم منه قرارا.. واستعملوا فيهم السيف فقتل وغرق وأسر منهم عدد كبير، فهم بين غريق وقتيل وأسير..». لكن القوات الفرنسية كانت مصرة على تنفيذ أوامر الملك مهما كلفها ذلك من ثمن، فظلت تحاصر قواعد المجاهدين في سلا والمهدية والعرائش، وتقطع سبيل الاتصال بين المجاهدين والعالم الخارجي، وهكذا فقد اعترضت قطع الأسطول الفرنسي سبيل سفن هولندية ودانماركية كانت محملة بالعتاد إلى السلطان وأرستها وقادتها على مدينة Toulon الفرنسية، وأمام هذه الوضعية عقد السلطان في 28 ماي 1767 معاهدة هدنة مع فرنسا، اعتبرها بعض المؤرخين الأجانب نهاية الجهاد البحري المغربي، مستنتجين ذلك من خلال الأحداث التي تلت هذه المعاهدة».
على كل حال، فإن الهدنة مع فرنسا لم تكن أبدا تعني توقف نشاط البحارة المغاربة، بل على العكس، فقد دخلت البلاد في دوامة أخرى، تمرد فيها بحارة بعض القبائل المطلة على الساحل، واعتبروا أنهم ليسوا معنيين بما جاء في نص الاتفاق بين السلطان وفرنسا، وواصلوا عمليات التعرض للسفن الفرنسية في عرض المتوسط والمحيط الأطلسي أيضا، وهو ما جعل فرنسا تُقدم على خطوة عسكرية دون الرجوع إلى السلطان، وهذه الخطوة تمثلت في إغراق السفن المغربية، وبعضها كانت محملة بغنائم «الحروب» التي كان يخوضها هؤلاء القراصنة البحريون في منطقة البحر المتوسط. كما أن الرد الفرنسي استهدف أيضا سفن الحجاج المغاربة المتوجهين إلى الديار المقدسة بحرا في ذلك التاريخ، وهو ما أدى إلى وقوع أعيان مغاربة، من سلا على وجه الخصوص، في الأسر، وبقوا على تلك الحال لأزيد من ثلاثين عاما، إلى أن أبرم الملك الفرنسي اتفاقا مع المغرب لتبادل الأسرى، وعاد المئات إلى المغرب.
بحارة مغاربة غرقوا مع سفنهم بسبب الحرب مع البرتغال
في عهد عبد الله الغالب تحديدا، الذي حكم المغرب ما بين سنتي 1557 و1574، جرت وقائع هذه الحرب لاسترداد المدينة من الاستعمار البرتغالي الذي استمر بها لسنوات، كان خلالها المغرب مجبرا على أداء غرامات مرتفعة للبرتغاليين، لذلك كان الانتصار في حرب «مازاغان» استردادا لكرامة المغرب، ووصلت أخبار الانتصار إلى أقصى الشرق، حتى أن المؤرخين كتبوا عنها واعتبروها انتصارا إسلاميا.
وحسب ما رواه المؤرخ البريطاني «جوناثان هانثر» الذي كان ما بين سنتي 1964 و1980، مهتما بتاريخ حروب ضفتي المحيط الأطلسي وألف عنها كتابه «تاريخ المحيط المنسي»، فإن معركة «مازاغان» التي انتصر فيها المغرب استمرت لأسابيع طويلة وانتصر فيها المغرب على مراحل، انتهت بالانسحاب النهائي للبرتغاليين، بعد أن تركوا وراءهم سفنا مخربة ومؤنا محروقة عن آخرها، ولم يحدث الانسحاب إلا بعد أن تأكد قادة جيش الملك البرتغالي من أنه يستحيل التقدم عسكريا على مستوى سور المدينة. ومما وصف به هذا الباحث تلك الحرب، حسب ما توفر لديه في وثائق الأرشيف: «انتصار قوات الملك المغربي عبد الله السعدي الذي حاز لقب «الغالب»، كان تشريفا دينيا، واعتبر معجزة في تلك الفترة، بحكم أن الجيش البرتغالي كان متقدما جدا مقارنة مع نظيره المغربي. نتحدث هنا عن أزيد من خمسة آلاف سفينة حديثة بمعايير ذلك الوقت، كانت مزودة بمدافع قوية لم يكن يتوفر عليها المغرب.
كان البرتغاليون يسيطرون على المدينة ويطوقون مداخلها ومخارجها لسنوات، ويستغلون ميناءها لاستيراد السلع من إفريقيا وتصديرها صوب البرتغال، دون أن يدفعوا لخزينة الدولة المغربية. ونشأت عداوة كبيرة بين البلدين لهذا السبب، تم استثمارها على مستوى الجيش المغربي الذي كان يتكون من مجاهدين وليس من جنود يتلقون أجورا في آخر الشهر فحسب. كانت معركة استرجاع المدينة في عهد السعديين، حيث كانت الدولة المغربية وقتها تسيطر على تجارة السكر، وتقيم علاقات وطيدة جدا مع بريطانيا، مصيرية لأنها تهدد مستقبل الدولة.
استمر التحضير للمعركة من الجانب المغربي على مستوى الأرض، وأيضا على مستوى البحر. حيث برزت قوات السعديين قادمة من تارودانت في اتجاه «مازاغان»، بينما قوات أخرى تحركت بحرا. أسطول مكون من مئات السفن المغربية، رجالها يحملون سيوفهم وعلى استعداد للانقضاض على سفن البرتغاليين، التي كانت ترسو بهدوء فوق مياه «مازاغان». اختلف المؤرخون في تحديد مدة المعركة، إلا أنها كانت تتجاوز الثلاثة أسابيع».
هناك من تحدث عن حصار للبرتغاليين استمر لأشهر، لكن الرواية التاريخية الأقوى من حيث المصادر، تؤكد أن المغرب استغل الطقس الممطر، وطوق الجديدة ومنع البرتغاليين من الوصول إلى المياه ومن التزود بالدعم من البرتغال، واستمرت المواجهات، قبل أن يعلن البرتغاليون استسلامهم وانسحابهم النهائي من «مازاغان»، بعد أن تم تدمير مينائها بالكامل بسبب القصف.
وهناك إشارات تاريخية مهمة، خصوصا في المصادر الفرنسية، تؤكد أن البحارة المغاربة تضرروا كثيرا بسبب الحرب مع البرتغال، ولم يتم إحصاء السفن والزوارق المغربية التي أغرقها البرتغاليون أثناء محاولتهم الضغط على المغاربة للاستسلام. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن التجار المغاربة تضرروا أكثر، بسبب حوادث إغراق السفن المغربية على السواحل، بمدفعيات برتغالية. إذ إن هذه السفن كانت محملة بتجارة هؤلاء الأعيان المغاربة، ومنهم من كتبوا وقتها إلى السلطان، وطلبوا منه أن يُعوض المخزن ضحايا هذه الحرب البرتغالية، حتى لا تؤثر الحوادث على الأسواق المغربية، بسبب غرق سفن التجار المغاربة بحمولتها في قاع البحر.
هل هناك سفن غارقة قُرب جبل طارق؟
طالما ارتبط مضيق جبل طارق بقصص عبور الأوروبيين إلى المغرب، والعكس. على امتداد قرون طويلة، ظل هذا المضيق مسرحا لأحداث تاريخية صنعت العالم الذي نعيش فيه اليوم.
وهناك احتمال كبير، بحكم المعارك التي دارت رحاها هناك، أن تكون هناك سفن غارقة في آخر نقطة حدودية للبحر الأبيض المتوسط، قبل أن يعانق المحيط الأطلسي.
وما يؤكد فرضية وجود سفن غارقة، المعارك التاريخية التي دارت رحاها في النقطة الفاصلة بين المغرب وأوروبا، على مستوى مضيق جبل طارق. وأكد عدد من الدبلوماسيين الأجانب، في مراسلاتهم هذا المعطى، ما بين سنتي 1817 و1860. وأحد هؤلاء الدبلوماسيين الأجانب، هو البريطاني «دريموند هاي».
سبق في «الأخبار» أن تناولنا مؤلف المؤرخ البريطاني د. روجرز، الذي أرخ للعلاقات المغربية البريطانية منذ عهد السعديين إلى حدود سنة 1900، وتناول مسألة المساعي البريطانية لحل الخلافات الأوروبية مع المغرب، خصوصا في مسألة الأسرى. وهذا ما يعني أن مواجهات قد وقعت في قلب البحر المتوسط، خسرها الأوروبيون واقتيدوا بموجبها، أو من نجا منهم إلى طنجة ووقعوا في الأسر، إلى أن أطلق المغرب سراحهم بموجب الاتفاقيات.
في 1817، ومع تعاظم قوة إنجلترا وسيطرتها على مضيق جبل طارق، خاف السلطان سليمان من ذلك الامتداد، وحد من عمليات القرصنة البحرية، ولم تعد سفنه تمارسها بالأشكال السابقة وإنما بسرية، ولم تنته إلا في 1856، عندما نجح السير جون دريموند هاي في تحرير جميع العبيد والمسجونين».
السيد دريموند هاي، لم يكن مجرد دبلوماسي أوروبي مرموق، وإنما كان أيضا خبيرا بشؤون «المخزن» المغربي. لقد كان أيضا مفاوضا جيدا، رغم أنه في النهاية حاول تقديم نفسه، أو هكذا أراد أصدقاؤه أن يقدموه، على أنه بطل قومي نجح في إرغام المغرب على إنهاء وضعية الأسرى الأجانب، سيما الإسبان في المغرب. لكن الرجل في الحقيقة كان أيضا يخدم مصلحة المغاربة، لأن القصر في عهد المولى سليمان، وحتى في عهد المولى الحسن الأول، كان يعلم أن الأسرى الأجانب لديه، كانوا قنبلة موقوتة من شأنها أن تقلب التخطيط لسياسات المغرب وعلاقاته بالخارج، لذلك فضل المغاربة في محطات تاريخية كثيرة إنهاء الأمر بالسماح للأسرى بالعودة إلى بلادهم، وطي الخلاف نهائيا.
بعض المغامرين الأجانب أيضا، اعترفوا في أوروبا بتهريب التحف من المغرب إلى إسبانيا، وفرنسا على وجه الخصوص. إذ كان ميناء مارسيليا مسرحا لعمليات إفراغ سفن من حمولات «غير قانونية»، خصوصا في القرن التاسع عشر، نجح أصحابها في تهريب تحف مغربية إلى أوروبا.
وما يؤكد هذا المعطى، وجود مقتنيات مغربية لا تقدر بثمن في متاحف فرنسا، يُحيط غموض كبير بالطريقة التي وصلت بها إلى هناك. وهو ما يؤكد فعلا أن السفن، خصوصا منها التي كانت تابعة للخواص وليس للحكومات، نقلت حمولات ثمينة صوب أوروبا. وبالتالي فإن وقوع الحوادث يبقى واردا جدا، سيما وأن الإبحار خلال القرنين 18 و19 كان وقتها محفوفا بالمخاطر، وبالتالي فإن غرق سفينة بحمولة ثمينة كان واردا جدا.
اليوم، توجد في مدينة طنجة نصب تذكارية لحفظ ذكرى غرق سفن بريطانية وألمانية في السواحل المغربية، وتحمل النصب أسماء المواطنين الإنجليز والألمان الذين فقدوا حياتهم، بسبب تحطم سفنهم ليلا قرب الصخور من جهة غرب طنجة. وهؤلاء المواطنون كانوا من نخبة أثرياء بَلَدَيْهِمْ في ذلك الوقت، إلى حدود سنة 1907، التي سجلت فيها حادثان من هذا النوع.
هؤلاء الركاب الذين كان مصيرهم الغرق، لم يكن مستبعدا أبدا أن يكونوا وقتها محملين بأغراض ثمينة مثل اللوحات الفنية، والقطع الذهبية والفضية، والحلي وأيضا النقود الذهبية، فقد كان شائعا وقتها أن تنقل العائلات ثروتها من أوروبا صوب طنجة الدولية، ولا شك أن حوادث الغرق المسجلة رسميا في السجلات، شملت غرق سفن من النوع المحمل بثروات تقدر اليوم بملايين الدولارات.
معاهدة بين المغرب وإسبانيا قلّصت حوادث إغراق السفن قبل 150 سنة
العلاقات المغربية الإسبانية مرت بفترة عصيبة جدا، قبل إبرام اتفاق الصلح بين البلدين في عهد المولى محمد الرابع، الذي توفي سنة 1873. حتى أن المؤرخين اعتبروا أن أهم إنجاز في عهد هذا السلطان الذي ناضل لإبقاء المغرب خارج مظلة دول أوروبا وشباكها، هو هذا الاتفاق الذي ساعد على حقن الدماء وتقليص مخاطر البحر.
ورغم أن مضامين المعاهدة كانت تخدم مصالح الإسبان أكثر مما تحمل الخير للمغرب، إلا أن أهم ما جاءت به تلطيف الأجواء في ما يتعلق بالملاحة البحرية، بعد أن تكبد البحارة المغاربة خسائر فادحة، بسبب إغراق سفنهم على يد البواخر الإسبانية العملاقة والمتقدمة.
غرقت سفن مغربية كثيرة في عهد المولى محمد الرابع، وبعضها كانت محملة بثروات الأثرياء المغاربة الذين تنقلوا من الصويرة صوب الجديدة. وبعض هذه السفن سُرقت، أو ضُربت في السواحل المغربية بقصد إغراقها بما فيها ومن فيها أيضا.
في عهد محمد الرابع دائما كانت العمليات البحرية، خصوصا قبل توقيع الاتفاق مع الإسبان، تعرف معارك كبيرة ضد الأوروبيين، غنم فيها المغاربة وكبدوا البحارة الإسبان والإنجليز أيضا خسائر كبيرة. إلى درجة أن الاتفاق الموقع بين السلطان محمد الرابع وإسبانيا، كان مكتوبا بلغة «العقوبة» للمغرب لتعويض البحارة الأجانب عن خسائرهم. في حين أن المغاربة تضرروا أيضا من عمليات إغراق سفنهم، التي كانت بدون شك محملة هي الأخرى بمواد نفيسة.
هذا الواقع، استمر حتى بعد توقيع الاتفاق مع الإسبان، ولم يكن ممكنا للسلطان محمد الرابع السيطرة على تصرفات البحارة، الذين اعتبرهم الأوروبيون «خارجين عن القانون» و«قراصنة»، لأنهم قرروا مواصلة «الجهاد البحري»، حتى مع توقيع المغرب لتلك الاتفاقيات. وهو ما استمر عليه بحارة الناظور، وسلا، ثم الصويرة بصورة أقل.
وهنا نُذكر بقصة المولى محمد الرابع مع الأمريكيين، ودهاء موظفي المخزن المغربي الذين احتووا غضب الأمريكيين، بسبب اعتداء على سفن أمريكية في عرض المتوسط، على يد قراصنة من طرابلس ظهر في ما بعد أنهم كانوا مدعومين من المغرب عن طريق الجهاد البحري.
وهو الأمر الذي جعل هذه القبائل تراكم أموالا طائلة بفضل العمليات البحرية، التي كانت تقوم بها لإيقاف السفن الأجنبية التي كانت تعبر المياه الإقليمية المغربية.
بعض تلك السفن كانت مملوكة لجنسيات أوروبية، ومنها سفن أمريكية، كانت قادمة من آسيا، وتعرضت لهجومات في إطار الجهاد البحري، أو «القرصنة» البحرية كما كان يسميها الأجانب. وقد قدموا شكاوى إلى الدولة المغربية في الموضوع، في حين أن البرتغاليين والإسبان توعدوا برد عسكري عنيف، ما لم يتدخل المغرب لردع تلك القبائل وثنيها عن مهاجمة السفن الأجنبية، التي كانت تنقل الذهب من بعض الدول الإفريقية صوب المغرب.
لقد كان مُربكا للدبلوماسية المغربية في عهد محمد الرابع، الذي شهد عهده تقدما في مجال العلوم وانفتاحا على الدبلوماسية، عندما أرسل سفيره الشهير السلاوي إلى فرنسا في مهمة رسمية، أن يكون هناك بالمقابل عصيان للدولة عن طريق الجهاد البحري الذي كان يحظى بدعم من الدولة في وقت مضى.
1817.. حين أراد «مولاي سليمان» توقيف عمليات البحر
جاء في مذكرات الكاتب الإنجليزي «ل. هاريس»، في قراءته للأوضاع في المغرب، ما يلي: «في 1817، ومع تعاظم قوة إنجلترا وسيطرتها على مضيق جبل طارق، خاف السلطان سليمان من ذلك الامتداد، وحد من عمليات القرصنة البحرية، ولم تعد سفنه تمارسها بالأشكال السابقة وإنما بسرية، ولم تنته إلا في 1856، عندما نجح «السير جون دريموند» في تحرير جميع العبيد والمسجونين. كان هذا في أيام مولاي الحسن، السلطان والد مولاي عبد الحفيظ وعبد العزيز.
في عهد مولاي الحسن كانت الضرائب تجمع بالقوة من كافة ربوع البلاد، وكان يفرض على أهل القرى والبوادي توفير طعام الجيش أينما حل وارتحل. رتب مولاي الحسن لطريقة يتعامل بها مع القواد والسيطرة عليهم، والأهم.. أنه كان يهزم المسيحيين. كان مثالا على تفوق المغاربة وتواضع العظمة البريطانية أمامهم».
كان معروفا عن المولى سليمان احتياطه الكبير من الأوروبيين، فقد رأى كيف أن العمليات البحرية للإسبان والبرتغال قد أضرت كثيرا باقتصاد مدن الساحل، التي كان المغرب يعول عليها كثيرا لإنعاش خزينة الدولة.
المولى سليمان تضرر مباشرة من التجار الأجانب الذين رفضوا في وقت من الأوقات أن يدفعوا ضرائب للدولة، بحجة أنها لا توفر الحماية للسفن التي تنقل أموالهم وسلعهم إلى المغرب. حتى أن بعض المؤرخين المغاربة أشاروا إلى احتمال ادعاء هؤلاء التجار تعرضهم لاعتداء في السواحل المغربية، حتى يمتنعوا عن أداء ما في ذمتهم من ضرائب.
إلا أن هذا كله لا يمنع من التأكيد على أن سفنا أجنبية قد تعرضت لاعتداء في عرض البحر، ومنها سفن غرقت في عهد المولى سليمان، حسب ما يشير إليه المؤرخ البريطاني السيد روجرز، الذي رصد جل محطات الشد والجذب بين بريطانيا والمغرب في ما يتعلق بالتجارة. حتى أن أصحابها فضلوا إغراقها في عرض البحر، على أن يستولي المغاربة على حمولاتها الثمينة، خصوصا السفن القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء، والتي كانت في العادة محملة بالذهب والتبر وبعض المعادن النفيسة الأخرى.
وهذا يعني أن سواحل آسفي والصويرة وصولا إلى «مازاگان»، وكلها موانئ رئيسية صنعت مجد الملاحة المغربية والتجارة، لا بد وأن تضم ما تبقى من حطام هذه السفن. وهو ما يتأكد مع بروز أخبار بين الفينة والأخرى، تؤكد العثور على حطام سفن برتغالية أو إسبانية قرب هذه السواحل.
الخبراء يرجحون أن تكون هناك سفن أخرى غارقة بالقرب من السواحل المغربية المذكورة، بالإضافة إلى سفن أخرى على بُعد كيلومترات في عُرض المحيط، حاول أصحابها تهريبها من مجال نشاط القرصنة البحرية، ثم غرقت أو اختفت نهائيا، بسبب رداءة الأحوال الجوية، ولم يظهر لها أثر نهائيا، وهو ما يعني أنها لا بد وأن تكون غارقة في المحيط بحمولاتها.
المستيري وحكم والسلاوي.. من أثرياء البحر الذين أغرقوا السفن الأجنبية
يبقى الباحث المغربي محمد زروق، أحد أبرز من اشتغلوا على تاريخ الجهاد البحري، ورصد بالوثائق والمراسلات السلطانية، تاريخا حافلا بأحداث أغرق فيها المغاربة سفنا إسبانية وأخرى برتغالية في عرض البحر، كانت محملة بالغنائم.
حتى أن بعض «الروايس» من ممارسي هذا النشاط البحري الذي اعتبره الأوروبيون قرصنة، كانوا يتحسرون على إغراق هذه السفن الأجنبية، وتمنوا لو أن لديهم الإمكانيات لإفراغ السفن من محتواها قبل إغراقها، أو الغوص لانتشال حمولاتها بعد غرقها بمن فيها.
وهذا لا يعني أن المغاربة لم يكونوا قادرين على مواجهة أطقم السفن الأجنبية ومصادرة ما يحملونه على متنها قبل إغراقها، بل سُجلت حالات كثيرة لسيطرة بحارة مغاربة على سفن أجنبية، وأسر طاقمها، مثل ما وقع في عهد المولى إسماعيل ما بين سنتي 1670 و1727.
يقول الباحث المغربي محمد زروق: «تقوى الأسطول المغربي في هذه الفترة أيضا من طريق الغنائم التي كان يحصل عليها المغاربة نتيجة عملياتهم البحرية المتكررة»، وهذا ما أشار إليه بكل وضوح محمد الضعيف وهو يصدد الحديث عن أعمال السلطان الجهادية: «..تكاثرت سفنه في البحر من أهل سلا ورباط الفتح وأقبلت عليه الأيام…وكان الرايس من أهل سلا والرباط يقدمون عليه بمراكش بالنصارى الأسرى في كل سنة، مثل الرايس العربي المستيري والرايس عواد السلاوي والرايس العربي حكم وغيرهم. وهؤلاء كلهم بالسفن وكلهم يأتون إليه بسفن النصارى إلى مراكش..»، ويقول في مكان آخر: «…وفد (السلطان) على رباط الفتح وسلا فوجد الرايس محمد عواد مانطة السلاوي، والرايس محمد عواد المعروف بقنديل السلاوي، والرايس العربي المستيري الرباطين أتوا بسفينة مغنومة من جنس السويد..ثم سافر القائد العربي المستيري في الحين، فغنم اثنين من السفن، واحدة من جنس البرطقيز والثانية من جنس السويد».
وكان من نتيجة الجهود الجبارة التي بذلها السلطان أن تقوى الأسطول المغربي في عهده، وأصبح بإمكانه تقديم المساعدة إلى الأتراك العثمانيين أنفسهم: «ثم إن السلطان – نصره الله- سمع بجور النصارى على السلطان، عبد الحميد العثماني – أيده الله – فأراد إعانته على الروم. وأصدر أمره للحاج المكي على أن يرجع ويتهيأ ليأتي بالسفن هدية من السلطان – أيده الله تعالى – إلى العثماني، وأن يقف على السفن بالعرائس، وصار يمد العثماني بالبارود وملح البارود نحو الأربعة آلاف قنطار بارود ومثلها ملحا لطنجة، ومنها تسير للعثماني – أيده الله».
هذه المعطيات تكشف إلى أي حد كانت هناك ثروات تُحمل على متن السفن، وإلى أي حد كانت السواحل المغربية تعرف رواجا ملاحيا. وهو ما يقوي فرضية أن يكون حطام السفن الغارقة أكبر بكثير مما توقعه الخبراء والمؤرخون المغاربة، وحتى الأجانب.
إذا كان هؤلاء «الرياس» المغاربة قد تأكد فعلا أنهم اغتنوا من وراء الجهاد البحري، فلا بد أن المرات التي لم ينجحوا فيها في الوصول إلى حمولات السفن الأجنبية، تبقى أكثر من المرات التي غنموا فيها. وهذا يعني مباشرة أن حطام السفن في السواحل المغربية، لا بد وأن يُعاد النظر في طريقة التنقيب عنه لاستخراج التحف الغارقة. وحدهم الباحثون والمؤرخون يُدركون أهمية الوصول إلى محتويات حطام السفن، إذ لا يقتصر الأمر فقط على قيمة الذهب والمعادن النفيسة التي كان ينقلها البحارة في ذلك الوقت، بل أيضا على كم المعلومات التي يمكن الوصول إليها، بعد فحص حمولات هذه السفن.