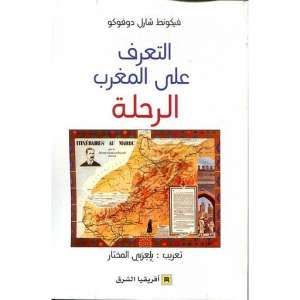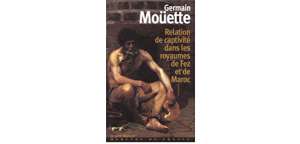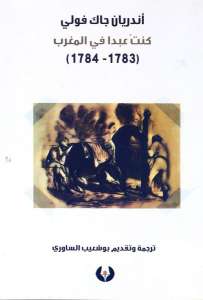كان المغرب، منذ بدء المرحلة الاستعمارية، مجالا خصبا للكتابة من قبل الأوروبيين مستكشفين ومغامرين وسفراء وفنانين وحتى الأسرى الأوروبيين الذين دوّنوا مذكرات أسرهم. زاد من هذا الاهتمام والولع الشديد أن المغرب ظلّ لأكثر من قرنين متمنعا عن كل اختراق لأرضه متبعا سياسة الانغلاق والاحتراز من أي تواصل مع العالم، خاصة القوى الاستعمارية الوليدة. كلّ ذلك جعل من المغرب بلدا تلفّه الأساطير والكثير من الأسرار الحقيقية أو المتوهمة ألهبتها كتابات قليلة لكنها كانت كافية لتجعل منه موضوعا مغريا بالكتابة والاكتشاف. سعت الدول الأوربية الطموحة إلى المزيد من المستعمرات والصراع في ما بينها إلى تشجيع مجال البحث والاستكشاف في كل ما يخصّ المغرب عن طريق مؤسسات وهيئات منظمة من أجل غاية واحدة، أن تساهم كل هذه الجهود في تسهيل عملية استعمار ما تبقى من شمال إفريقيا. هكذا توالت الكتابات والرحلات الاستكشافية إلى المغرب التي كان طابعها الأساسي كولونياليا بمظهر علميّ في شتى المجالات، هذه الشخصيات الاستعمارية أصبحت هي الأخرى مرتبطة بالمغرب وبالأحداث التي سيشهدها في المراحل التاريخية التالية.
إعداد وتقديم: سعيد الباز
شارل دو فوكو.. أخطر الرحالة الاستعماريين الفرنسيين
فيكونط شارل دو فوكو (1883-1916) Charles de Foucauld من عائلة أرستقراطية توارثت المناصب الرفيعة في الجيش الفرنسي. عمل ضابطا في الجيش خلال الاحتلال الفرنسي للجزائر، وعرف عنه مغامراته النسائية وميله إلى حياة اللهو والمتعة ما كان سيعرضه إلى الطرد. لكنه قرر فجأة القيام برحلة استكشافية إلى المغرب بطريقة مغايرة لسابقيه تجنب فيها المدن والحواضر المعروفة واهتم بالمناطق المجهولة بالنسبة للأوروبيين في رحلة قصيرة وخاطفة تمتد لما يقارب أحد عشر شهرا من يونيو 1883 إلى ماي 1884 متنكرا في زيّ يهودي صحبة دليل يهودي مغربي أصله من منطقة «أقا» يدعى الربّي مردوخ أبي سرور. يقول شارل دو فوكو عن ذلك: «ألقيت نظرة على الزي اليهودي. بدا لي أنّ هذا الأخير سيمكنني من المرور دون لفت انتباه أحد، وسيمنحني حرية أكبر. لم يخب ظني». نجح دو فوكو في رحلته «التعرف على المغرب» التي تعد أخطر ما كتبه الأوروبيون عن المغرب في دقتها ومعلوماتها الجغرافية الهائلة. بعد عودته عاش دو فوكو، ذو النزعة الوضعية في التفكير والكتابة، أزمة روحية اختار فيها حياة النسك والرهبنة حتى مقتله الغامض في جنوب الجزائر… رغم مهمة شارل دو فوكو الاستعمارية نجد لديه صراعا روحيا سيفسّر تحوله إلى الرهبنة في قوله: «لقد ولَّد الإسلامُ فيَّ انقلابًا عميقًا. إن رؤية هذا الإيمان وهذه النفوس التي تعيش باستمرار في حضرة الله جعلتْني أرى أن هناك شيئًا أعظم وأحق من الاهتمامات الدنيوية الباطلة، فأخذت أطَّلع على الدين الإسلامي، ثم على الكتاب المقدس». لم يكن دو فوكو مهتما بالمدن المعروفة التي سبق أن كتب عنها غيره، وإنّما كانت غايته الأساسية زيارة الأماكن المجهولة والتعرّف على سكان البوادي في السهول والجبال المنعزلة، من خلال نشاطهم الاقتصادي وعلاقتهم على الخصوص بالسلطة المركزية. كان دقيقا في عمله كأيّ جاسوس محترف، يدوّن يوميات رحلته في دفاتر صغيرة وأقلام رصاص، يخفي بعناية آلاته العلمية ورسوماته وخرائطه عن أعين الجميع حتّى اليهود المغاربة، الذين من المفترض أنّه يهودي مثلهم، بل كان يضمر لهم الكثير من الكراهية والعداء وخاصة دليله موردخاي أبي سرور.
من نماذج يوميات رحلته من أكادير إلى الصويرة (موغادور) يكتب في صفحة 246: «23 يناير الذهاب في الساعة 9 يسترسل نفس السهل، حيث كنت منذ ما قبل الأمس، من هنا إلى «أكادير إغير» تكسوه المزروعات والمراعي، وتنتشر هنا وهناك السدرة وقد انمحت أشجار الأركان. أصبح البلد خاليا في الساعة العاشرة و30 دقيقة، دخلنا في دغل من أشجار وأحراش، أشجار أركان صغيرة وعنب بري. وجدت على جانب البحر في الساعة 11، بعد اختراق بعض التلال الرملية علوها ما بين 8 إلى 10 أمتار. سرت محاذيا للبحر حتى أكادير. يمرّ الطريق عند عالية المدينة في منتصف الطريق بينها وبين فونتي Founti: هذا الأخير كَفْرٌ بائس يتكوّن من بضعة أكواخ للصيادين، وأكادير –رغم سورها الخارجي المجيّر الذي يضفي عليها مظهر المدينة- بلدة فقيرة هجرها السكان وبدون تجارة حسب ما قيل لي. اتبعت الشاطئ انطلاقا من هنا، سائرا عند منتصف الجرف الذي يحدّ هذا الشاطئ، ليس الجرف عاليا ولا وعرا جدا: إنّه حافة محجوجرة وصخرية في بعض الأحيان، تكسوها الأحراش والمراعي وتطغى فيها السدرة. حوالي الساعة 1 و45 دقيقة سرت في اتجاه السافلة لأخترق عصف تمراغت Tamraght على بعد أمتار من مصبه: تكثر المزروعات في واديه وترى فيهن على مسافة ما، عدة قرى… في الساعة الثالثة و45 دقيقة… تبدو عدة بنايات منعزلة ومجموعات من المساكن. توقفت عن السير في الساعة 4، عند إحدى البنايات. أولى هذه البناية «نزالة». يطلق هذا الاسم على مواقع تسكنها عائلات ذات ارتباط بالمخزن يجب عليها ضمان أمن الطرق ويرخّص لها المخزن بتحصيل مكوس مرور ضئيلة. توجد هذه النزالات في عدد قليل من القبائل الخاضعة للسلطان: لا تضمن هذه النزالات إلّا أمنا جزئيا، لا يتجرأ الأجانب على السفر فرادى هنا كما هو الأمر في جهات أخرى. سأبقى في أراضي حاحا بعد دخولها هذا الصباح عند أكادير وسأبقى في هذه الأراضي حتى وصولي إلى موغادور».
جرمان مويط.. رحلة الأسير
كتاب جرمان مويط الفرنسي (1651-1691) Germain Moüette الذي أسره قراصنة سلا وتنقل بين فاس ومكناس ومراكش أسيرا في عهد السلطان مولاي رشيد ومولاي إسماعيل. حفل كتابه بالكثير من التفاصيل عن هذه الفترة وكان قريبا جدا من بعض الأحداث. أثناء أسره استطاع جرمان الأسير الفرنسي تسجيل العديد من التفاصيل عن المغرب بشكل عام في تلك الفترة، وبسبب تنقله قام، وبشكل دقيق، بوصف الأمكنة والحياة الاجتماعية في ذلك العصر. هنا يتناول أهم المدن والمناطق في المغرب: «… إنّ مدينة مراكش، التي تسمّى بها المملكة كلّها مثل مملكة فاس، واقعة في سهل كبير مغطى بنخيل… نطاقها أكبر من نطاق فاس بنسبة الثلثين، وفيها ستة عشر بابا. لكنها ليست آهلة بما يناسب كبرها، بسبب الحرب والطاعون الذي أهلك أكبر قسم من سكانها. وهناك قصر جميل يحتوي على مساكن نساء الملك، وهو أفخم ما في إفريقيا بأسرها. خصص له مولاي أحمد الذهبي كلّ ما كان يملك من ذهب. جعله صفائح تغطي جميع جدران القاعات وحائطياتها. إنّ المسامير والمحاور والمساحيق والمزالج والأقفال كلّها من الفضة المموهة بالذهب، وفي أعلى البرج الكبير ثلاث تفاحات من ذهب في غاية الضخامة، مثقبة في عدة مواضع بطلقات بندقيات، تعتبر مرصودة. وفي مساكن الحريم قاعات طويلة فسيحة حتى إنّها تتسع لأحواض كبيرة من الماء الصافي المليء بالأسماك، يمكن رؤيتها كذلك وهي تسبح في مرايا كبيرة مركبة في سقف القاعة. وفي إحدى تلك القاعات مثلت جميع بروج السماء بمهارة حتّى ليتوهم المرء أنّه يرى القبة الزرقاء… وذلك القصر البديع مزدان بكمية من السواري وأحواض المرمر الأبيض، مع عدة زخارف جميلة من الجبس، ومربعات صغيرة مصبوغة ومنقوشة بالمطرقة. وقد أضيف إلى القصر أجمل بساتين الدنيا، بممرات من شجر البرتقال والسرو، وتحيط بكل من الصرح والقصر والبساتين أسوار جيّدة محصنة ببروج جميلة وقلاع لكن بدون مدفعية. وتمرّ تلك القنوات الشهيرة التي تحمل الماء إلى المدينة من مسيرة يوم كامل بجانب ذلك الصرح لتزوده بالماء كما تزود المدينة بأسرها. لا تتكون هذه المملكة إلّا من خمسة أقاليم، هي مراكش وتادلة، ودكالة، وحاحة وقسم من جبال الأطلس. هذه البلاد غنية بالحبوب والمواشي وأكثر حرارة من مملكة فاس، لتوغلها أكثر في الجنوب. ومدنها، فضلا عن مراكش، هي أزمور، والوليدية وأسفي. وهناك عدة حصون يعيش فيها الأعراب مجتمعين، كما يفعل البربر في أماكن أخرى… يحتل البرتغاليون على شواطئ هذه المملكة مدينة مازغان أو البريجة، التي لا تبعد عن أزمور إلّا بفرسخين.
… كانت إمارة سوس في القديم تابعة لنفس المملكة (مراكش)، التي لا يفصلها عنها إلّا سلسلة طويلة من الجبال الممتدة من ساحل البحر إلى تخوم الأطلس ويحدها إقليم درعة من الجنوب الشرقي، ومملكة السودان من الجنوب الشرقي، والبحر من الغرب والشمال الغربي، ومملكة مراكش من الشمال إلى الشرق. وليس فيها سوى إقليمين هما سوس والساحل ومدنهما هي تارودانت وأكادير وإغير أو سانت كروز وإليغ التي كانت عاصمة البلاد لما كان سيدي علي أميرها. أمّا الآن، فالعاصمة تارودانت التي يقيم فيها عادة مولاي أحمد بن محرز كأمير لها. إنّ واد سوس الذي سميت به البلاد كلها لا يوجد معه إلّا نهر آخر يدعى ماسة. إنّ منطقة سوس مليئة بقصبات جيّدة، وسكانها مشهورون بأنّهم جنود ممتازون وأكثر حذقا في استعمال الأسلحة من جميع المغاربة. وجبالها مليئة بالحبوب والثمار والشمع. وهناك مناجم غنية بالنحاس وأخرى بالذهب، ولا ينقصها إلّا الصوف. ويوجد في تلك الجبال عدد كبير من الأسود تلتجئ ليلا في عرينها ولا تخرج منها إلّا للبحث عن قوتها. ولما كان البربر يعرفون بالتقريب المواضع التي تمرّ منها فإنّهم ينصبون لها مصائد ليأخذوها حية».
(ترجمة: محمد حجي/محمد الأخضر)
أندري شوفريون.. رحلة إلى المغرب
كتاب «رحلة إلى المغرب» للكاتب الفرنسي أندري شوفريون (1864-1957) André Chevrillon الذي قام بزيارة إلى المغرب سنة 1905، شكل وثيقة عن المغرب قبيل سقوطه ضحية الاستعمار الفرنسي. نقرأ في هذه الرحلة بعض ملاحظات الكاتب: «… وبعد ساعتين من ذلك بلغنا مدينة العرائش… بيضاء بياضا ثلجيا وهي تنحدر من جرف نحو مصبّ النهر الأزرق. وكلّما اقتربنا منها كانت تنكشف لنا أسوارها المسنّنة البيضاء أيضا التي تغلفها بكاملها بحيث تخفيها عن ناظرنا، كما لو كان ذلك غلاف عشّ إنساني موضوعا هناك ومربوطا إلى هذا الشاطئ القفر. وفي داخلها من دون شكّ ضجيج وصخب دفين كما الزنابير المتجمعة في كيس لصيق بالصخر. ومن الجهة الأخرى، وبدءا من جدر السور، ثمة الوحدة والبحر والبادية المشرقة الخالية إلى ما لا نهاية.
رست السفينة عند مدخل المرفأ قرب السياج البدائي. يا له من منظر بسيط وشاسع ! لا وجود للأشجار ولا للتفاصيل. فقط الزرقة الرائعة للنهر، والمنعطف الكبير الخالص بشطّيه عبر السهل، والمرعى الطويل اللانهائي الذي تقوده التلال المحاذية نحو الشرق، والذي سوف نسير منه بعد غد نحو داخل البلاد.
ما كنت أتخيّله خلف الأسوار هو الحياة الكثيفة المزدحمة. وفي الصباح عند الإفاقة من النوم، في غرفة صغيرة تطلّ على الزقاق الأكثر ازدحاما في السوق، أسمع جلجلة الدواب والعراك وأصوات سائسي الحمير: «بلاك، بالاك». أسمع الصياح بالعربية، وهمهمة الناس كما لو كانت دندنة هائجة على زجاج النوافذ. يا لها من حياة وقّادة في فورانها الباكر القريب من أذني. ينبعث منها تأثير حيوي، وهو ما يطرد عنّي شكوك الإفاقة من النوم، كما لو أنّ أشعة الشمس الإفريقية تشعل في الشمال النور الوهاج للظهيرة منذ الساعة الأولى من الصباح.
جاءني أول ضيف فرنسي (من مواليد الرباط)، وهو الفرنسي الوحيد المقيم هنا. وهذه الغرفة الضيقة التي أقيم بها ذات أثاث أوروبي، غير أنّ بها روائح وعطورا لطيفة ليست آتية من أوروبا. هل هي منبعثة من حوانيت السوق القريب؟ لا، لأنني أدركت أن آثار العطر قد تبقى هنا كما لو أنها ظل الغرفة، منذ أن وجد هذا البيت.
إنّها الروح العربية للدار المغربية التي تنبعث من عمق الحيطان، ورائحة الأخشاب النادرة، وربما كان ذلك خشب الأرز الذي استعمل في سقف الدار. يكفيني أن أشمه كي يستثير ذلك في نفسي الشرق: فقد تشبعت به في حوانيت دمشق والقاهرة، مخلوطا ببخور صمغ جاوة والألوة مع دفق الجمال الرائعة التي كانت تمر تحت الأقواس البخورية.
فتحت الستائر وأطللت من النافذة. لم تعد الشقشقة التي كانت تتسلل إلى نومي من قبل تثير في نفسي الدهشة. ففي الساعة السابعة صباحا، كان سكان العرائش بكاملهم يتكدّسون في هذا الزقاق الضيق. وهم بين أكياس الحبوب والقفف المقلوبة وركام الفصّة والحمير الملتصقة بالحيطان عبارة عن زحام وخليط من اليهود بعباءتهم السوداء، والنساء المتلفّعات مثل الرزم، والصبيان العراة، والبدو اللابسين الخرق، والبرجوازيين المغاربة. كلّ هذه الجمهرة من الناس التي تتعارك، وتساوم البضائع وهي تتضارب بالأكتاف وتجري في العتمة الخصبة في قعر هذا السرداب.
وحين رفعت عينيّ، كان عليّ للتوّ إغلاقهما قبل أن أتمكّن من التعرف على البياض الناصع الذي يتراءى أمامي: سطوح ثلجية تحت نور الشمس، غير أنّها مائلة إلى الزرقة بشكل خفيّ على الإدراك، كما لو أنّ ما تحت ذلك الثلج يكاد يلامس شفافية المرآة، وبعيدا من هناك، خلف خط من الألوان البيضاء المحزّزة، تمتد الزرقة الباهرة والثقيلة للمحيط الأطلسيّ السديميّ، وإذا ما أنا أدرت رأسي شيئا ما نحو الشمال ثمة مصب نهر اللوكوس ذي الزرقة الملساء، حيث يمتدّ اللون الذهبي للرمل، ثمّ المجرى الأول للنهر وهو يتمدد بسعة في السهل. يقال بأنّ هذه الحلقات الرائعة من بين أجمل أشجار البرتقال في العالم قد أوحت للقدماء بفكرة التنين، الذي كان يحرس في ما وراء أعمدة هرقل حدائق الهسبريد المسحورة».
(ترجمة/ فريد الزاهي)
أدريان جاك فولي.. كنت عبدا في المغرب
كتاب «كنت عبدا في المغرب» للفرنسي أدريان جاك فولي (1746-1803) A Jacques Follie وهو موظف إداري وقع في الأسر بعد أن غرقت سفينته المتجهة إلى السينغال، في سواحل الجنوب المغربي وقيام السلطان محمد بن عبد الله بتخليصه صحبة مرافقيه من البحارة. يروي لنا أدريان جاك فولي، في كتابه «كنت عبدا في المغرب»، تفاصيل وقوعه في الأسر قائلا: «… حين تبيّن للملك كم هو صعب جمع الفرنسيين من طاقم سفينتنا، أصدر على الفور أوامره لحاكم موغادور بإرسالنا إلى مراكش. استأذنا من كلّ التجار الذين أغرقونا في كرمهم وغادرناهم يوم 5 يونيو 1784 ممتلئين بذكرى محبّتهم. منح الحاكم كلّ واحد منّا بغلة، وكان يودّ رؤيتنا أثناء انطلاقنا. ووضعنا تحت حراسة جنود الإمبراطور. سرنا في الصبيحات، لأنّ الحرارة كانت جدّ مفرطة، وكان عدد أفراد القافلة كبيرا، كانوا يسوقون صندوق جمارك موغادور. وفي اليوم الأول من رحلتنا نفق جملان مختنقين بالحرارة. استأنفنا السير في اليوم الموالي قبل طلوع النهار، وكنّا مضطرين للتوقف كلّ تسع ساعات، وعلى الرغم من تلك الاحتياطات فقد تسببت الحرارة في موت يهودي ويهودية.
كنت أعاني كثيرا، ففي كثير من الأحيان كنت أفقد القدرة على التنفس، وكنت أسقط من على متن بغلتي. شملنا المغاربة بعناية كبيرة جدا، كان يتقدّمنا القائد الذي عهدنا إليه خشية أن يصيبنا مكروه. وأخيرا وصلنا إلى مراكش مرهقين ومنهكين يوم 20 من نفس الشهر. كان الإمبراطور قد خرج في صباح ذلك اليوم على رأس اثني عشر ألف مغربي في حركة (حملة عسكرية) لتأديب متمردي جبل الأطلس، وفي انتظار عودته، وضعنا تحت حماية البعثة الإسبانية، حيث وجدنا بحّارا من طاقم سفينتنا قد اقتيد إلى هناك.
في يوم 28 يونيو 1784 عاد الإمبراطور من حملته، فاستدعانا. كان يختبر جنوده حين وصلنا إلى موضع مقابلته، استقبلنا للتو، وبدا حساسا تجاه مصائبنا. كنّا قد تمثّلناه كرجل قاس ومطلق السلطة، ولا إنساني ولا يرحم، لدرجة أنّ التوسلات كانت تغضبه، ومع ذلك تجرّأنا على التوسّل إليه كي يأذن لنا بالعودة إلى أسرنا، ابتسم لشجاعتنا، بالرغم من أن اهتمامه الأول كان هو أن ننتظر وصول باقي طاقم السفينة، فقد أبدى تأثره الكبير بالحالة السيئة التي قدّمنا له عليها، فوعد بإرسالنا في أقرب وقت إلى فرنسا.
في اليوم الموالي جاءنا واحد من كبار الإمبراطورية، بأمر من الإمبراطور، ومعه مكافأة نقدية. وأخيرا في الخامس من يوليو 1784 تمّ استدعاؤنا مجددا، ووضعنا الإمبراطور بين يدي باشا وأمره بالاعتناء بنا وأن يقودنا إلى قنصلنا. انطلقنا في نفس اليوم من مدينة مراكش، مخفورين بعشرة جنود وفارس. التحقنا عند خروجنا من المدينة بجيش صغير من المغاربة، كان يتوجّب عليه أن يجوب كل بلاد البربر، وكان يرأسه ذلك الباشا الذي كلّفه السلطان بنا، لم تضايقنا الحرارة في تلك الطريق سوى على نحو قليل.
اعتنى الباشا بنا غاية العناية، إذ كنّا نسير دائما وسط الجيش، مطوّقين بحرس خاص، وإذا تعبت بعض بغالنا كان يتمّ استبدالها للتو. كنّا نجد دائما خيمتنا مهيأة قبل وصولنا، وكان يوفّر لنا ما يكفي من المؤونة. كانت أوّل مدينة وجدناها في طريقنا هي أزمور، وهي واقعة على ربوة، كنّا محاطين بحرسنا كما شاهدنا عرضا ممتعا للعديد من الألعاب المغربية. سكان مدينة أزمور الذين كانوا ينتظرون، مجندين، الجيش الإمبراطوري قادوه إلى غاية المكان حيث سيعسكر، وهناك تعاطوا للعب البارود وأظهروا مواهبهم في استعمال الأسلحة النارية. أثناء ذلك كان يجري في المدينة إعداد الطعام الكافي لكل أفراد الجيش، وتمّ حمله إليهم ساعتين بعد ذلك على محامل. بعد أن أدّى حاكم المدينة التحية إلى الباشا، جاء لزيارتنا في خيمتنا، وهنّأنا بالحفاوة التي أنعمنا بها لدى الإمبراطور وأرسل لنا، بعيد ذلك، بعض المرطبات. مكثنا يومين في ذلك المكان، وفي اليوم الثالث عبرنا النهر ومن هناك توجهنا نحو الدار البيضاء… لا توجد بها سوى كومة من الأطلال، واصلنا طريقنا عبر فضالة والمنصورية، وأخيرا وصلنا إلى مدينة الرباط بعد 16 يوما من السير».
(ترجمة/ بوشعيب الساوري)
إدموند دوتي.. السوسيولوجيا في خدمة الاستعمار
إدموند دوتي (1867-1926) Edmond Doutté سوسيولوجي فرنسي يعتبر من مؤسسي أنثروبولوجيا الدين الكولونيالية. ظل وفيا لأستاذيه هنري باسيه وأوغست مولييراس وهما من أهم رواد المدرسة الكولونيالية في الجزائر. قام بالعديد من الرحلات الاستكشافية والاستطلاعية إلى المغرب حيث ربط علاقات مباشرة بأعيان المناطق التي جعلها مجالا لبحثه السوسيولوجي والأنثروبولوجي، ساعده في ذلك معرفته اللغوية واطلاعه الواسع على تاريخ المغرب. انصبّ اهتمامه في بحثه على التمهيد للاحتلال الفرنسي للمغرب بأسهل السبل وأقربها بأقلّ الأضرار والخسائر الممكنة. كلّ دراساته الميدانية في مجاله السوسيولوجي والأنثربولوجي كان مرتبطا بشكل أساسي بمشروع استعماري متكامل لم يكن يخفيه في كتاباته، فهو يقول متحدثا عن مستقبل المغرب قبيل الاستعمار بقليل: «لو قيض للمغرب أن يصبح ملكا لنا، فينبغي أن نحافظ مسبقا على مساحات شاسعة التي ستظل عذراء وخالية من السيارات وفنادق السياح، عذراء على الخصوص من ثقافة الاقتلاع التي ستقضي على أجناس كاملة من النباتات. وسيكون أحفادنا ممتنين لنا، من أجل أعصابهم المنهكة بالحضارة، بالمحافظة على بعض الأماكن التي سيجدون فيها الهدوء والحياة البسيطة». قام إدمون دوتي بعدة رحلات إلى المغرب مكنته من الكشف عن الكثير من الظواهر الاجتماعية ودراستها دراسة علمية في ظاهرها لكنّها في عمقها تستجيب للأهداف التي ترسمها الدوائر الاستعمارية في فرنسا. فهو يتطرق، على سبيل المثال، في كتابه «الصلحاء»، لظاهرة الزطاط في المغرب قائلا: «… ولا يمكن في المغرب حاليا أن تنتقل من قبيلة إلى أخرى دون «زطاط» أي حارس القافلة إلّا بمقابل، وبمجرّد أن يوصلك إلى القبيلة الأخرى يسلّم المهمة زطاطَ آخر، وهكذا دواليك. ويجلب الزطاطة مداخيل كثيرة إلى العديد من الصلحاء باعتبار أن الاحترام الذي يحيطون به كفيل بضمان أمان المسافرين وقد أصبحت الزطاطة في المغرب مؤسسة حقيقية لا يمكن بدونها السفر، والصلحاء الذين يمارسونها تتضاعف مداخيلهم وهذا تصرّف قديم حيث قال ليون الإفريقي بأنّه إذا أراد أحد الأشخاص الذهاب من مكان إلى آخر يجب أن يأخذ معه حراسا من أهل الدين أو امرأة من القبيلة المعادية (أي القبيلة المجاورة عموما العدوة التي سيعبرها)». أو مدلول بعض الكلمات المتداولة في المجتمع المغربي مثل كلمة «مرابط»: «وكان أوائل هؤلاء الأشراف مرابطين مجاهدين بحيث إنهم اكتسبوا حظوتهم من جهادهم ضد البرتغاليين، كما يدينون بتألقهم وإشعاعهم إلى نجاحهم في طرد الكفار من أرض الإسلام. لكن، وبعد انتهاء المرحلة البطولية تلك، كفّ دعاة جنوب المغرب، الذين ذهبوا لنشر الإسلام في سكان المغرب، عن أن يكونوا مجاهدين بل تحولوا فقط إلى دعاة لنهضة دينية حديثة في إفريقيا الشمالية، وأصبح الرباط القوي مؤسسة دينية حقيقية أي: زاوية».
أوغست مولييراس.. المغرب المجهول
استطاع أوغست مولييراس (1855-1931) Auguste Mouliéras، بفضل دهائه وحماسه الديني والقومي، أن يقوم بعمل أنثروبولوجي فوق الأرض المغربية دون حاجة إلى القيام برحلة استكشافية ميدانية في أصعب المناطق، خاصة الريف وجبالة. لقد استغل إقامته في مدينة وهران زمن الاحتلال الفرنسي وإتقانه للغة العربية والأمازيغية ومعرفته التامة للدين الإسلامي لمخالطة المسلمين، خاصة المغاربة الوافدين إلى الجزائر، في جمع المعلومات عن المغرب في شتى المجالات. كان مولييراس كثيرا ما يوهم مخالطيه المسلمين بأنّه يخفي إسلامه عن مواطنيه الفرنسيين كسبا لثقتهم وطمعا في الحصول على أكثر الأسرار عن ما يسميه بالمغرب المجهول. انتقل بعدها إلى خطوة طموحة تمثلت في إرسال موفد رحالة إلى مناطق محددة في المغرب، خاصة في منطقتي الريف وجبالة، ووقع اختياره على محمد بن الطيب الدرويش ذي الأصل القبائلي لإتقانه اللغة العربية والأمازيغية ولقرب سحنته من عامة أهل الريف وجبالة فضلا عن كونه طالبا حافظا للقرآن، ولكي لا يثير الشكوك كان عليه أن يتظاهر بالجنون على شكل درويش ليسهل عليه الانتقال بين القبائل والدواوير بسهولة. يقول مولييراس عن ذلك: «لكن رحالتنا سيسرع الخطى نحو المسجد متخذا هيئة الدرويش المخبول إلى حد ما وسيبتعد عن الحشد الذي اعتقد بأنه رجل مجنون، ومعلوم أن المجانين يحظون لدى جميع المسلمين بعطف كبير واحترام عميق لأن جنونهم لا يؤذي أحدا على العموم». لقد أسفر هذا الجهد على إنجاز كتاب مهم «المغرب المجهول» في جزأين الأول عن الريف والثاني عن جبالة، أكسبه صيتا كبيرا في الدوائر الاستعمارية الفرنسية.
انطلق مولييراس في مشروعه بشكل فردي من أجل بلاده ومن أجل العلم كما يقول: «إنّ دماء الغاليين Gaulois القدامى التي تجري في عروقي لا تتوافق أبدا مع المذهب الجبري العزيز على الكسالى. سيستحيل عليّ الذهاب إلى المغرب؟ فليكن. غير أنّ هناك مسلمين قاموا بزيارته. ففي كلّ يوم، هناك حركة ذهاب وإياب إلى ومن المغرب. وهنا برز أمامي الحل شبه التام للمشكل المطروح باستمرار والذي ألخصه كما يلي: «إنّ معرفة المغرب وجعله معروفا من طرف الآخرين، بشكل مماثل ولربما أفضل مما لو قمت بزيارته بنفسي، قد يتم بفضل تصريحات المغاربة والرحالة المسلمين الآخرين. وعلى الفور، شرعت في العمل وحيدا، دون معونة أيّ أحد ودون أيّ دعم كيفما كان نوعه، مستغلا كلّ وقتي بما في ذلك عطلتي وكل أوقات الفراغ التي تسمح بها خدمتي المزدوجة والمضنية التي طالبت الإعفاء منها، بدون جدوى. هكذا، سينجز هذا العمل على مدى عدة سنوات، وهو العمل الذي فرضته على نفسي، من أجل بلدي ومن أجل العلم، والذي يشبه مجهود ثور الفلاح.
والآن، وأنا أعاين المسار الذي قطعته والعمل الضخم الذي أصبح مجسدا على أوراقي، منتظرا الترتيبات النهائية، فإنني أتساءل عن الاستقبال الذي سيخصصه المعاصرون لي (وأنا أقصد هنا المتشككين والمتهكمين)، لعمل سيكشف عن الحياة الحميمية وعن عادات وأفكار شعب عظيم. وسيبرز لهم بواطن أرض مجهولة لديهم».
إنّ الرؤية الاستعمارية لمولييراس واضحة جدا في إشاراته المتعددة في كتابيه السالفين، فهو يعتبر فرنسا: «مدعوة لخلافة العرب على مستوى الهيمنة الثقافية التي مارسوها في كل البلاد الأمازيغية منذ فتوحاتهم الأولى، ومدعوة أيضا لخلافة الأمازيغ على مستوى الهيمنة السياسية التي ما فتئ هؤلاء الأشداد يمارسونها فعلا لمواجهة سيطرة الغزاة بالرغم من الانتكاسات التي لحقتهم»، كما يرى أنّ فرنسا مؤهلة للقيام بهذا الدور: «كان العربي داعية مشاكسا لا يشبع، وكان الوندالي متوحشا والروماني طاغية مستحوذا، والقرطاجي تاجرا عابدا للعجل الذهبي، ويجب أن يكون دور الأمم الحديثة المؤهلة لقيادة الشعوب المسلمة مغايرا تماما» لكن ذلك يشترط المعرفة الجيدة للمسلمين، حسب قوله، «في إدماج المسلمين…معرفتهم. ذلك أن كل مسلم يولد وفيه شيء من الدبلوماسية… فالمسلم يشكل لغزا وهو معروف فقط من طرف بعض المسيحيين القلائل الذين شاطروه حياته واندمجوا معه إن صح القول».
لكنّ اعتماد أوغست مولييراس بشكل تام على الروايات الشفوية للوافدين المغاربة إلى الجزائر وما ينقله مبعوثوه الرحالة إلى المغرب، رغم حرصه الشديد على مقارنتها بحثا عن تطابقها، أوقعه أحيانا في إصدار آراء مسبقة أو مغلوطة أحيانا أخرى. ومثالا على منهجه في الكتابة يتحدث مولييراس عن الطب الشعبي في المغرب: «… وعند الإصابة بصداع الرأس، ينصح الطبّ الشعبي الجبلي (يقصد منطقة جبالة) باستعمال مريوة، حيث تطحن ورقتها ويتمّ استنشاقها، وعلى الفور يزول الألم، وإن كان المريض يستمرّ في العطس مدّة طويلة، وبمزابل القرى تنبت شجيرة تدعى سيكران، تنتج ثمرة ذات خصائص مخدرة. ويستعمل الكبار Capre في العديد من الأطعمة ويعتبر مقويا جنسيا. أمّا آلام الأعصاب فتعالج بوضع كمادات من الحرمل بعد أن يتمّ غمسها في زيت ساخنة. ويسود الاعتقاد لدى الجميع بأنّ النباتات المرّة مفيدة لمعالجة آلام الهضم، وتستعمل للقضاء على الديدان المعوية المتولّدة، بدون شكّ، عن الشرب المبالغ فيه للشاي المحلّي بمعدل 30 غراما للقدح وأيضا عن الاستهلاك المفرط للحلويات لدى المغاربة. إنّ ممارسة الطبّ الشعبي، أو بالأحرى الشعوذة التي تأخذ هذا الاسم، هي حكر على بعض الطلبة عديمي الذمة. وفي الواقع، فإنّ كلّ طالب هو طبيب بمعنى ما. ومصدر شهرته الكونية هو الحرز أو الحجاب الذي يتضمن عبارات غير مفهومة، تنتقى كلماتها من القرآن الكريم الذي يثق فيه المريض بشكل مطلق. ويصنع جميع الطلبة أحجية علاجية، ومن ضمنهم الدرويش (يقصد محمد بن الطيب) الذي وزّع المئات منها خلال جولاته. فخلال جولته السابقة بحوز مراكش، ادّعى بأنّه طبيب. وقد جمع مالا كثيرا واحتال على العديد من المرضى. غير أنّ مصرع طالبين أو ثلاثة، ممّن كانوا يزاولون نفس المهنة، فتح عينيه على مخاطرها، بحيث يكثر الحسّاد والأعداء، من بين أولئك الذين دفعوا الأموال دون أن يشفوا. وفي الحقيقة، فإنّ الطلبة، المتهورين مثله، كانوا يرتدون أحسن الملابس ويرصّعون أيديهم بالخواتم، ما كان يثير حفيظة المغاربة تجاه هؤلاء المحتالين الذين يدعونهم بـ«كروش الحرام». وأمام هذه الوضعية، التي أثارت مشاكل عديدة لا مجال لذكرها هنا، اشمأز محمد (يقصد محمد بن الطيب) من العلوم الطبية ومن المعدن المعلوم، مصدر العديد من الجرائم، فتخلّى عن ملابسه الأنيقة ولبس أسماله القديمة التي تمنحه وحدها الأمان وتجنّبه تلقي ضربات قطاع الطرق، وهذا مكسب هام».