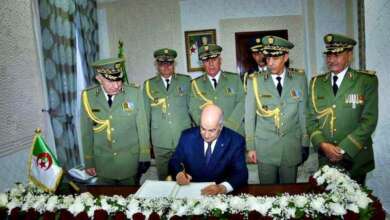الحياة المنسية والغامضة لـ«روزاليندا باول فوكس»
حلت بالمغرب في عز أنشطة الجاسوسية خلال الحرب العالمية الثانية

«.. مع انتشار الأخبار عن ثروتها الكبيرة ورحلاتها الكثيرة حول العالم، فإن روزاليندا كانت مرشحة مثالية لنيل تهمة الجاسوسية. وما زاد من ترسيخ التهمة، أنها تزوجت من «خوان لويس بيجبيدر»، المفوض السامي الإسباني. وقيل وقتها إن زواجها منه كان مخططا له، لكي تكون قريبة من مصادر المعلومات بشأن العمليات العسكرية الإسبانية في شمال إفريقيا، خصوصا في منطقة تطوان.
يونس جنوحي:
رغم المأساة التي حلقت فوق حياة الشابة «روزاليندا»، بحكم طلاقها من زوجها الأول، ومعاناتها مع المرض، إلا أنها لقيت هجوما شرسا من الصحافيين والدبلوماسيين والسياسيين الأجانب الذين كانوا يعيشون في شمال المغرب، وكانت تعلم بشأن تهمة الجاسوسية الموجهة إليها».
قصة حياة من الهند إلى طنجة الدولية
رغم أن اسمها كان على كل لسان، وموضوع أحاديث الأجانب الذين كانوا يعيشون في شمال المغرب خلال ثلاثينيات القرن الماضي، سيما في منطقة طنجة الدولية، إلا أن السيدة «روزاليندا باول فوكس» لم تحظ بما تستحق من اهتمام، خصوصا وأنها اتُهمت بالجاسوسية.
المعلومات التي توفرت عن هذه «الأسطورة» أنها فعلا تحمل الجنسية البريطانية، بل وتنتمي إلى واحدة من أعرق الأسر الأرستقراطية المعروفة عند الإنجليز.
كانت «روزاليندا» تعيش حياة هادئة جدا في الهند، خلال نهاية عشرينيات القرن الماضي، في قمة شبابها واستمتاعها بجمالها، سيما وأن زوجها كان أيضا من الأثرياء. وكانت تعيش داخل واحدة من أفخم الإقامات التي اقتناها الإنجليز في الهند، خلال سنوات الاستعمار البريطاني للهند.
هذه الحياة الهادئة، لم تكن لتقودها صوب المغرب، لولا أن كل شيء في حياتها قد انقلب مع بداية ثلاثينيات القرن الماضي، عندما تدهورت صحتها كثيرا، وفشل الأطباء الإنجليز في الهند في إيجاد علاج لحالتها المرضية المستعصية.
أجمع الأطباء الذين أشرفوا على علاجها أنه لم يتبق أمامها سوى ثلاث إلى خمس سنوات، لكي تموت، على اعتبار أن مرضها قاتل لا علاج له.
في ظل هذا الوضع الدرامي الذي خيم على حياتها، تداعت كل آمالها في أن تنعم بحياة مستقرة في الهند، خصوصا وأن زوجها قد تخلى عنها ولم يقف بجانبها خلال فترة مرضها.
وجدت «روزاليندا» نفسها وحيدة في بلاد الهند، ولكي تخرج من الكآبة التي سيطرت على حياتها بعد علمها بخبر اقتراب وفاتها، وفشل الأطباء في إيجاد علاج محدد لحالتها، قررت أن تخوض رحلة حول العالم، تقضي فيها ما تبقى من حياتها متنقلة بين دول العالم، وتنفق ثروتها في تلك الرحلات.
لكن كل شيء في حياتها قد تغير، بمجرد ما أن رست السفينة التي تقلها من الهند في ميناء طنجة.
لا توجد مصادر رسمية تحدد السنة التي وصلت فيها بالضبط إلى المغرب، لكن وصولها، بحسب ما نقلته الصحافة الأجنبية التي اهتمت بمسار حياتها، تصادف مع بداية الحرب العالمية الثانية، أي خلال سنة 1939.
كان سفرها إذن محاولة منها لكي ترمي كل شيء عن حياتها السابقة خلفها، وتبدأ حياة جديدة، رغم أنها سوف تكون قصيرة، بحسب ما قاله الأطباء.
بمجرد وصولها إلى طنجة، قررت أن تزور المدينة، وتقضي فيها بضعة أيام، قبل أن تواصل رحلتها الطويلة حول العالم. لكن بمجرد ما أن انقضت الأيام الأولى لمقامها في طنجة، حتى وجدت نفسها تجدد إقامتها في الفندق، وتقرر تمديد عطلتها المفتوحة. وبعد أسابيع من الإقامة في طنجة، قررت أن تقيم فيها نهائيا، وألا تغادرها أبدا.
هذه الرواية روجت لها الشابة «روزاليندا» بنفسها بين كل الأجانب الذين التقتهم في طنجة، وهو ما جعلها تحصد تعاطفا كبيرا في أوساط الأجانب، البريطانيين خصوصا، وسرعان ما أصبحت مشهورة بين الأجانب من جنسيات أخرى. إذ إن ما روجته عن نفسها تجتمع فيه كل شروط الإثارة: الثراء والطلاق والمرض.
اتضح لاحقا أن الشابة «روزاليندا» لم تكن تعاني من أي مرض عضال، وزعمت أنها شفيت تماما من مرضها بفضل جو مدينة طنجة الذي أثر إيجابا على حالتها النفسية.
ومع مرور الوقت، بحسب ما نشرته عنها الصحافة الأجنبية، أصبحت تهتم أكثر بأخبار الحرب العالمية الثانية، وتناقش في الجلسات المفتوحة التي كان يلتقي فيها أثرياء طنجة من الأجانب، في فنادق المدينة وإقاماتها الفخمة، أخبار الحرب وتداعياتها.
وبدخولها عالم أخبار الحرب، بدأت بعض الشخصيات الأجنبية تهتم بشخصيتها كثيرا. لكن السبب الحقيقي وراء اتهامها بالجاسوسية، هو زواجها الذي أثار جدلا كبيرا وقتها.
قصة زواج جعل «الجاسوسية» تطارد «روزاليندا» طيلة حياتها
في إطار تلك الجلسات التي يحضرها كبار الشخصيات، والتي تقول فيها «روزاليندا» رأيها العفوي والصريح بشأن الحرب العالمية الثانية، وهو ما كان لا يقوى أشجع الدبلوماسيين على الخوض فيه، تعرفت على زوجها المستقبلي الذي لم يكن سوى المفوض السامي الإسباني، السيد خوان لويس بيجبيدر. هذا الأخير كُتب عنه أنه كان معروفا بضعفه أمام النساء. وهذه التهمة وجهتها إليه صحافة بلاده عندما كان يشتغل في المغرب، انتقادا لسياسته وطريقة تدبيره للصراع بين إسبانيا والمغرب في منطقة الشمال، خلال فترة الحرب العالمية الثانية.
كان هذا المفوض السامي قد قضى سنوات طويلة في المغرب، قبل أن يتعرف على روزاليندا، وكان أيضا معروفا بحبه للغة العربية وآدابها والثقافة الشرقية عموما.
وعندما التقى مع روزاليندا في إحدى الحفلات الخاصة التي دُعيا إليها معا، سرعان ما وقع اتصال مباشر بينهما، وسرت إشاعات كثيرة بشأن العلاقة بينهما، وبدأت الشكوك تحوم حول روزاليندا بأنها جاسوسة لصالح الحكومة البريطانية، وأن الهدف من علاقتها مع المفوض السامي الإسباني، معرفة تحركات الجيش الإسباني في البحر الأبيض المتوسط.
لكن خبر زواجهما معا كان صادما لكل الذين اعتبروا العلاقة بينهما عابرة. وبحكم الرواية التي انتشرت بشأن وضع روزاليندا الصحي، وتجربة زواجها السابق في الهند، فقد حصدت تعاطفا كبيرا من طرف بعض النساء الأرستقراطيات في طنجة، وقيل وقتها إن زواجها جاء تتويجا للتحسن الكبير الذي طرأ على صحتها ونفسيتها، بعد إقامتها في طنجة.
هذا الزواج جر عليها المزيد من الاتهامات، وظل أغلب المسؤولين والصحافيين الأجانب في المنطقة الدولية ينظرون إليها على أنها جاسوسة لصالح الاستخبارات البريطانية، وأن الغرض من وجودها في المغرب منذ الوهلة الأولى، لم يكن إلا بهدف جمع المعلومات من المسؤولين الأجانب الذين يعملون في المنطقة الدولية، وإرسالها في تقارير سرية إلى مقر المخابرات البريطانية.
بل إن هذه التهمة بقيت تلاحق روزاليندا حتى بعد وفاة زوجها المفوض السامي سنة 1957. ورغم نهاية الحرب العالمية الثانية، إلا أن التهمة ظلت تلاحقها. بعض المعلومات التي تداولتها الصحافة الأجنبية، تؤكد أن روزاليندا غادرت مع زوجها صوب قرية في الجنوب الإسباني، حيث نعم بتقاعد مريح في أيامه الأخيرة، وكانت تلك القرية الشاطئية تُطل على طنجة الدولية من الضفة الأوروبية.
ورغم أن «روزاليندا» ظلت ملاحقة بتهمة التجسس، واستغلال منصب زوجها للتأثير في مواقف إسبانيا خلال الحرب العالمية الثانية، واستمالة المسؤولين الإسبان لكي يبتعدوا عن النازية الألمانية، ويصطفوا إلى جانب الحلفاء بزعامة بريطانيا، إلا أنها نُسيت في خضم الأحداث اللاحقة التي عرفها العالم. لكن لا يوجد في الأرشيف ولا في التحقيقات الصحافية ما يشرح كيف شفيت هذه الشابة البريطانية الغامضة، من المرض الخطير الذي راج في طنجة أنه انتشر في جسدها. بل إن الأجل القصير الذي حدده لها الأطباء في سنة 1939، في خمس سنوات، تبخر واستطاعت أن تحظى بحياة حافلة، إذ توفيت سنة 2006، وتركت خلفها أسئلة كثيرة عن حياتها في مدينة طنجة وحقيقة المهمة التي جاءت من أجلها إلى المغرب، وما إن كانت فعلا مجرد سائحة غيرت طنجة حياتها، أم أنها جاءت لكي تدخل «عُش الجواسيس».
هل كان المغرب فعلا وكرا للجواسيس؟
لم يكن وجود الجواسيس في المغرب يقتصر على فترة الحرب العالمية الثانية لوحدها، فالحقيقة أن عملاء الدول الأجنبية نزلوا بقوة في البلاد منذ بداية القرن الماضي. خصوصا في مدينة طنجة التي أصبحت منطقة دولية، وصارت منذ سنة 1923، قِبلة عالمية شهيرة رسميا باعتبارها منطقة دولية، رغم أن سمعتها الدولية سبقت تلك السنة بفترة طويلة. ولم ينته وضع طنجة الدولية إلا في سنة 1956، مباشرة بعد استقلال المغرب.
بين الفترتين، عرفت طنجة إنزالا كبيرا في الجواسيس بشكل غير مسبوق، أكثر من أي فترة أخرى.
بعض المؤشرات التاريخية تقول إن وجود الجواسيس في المغرب بدأ أولا بوصول بعض الفرنسيين، لجمع المعلومات تمهيدا لاحتلال المغرب، بالموازاة مع وصول جواسيس آخرين من بريطانيا، لجمع معلومات عن البلاد قصد استعمارها. وبعد سنة 1906، أي بعد مؤتمر الجزيرة الخضراء، صار الصراع بين فرنسا وبريطانيا حول المغرب سياسيا، وازداد اهتمام كل من البلدين بالوضع الداخلي في البلاد، ورغب الدبلوماسيون العاملون في المغرب، وكانوا وقتها يستقرون في طنجة قبل أن تصبح دولية رسميا، في ربط علاقات مع الوزراء و«المخزنيين» المغاربة.
منذ سنة 1939، أي تاريخ بداية الحرب العالمية الثانية، صار وجود الجواسيس في طنجة «موضة»، حتى أن عددا من الأبرياء لاحقتهم تهمة الجاسوسية لصالح الحكومات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، وحتى النازية الألمانية. وما زاد من ترسيخ هذه الصورة، صدور عشرات الكتب والمؤلفات، ما بين التوثيق والروايات الخيالية، تتحدث عن مغامرات جواسيس من جنسيات أوروبية داخل المغرب، سيما في طنجة الدولية.
بالإضافة إلى مئات الأفلام السينمائية والأشرطة، التي تصور الجواسيس الأمريكيين، ومغامراتهم في شمال إفريقيا وسفرهم الدائم نحو العواصم الأوروبية، وتأقلمهم مع الحياة في المدن المغربية، خصوصا طنجة والدار البيضاء، وربطهم صداقات مع المغاربة لجمع المعلومات الاستخباراتية، أو القضاء على الروس والألمان الموجودين في المغرب.
هذه الأعمال السينمائية زادت من تهويل الرأي العام الدولي بشأن ما يحدث في المغرب. إلى درجة أن بعض الأسماء، ما بين مشاهير في السينما والأدب، وأثرياء عالميين، صارت تلاحقهم تهم الجاسوسية، فقط لأنهم كانوا يعيشون حياة رغيدة بمعايير أبطال الأفلام السينمائية التي تتحدث عن هؤلاء الجواسيس.
أما المغاربة فقد كانوا متوجسين جدا من هذا الموضوع، سيما مع انتشار روايات عن وجود فرنسيين متنكرين في المغرب ما قبل سنة 1912، وكيف أنهم أبانوا عن حقيقتهم بمجرد توقيع معاهدة الحماية بين البلدين. هذه الروايات الشفهية، لقيت انتشارا واسعا في المغرب، وتتحدث في الغالب عن مجهولين وغرباء، بـ«عيون زرقاء»، جاؤوا إلى المغرب واستقروا في بعض القرى وكانوا يتحدثون العربية بطلاقة، ومنهم من كانوا يحفظون القرآن الكريم، وعاشوا بين المغاربة بشكل عادي، إلى أن وصل الجيش الفرنسي إلى المناطق النائية في المغرب، وكشفوا عن وجههم الحقيقي واتضح أنهم كانوا يجمعون التقارير عن حياة المغاربة وتضاريس المناطق التي نزلوا فيها لتسهيل مهمة الجيش الفرنسي، أثناء نشر قواته في البلاد.
هذه الروايات كلها، رغم أنه لا توجد أي وثائق تدعم معظم هذه الروايات الشفهية المحلية، زادت من تعميق خطورة تهمة «الجاسوسية» التي وُجهت إلى الأجانب الذين عاشوا في المغرب، حتى قبل فترة الحماية بسنوات طويلة. حتى أن بعض المشاهير دفعوا ثمن هذه الاتهامات غاليا.
هذه أجواء الحياة العامة بالمغرب عند انتشار الجواسيس
يبقى السيد إدموند هولت، القنصل الأمريكي في المغرب ما بين سنتي1907 و1909، أحد أهم من وثقوا للحياة العامة في مدينة طنجة، قبل أن تصير دولية. إذ كان هذا الدبلوماسي يجمع مشاهداته، إلى أن أصدرها في كتاب مهم سنة 1914، أسماه «أرض الغروب». وهنا ننقل بعض مضامينه من الإنجليزية.
«طنجة مدينة بدون بلد». هكذا كان يرى جورج طنجة. مدينة لا تنتمي إلى المغرب، رغم أنها كانت تنتمي إليه فعلا. لكن الأجانب كانوا يحبون رؤيتها هكذا، مدينة منزوعة من سياقها وقابلة للاستيطان من جميع الجنسيات، في تعايش مع المغاربة، دون أن يسري عليهم ما يسري في بقية المدن المغربية. الأخبار وقتها كانت تقول إن الأجانب يتعرضون باستمرار لحملات تصفية جسدية على يد المواطنين الأصليين، الذين لم يكونوا يقبلون اختيار «النصارى» المغرب كوجهة للاستقرار. كانوا يرون فيهم جانبا خفيا من الشر، وكانوا محقين، لأن الأحداث التي جاءت بعد ذلك التاريخ كشفت أن طنجة لم تكن مجرد مدينة كما يقول «جورج»، حتى أنه استدرك الأمر لاحقا، وأهمله في العنوان.
يبدأ جورج كتابه بالقول: «اتبع الأشعة الحمراء التي تمثل الأشعة الممتدة من نيويورك وجبل طارق. حرّك قلمك ثمانية إنشات في اتجاه الجنوب، والنقطة السوداء التي يتركها القلم فوق الخريطة.. تلك هي «طنجة». إنها أقرب مناطق الشرق إلى الغرب. يمكن أن تصل إلى الشرق عن طريق تونس أو الجزائر أو مصر، لكن لا يمكن أن تدخله بنفس الطريقة التي تدخله بها من المغرب.
طيلة الساعتين اللتين تفصلان جبل طارق عن طنجة، والقرن التاسع عشر عن الثامن عشر والغرب عن الشرق، هناك كما يقول بيير لوتي: «كفن أبيض يلف كل توتر الحياة الحديثة، إنه الكفن القديم للإسلام»».
يحكي جورج عن حوار قصير دار بينه وبين مرشده في اللحظة التي كان فيها يخطو الخطوات الأولى في المغرب، وتحيط به أصوات الباعة وضجيج نميمة ضيوف المقاهي المتراصة على طول الجهة المقابلة للميناء القديم:
«- دعنا نجلس للحظة في هذا المقهى الصغير، لكي أوضح لك بعض الأمور التي ستجعلك تعيش حياة حقيقية في طنجة.
– لا، لن نجلس أبدا قرب ذاك الرجل صاحب الشنب الضخم. أستطيع أن أؤكد أنه مجرد جاسوس ألماني يريد معرفة ما سنقوله عندما نجلس. الجواسيس دائما يهتمون بالمحادثات العفوية. تعال، سنجلس هنا، حيث لا توجد كراس لكي يجلس خلفنا أحد.
– الآن، ودون أن تثير الانتباه، أدر رأسك ببطء يسارا. هل ترى ذلك الرجل البسيط هناك؟ يدخن سيجارة؟ إنه السيد «كيو». لقد كان نائب القنصل الفرنسي في مدينة الدار البيضاء سنة 1907، وهو الذي أعطى الأمر لقصف الدار البيضاء بالمدافع الفرنسية. هل ترى الشارة الحمراء الصغيرة التي يضعها على صدره؟ إنها شارة شرفية عسكرية».
هذه المحادثة التي رغم قصرها، إلا أنها تلخص بقوة الوضع الحقيقي في مدينة طنجة، قبل أن تصبح رسميا مدينة دولية، تسيرها حكومات بلدان أجنبية مختلفة. «وكر الجواسيس» كما كانت تصفها الصحافة الدولية، كانت فعلا كذلك.
قناصلة ودبلوماسيون أم مُخبرون؟
من المعضلات التاريخية التي عرفها المغرب، ما يتعلق بتصنيف عدد من الأجانب الذين اشتغلوا في المغرب، أو استقروا فيه، وما إن كانوا مُخبرين، أم مجرد موظفين وزوار؟
إذا تطرقنا مثلا إلى الصحافيين، سوف نجد أن أشهر صحافي زار المغرب، قبل الحماية، هو الصحافي البريطاني «والتر هاريس» الذي كان صديقا للمولى عبد العزيز، وفر بجلده من فاس قبل أن يُقتل على أيدي الغاضبين من وجوده في محيط القصر الملكي، والسبب أنه حُمل مسؤولية بعض الإصلاحات التي كان يرى فيها المحافظون تهديدا أجنبيا للمغرب. ورغم أنه مارس الصحافة وكتب عددا من المؤلفات عن المغرب، إلا أن تهمة الجاسوسية ظلت تلاحقه حتى عندما استقر نهائيا في طنجة الدولية، ولم يعد يتردد على أية مدينة مغربية أخرى، إلى أن مات في طنجة في بداية الأربعينيات من القرن الماضي.
هذا الصحافي، بخلاف الدبلوماسيين الأجانب، استفاد من وضعه الاعتباري عندما كان صديقا للسلطان، واستطاع فعلا كسب صداقات مع شخصيات مغربية كثيرة، ولهذا السبب تقوت الإشاعات التي راجت بشأن أنشطته الجاسوسية في البلاد، خصوصا قبل الحماية الفرنسية.
هنا، يتحدث المغامر البريطاني «آرثر كامبل» في كتابه «A ride in Morocco»، والذي ننقل هنا ترجمة حصرية لبعض فقراته، والتي يتحدث فيها عن فترة وجود قناصلة أجانب في مدينة تطوان. الكتاب يتحدث عن فترة 1897، أي قبل معاهدة الحماية بحوالي 15 سنة، ويصف بدقة أجواء الحياة اليومية للدبلوماسيين الأجانب، الذين كانوا أيضا متهمين بالجاسوسية لصالح حكومات بلادهم.
المثير في هذه المذكرات أن صاحبها ينقل كيف أن دبلوماسيين من مختلف الجنسيات، كانوا على اتصال ببعضهم البعض، في ظرفية حساسة لم تكن فيها حكومات بلادهم على وفاق دائم، بل كانت تمر بأزمات سياسية حقيقية، لكن هؤلاء الدبلوماسيين كانوا يجتمعون حول طاولات العشاء والمأدبات، تبديدا للوقت في مدينة تطوان، التي كانت مسرحا لصراع سياسي كبير بين فرنسا وإسبانيا بقصد احتلال المغرب.
يقول هذا المغامر في مذكراته:
«قُدم لنا العشاء وجلسنا نحن أربعة في الطاولة. كان القنصل شخصا مثيرا للاهتمام. وكان يحظى بتقدير كبير في المغرب، وكانت لديه ملكة اللسان وإتقان أدب الحديث. ثماني سنوات قضاها مقيما في المغرب، جعلته متآلفا مع كل الظواهر والعادات عند المغاربة. تعلمنا منه في غضون ساعات قليلة فقط، ما لم لا يمكن تعلمه خلال شهر مع المرشدين، أو حتى من خلال الكتب.
كيف يستطيع هذا الرجل الحديث هكذا! لقد مضت عليه ثمانية أشهر لم ير خلالها أي وجه بريطاني ولم يسمع لغته الأم، لكنه كان مسيطرا على الحديث طيلة السهرة.
بعد العشاء اقترح علينا القنصل التوجه معه إلى منزله، لقضاء ليلة هادئة عنده. وذهبت لكي أخبر «مورينو» أنني سوف أخرج مع القنصل. كان «مورينو» يعتقد أنني سوف أكون في خطر كبير، وأنني سوف أغامر بحياتي عند الخروج في وقت متأخر ليلا. لاحظت أنه مع «الجيلالي» كنا أربعة رجال بريطانيين، بالإضافة إلى بعض الخدم المغاربة الذين كانوا يحملون القناديل لإضاءة الطريق. سمح لي «مورينو» بالمغادرة، وحملني مسؤولية ما سيقع لي».
لم يكن الخطر الداهم ما يهم هذا الكاتب، فالمغامرات التي عاشها قبل ذلك العشاء، وكانت فيها حياته على المحك، تبقى أخطر بكثير من المخاطر التي قد تنتظره بعد مغادرة مأدبة العشاء، «الحافلة بالجواسيس».
من شريفة وزان إلى «روزاليندا».. تُهمة الجاسوسية بالمؤنث
شريفة وزان، أو إيميلي كين، التي جاءت من بريطانيا إلى المغرب سنة 1872، لاحقتها تهمة الجاسوسية بعد أن اشتغلت في إقامة الثري الشهير «بيرديكاريس»، الذي اختطفه الشريف الريسوني، بداية القرن الماضي، وطالب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بفدية لإطلاق سراحه.
شريفة وزان جاءت في البداية للعمل مشرفة ومعلمة لدى هذا الثري ذي الأصول الأوروبية، ثم قيل إنها كانت تعمل لصالح المفوضية البريطانية، بحكم أنها بريطانية الجنسية. وسرعان ما تقوت الإشاعات بشأنها في مدينة طنجة، عندما سرى خبر اعتزام شريف وزان، الشريف مولاي عبد السلام، الزواج منها.
كنا في «الأخبار» سباقين إلى نشر استطلاع عن ضريحها الموجود في مدينة طنجة وأحفادها ومصير مقتنياتها، سنة 2015، ووجدنا وقتها أن هذه السيدة البريطانية قد اعتنقت الإسلام فعلا، والدليل أنها مدفونة في مقبرة عائلة الشريف بمنطقة مرشان، ولو أنها بقيت على الديانة المسيحية لدُفنت في مقابر المسيحيين البريطانيين التي لا تبعد عن ضريحها الحالي إلا بكيلومترات قليلة.
اعتناق إيميلي كين الإسلام، من شأنه أن يفند أيضا تهمة الجاسوسية التي لاحقتها في طنجة، خصوصا عندما كان المارة من مختلف الجنسيات يتعرفون عليها وهي تتمشى مع زوجها الشريف، أو تتردد على إقامات أصدقائها البريطانيين الذين كانوا يعيشون في المدينة.
من بين الإشاعات التي نُسجت حول شخصية «إيميلي كين»، أنها تعمل على صفقة سلاح لفائدة الجيش البريطاني، وأنها تتجسس على الألمان الذين كانوا يعيشون في طنجة قبل سنة 1906، لكي تعرف أسرار الخطط العسكرية التي يخطط لها الألمان بقصد غزو شمال إفريقيا.
اتضح لاحقا أن «إيميلي كين» كانت أبسط من أن تشتغل مجندة لصالح مخابرات بلادها في المغرب، سيما وأنها عاشت بقية حياتها بين المغاربة، وتمسكت بالبقاء في المغرب حتى بعد رحيل زوجها.
الفرق بين شريفة وزان، وبين «روزاليندا باول فوكس»، أن الأخيرة كانت تنتمي إلى أسرة ثرية جدا، وورثت بعد فراقها عن زوجها الثري ما يكفي من المال لكي تعيش حياة رغيدة و«برجوازية» في طنجة الدولية. بينما إيميلي كين كانت تنتمي إلى أسرة بريطانية عادية، وجاءت إلى المغرب للعمل وليس للسياحة.
كما أن ما جعل التهمة التي وُجهت إلى «روزاليندا» تكون أقوى حدة من تهمة الجاسوسية التي وُجهت إلى إيميلي كين، بعد زواجها من شريف وزان، أن «روزاليندا» جاءت إلى المغرب بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية. ومع انتشار الأخبار عن ثروتها الكبيرة ورحلاتها الكثيرة حول العالم، كانت مرشحة مثالية لنيل تهمة الجاسوسية. وما زاد من ترسيخ التهمة، أنها تزوجت من «خوان لويس بيجبيدر»، المفوض السامي الإسباني. وقيل وقتها إن زواجها منه كان مخططا له، لكي تكون قريبة من مصادر المعلومات بشأن العمليات العسكرية الإسبانية في شمال إفريقيا، خصوصا في منطقة تطوان.
رغم المأساة التي حلقت فوق حياة الشابة «روزاليندا»، بحكم طلاقها من زوجها الأول، ومعاناتها مع المرض، إلا أنها لقيت هجوما شرسا من الصحافيين والدبلوماسيين والسياسيين الأجانب الذين كانوا يعيشون في شمال المغرب، وكانت تعلم بشأن تهمة الجاسوسية الموجهة إليها.
القصتان معا تؤكدان أن تهمة «الجاسوسية»، الموجهة إلى النساء على وجه الخصوص، عمّرت طويلا في المغرب، سواء قبل فرض الحماية الفرنسية على المغرب، واحتلال شمال البلاد من طرف الإسبان، أو بعدهما.