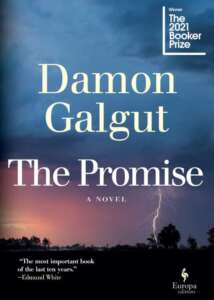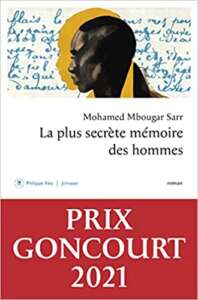إعداد وتقديم: سعيد الباز
كانت هذه السنة كسابقتها استثنائية، خاصة على المستوى الثقافي والإبداعي. فبسبب تداعيات فيروس كورونا استمر التوقف الاضطراري لجلّ الأنشطة الثقافية من حيث النشر والملتقيات. لكن، في الوقت نفسه، ظهر اهتمام أكثر بوسائل التواصل عبر الإنترنيت من خلال تنظيم لقاءات افتراضية عن بعد، ما أبرز أهم الملامح لمستقبل الغد، وطرح كذلك، في الآن نفسه، إشكالات الوضع الثقافي في المغرب وصور اختلالاته من جهة، ودور العامل الثقافي في تحصين الوعي الاجتماعي لمواجهة الأزمات من جهة أخرى.
أمّا على مستوى الجوائز التي يعتبرها البعض معيارا للحركية الثقافية والإبداعية، فعربيا كانت الجائزة العربية العالمية من نصيب الأردني جلال برجس دون لغط أو ضجيج إعلامي كما كان في الدورة السابقة، وعالميا تسيّد الأفارقة معظم الجوائز الكبرى.. من خلال تتويج التنزاني عبد الرزاق قرنح بجائزة نوبل للآداب، والجوائز الأخرى بشقيها الأنكلوساكسوني والفرانكفوني، البوكر للجنوب إفريقي دامون غالغوت، والغونكور للسينغالي الشاب محمد مبوغار سار.
إبراهيم الحَيْسن.. حصيلة تشكيلية تحدَّت ظروف الجائحة
رغم ظروف جائحة كورونا المرعبة، لم يمر العام الماضي في المغرب دون أنشطة فنية وتشكيلية فردية وجماعية ميَّزت الحصيلة الجمالية، حيث أقيمت معارض فنية متنوِّعة، فردية وجماعية، ساهم فيها فنانون ومؤسسات خاصة وأخرى تابعة للدولة. وقد عكست هذه المعارض والفعاليات الثقافية تحدِّياً لهذه الجائحة مع الأخذ بعين الاعتبار البروتوكول والتدابير الاحترازية التي دعت إليها الجهات الأمنية والصحية. ولم تثن الجائحة الفنانين التشكيليين عن الإبداع في عزِّ الأزمة الصحية المرعبة التي شلت حركة العالم برمته وضربت الثقافة والاقتصاد والسياحة والخدمات الاجتماعية في العمق، ما نتج عنه خسائر وأضرار كثيرة ومتنوِّعة، وأقيمت بالتالي فعاليات عديدة لم يكن من السهل إقامتها بسبب صعوبة الحصول على التراخيص وفي غياب المتلقين بالعدد الكافي، مما فرض التواصل والتتبع والمعاينة. في العديد من الأحيان. عن بعد وعبر الوسائط التكنولوجية المتاحة.
نذكر في هذا الإطار، بعض المحطات الفنية الأساسية التي ميَّزت المغرب التشكيلي خلال العام الماضي وهي ليست حصيلة تقييمية لذلك، منها مثالاً الأنشطة التالية:
معرض «قطاف الأهلة» دعماً للشعب الفلسطيني الشقيق والذي أقيم في الرباط خلال نونبر 2021 بمبادرة من النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين ودار «مزاد وفن» بطنجة، تحضيراً لمزاد علني للوحات التشكيلية أقيم في موفى الشهر المذكور، وقد عاد ريعه لفائدة وكالة بيت مال القدس الشريف، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقد استجاب لهذه المبادرة الفنية الإنسانية أزيد من مائة فنان وفنانة، التي جسَّت وعي المبدعين المشاركين بالقيم الفُضلى تعزيزاً لقيم السلام والتعايش التي ترمز إليها مدينة القدس باعتبارها مدينة جامعة لأتباع الديانات السماوية الثلاث.
إلى جانب ذلك، أقيمت فعاليات ومعارض فنية كثيرة متباينة من الصعب رصدها كاملة، في التصوير والكاريكاتير والنحت والتعبيرات المعاصرة الجديدة، أغلبها في تطوان وطنجة والرباط والدار البيضاء ومراكش والصويرة، نذكر من ذلك، مثالاً لا حصراً، معرض الفنانين الراحلين: طلال شعيبية بالرواق الفني التابع لصندوق الإيداع والتدبير في الرباط تخليداً لذكراها ولمنجزها الفني الذي مثل المغرب وشرفه في أكثر من مناسبة دولية. وكذا المعرض الاستيعادي «لحظة شاعرية» للفنان عباس صلادي الذي احتضنه متحف بنك المغرب في الرباط خلال فبرايرـ يونيو 2021.
ومن المعارض الأجنبية التي شهدها العام الماضي، نذكر المعرض الفوتوغرافي «مسافات» الذي نظم خلال أبريل ـ يونيو 2021 بالمتحف الوطني للتصوير الفوتوغرافي وحديقة التجارب النباتية والمعهد الثقافي الفرنسي في الرباط، وهو يخلد لحظات للحياة البشرية في ظل الأوضاع الحالية التي سبَّبتها أزمة كورونا.
على مستوى البنيات التحتية المرتبطة بالمجال التشكيلي، شهدت مدينة طنجة إنشاء متحف القصبة فضاء الفن المعاصر، وذلك خلال شهر دجنبر المنصرم، وهو معلمة فنية تقع داخل بناية السجن القديم للقصبة، ويرُوم القائمون عليها المساهمة في إنعاش المشهد الفني والإبداعي بالمنطقة.
على مستوى الإصدارات والمنشورات الفنية المنجزة خلال العام الماضي، نذكر: كتاب شفيق الزكاري «سرديات تشكيلية» (مختارات جمالية)، صادر في طبعته الأولى عام 2021 ضمن منشورات دار القلم العربي للنشر والتوزيع- القنيطرة، المغرب.
ونأمل أن يشهد العام الجديد ظروفاً أفضل وأحسن وأن تعود الحياة الفنية والثقافية إلى طبيعتها، الأمر الذي سيمكن الكثير من المبدعين من الإنتاج وعرض وتقديم منجزاتهم الفنية التي طالها الحظر وقلة الدعم والتحفيز، ولنتفاءل بعام 2022 ليكون «عام الإبداع بامتياز»، إن شاء الله..
صالح لبريني.. الحصاد الثقافي بين ألم الغياب وأمل الحضور
الثقافة المغربية وسؤال الجدوى
يبدو أن الحديث عن المغرب الثقافي، خلال سنة 2021، يثير الخجل والشعور باللاجدوى، فالرأسمال اللامادي أصبح مغيّباً في المغرب، لدواع كثيرة؛ متداخلة ومتشابكة، على اعتبار أن الممارسة الثقافية بالمغرب محكومة بالسياق السياسي منذ عقود من الزمن، ومادام الفعل السياسي مصابا بالاعتلال والسقم، فإن الفعل الثقافي سيصاب بعلله وأسقامه. الأمر الذي سيقودنا إلى القول إن الحركية الثقافية ممارسة وحصيلة يمكن نعتها بأنها تساوي العدم، حيث نلاحظ الشللية الجلية على الساحة الثقافية المغربية، خصوصا بعد إعلان الدولة تمديد حالة الطوارئ الصحية بفعل كوفيد 19، هذا الأخير أعلن -بكل صراحة- عن موت المغرب ثقافيا، فلا حياة ثقافية موجودة مادامت دور الثقافة والمسارح والنقص الحاصل في قاعات السينما وطنيا اللسان الناطق باسم أزمة حقيقية تعيشها ثقافتنا المغربية، بل إن الدولة تسهم في تكريس وضع ثقافي معطوب ويزداد تراجعا ينذر بتأثيرات سلبية على بناء إنسان مغربي متحرّر من كل الأغلال التي تزداد تعدّدا وابتكارا في الأشكال والقوالب المحنطة هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المؤسسات الثقافية الأخرى من اتحاد كتاب المغرب وبيت الشعر وهيئات المجتمع المدني ذات الميولات الثقافية لم يعد لها أيّ دور يذكر في تحريك عجلة ما هو ثقافي بالشكل المطلوب، بقدر ما ظلت جامدة لا روح فيها، تراقب الوضع دون أن تؤثّر في مجرياته، فغدا المثقف مجرّد متفرج وغير فاعل ولا متفاعل مع أحداث وقرارات سياسية زادت الطين بلة، كل هذا يجعل السؤال الثقافي مغيّبا ولا وجود له، على أساس أن الفاعل الثقافي مقيم في دار غفلون لا أثر ولا تأثير في الحقل الثقافي ومن ثمّ في المجتمع. ويعود هذا الموت الثقافي إلى أن دور النشر المهتمة بالكتاب لم تعد تخلق الحدث، في ظل الأزمة الخانقة الناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد 19؛ لكونها لا تملك الجرأة على المغامرة في مجال تحوّل إلى سبب من أسباب هذا الارتكاس الثقافي المهول والخطير في الآن نفسه.
هناك أمل قادم رغم ألم الواقع
ومع ذلك لابد من الإشارة إلى عدة مبادرات كان لها الإشعاع والفعالية في زرع روح الحياة من جديد في جسد الثقافة المغربية، ويمكن اعتبارها منارات أضاءت ما ادلهم من ليل في سماء المغرب الثقافي، وأيقظت الرغبة في مواصلة المسار، رغم كل المعيقات، هكذا يأتي الضوء من مبادرات مهمة تبّنت إصدار كتب ومجلات كما هو الشأن لمؤسسة مقاربات التي أقدمت على مغامرة النشر والطبع، عبر إصدار ثلاثين ديوانا شعريا مغربيا احتفاء باليوم العالمي للشعر، وهي بادرة محمودة منحت للشعر متنفّسا جديدا؛ علاوة على هذا جائزة أركانة العالمية للشعر التي يمنحها بيت الشعر بالمغرب والتي فاز بها الشاعر محمد الأشعري، ووصول كتاب ومبدعين مغاربة إلى القوائم الطويلة لأهم الجوائز العربية . كما أن فوز الشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي بالجائزة الكبرى للشعر «روجر كوالسكي» بفرنسا خفّف نوعا ما من هذا اليباس الثقافي، وأعاد الاعتبار إلى الشعر، وتجاوزا يمكن الإشارة إلى جائزة المغرب للكتاب التي تمّ الإعلان عنها مؤخرا، وهي جائزة لم تعد تلقى الاهتمام من لدن المثقفين، ومع ذلك ففي جنس الشعر كانت منصفة لعلمين شعريين وهما محمد علي الرباوي ورشيد المومني، ولكن مناصفتها بين الشاعرين كانت قاتلة ومؤلمة، ولابد من الإشارة إلى بيتين شعريين بكل من بيت الشعر بمراكش وبيت الشعر بتطوان عملا ما في وسعهما من تحريك مياه الثقافة المغربية الجامدة. ثم بيت الرواية المغربي الذي يديره الروائي عبد العزيز الراشدي فقد سلط الضوء على كتاب روائيين مغاربة، دون أن ننسى المعارض الجهوية للكتاب التابعة لوزارة الثقافة التي تبذل مجهودات جبارة في التعريف بالإبداع الجهوي والقيام بالإشعاع الثقافي في ظل غياب الإمكانات.
إن وضع الممارسة الثقافية بالمغرب يستدعي تغيير إواليات الاشتغال والتفكير في طرق جديدة ووسائل جد متطورة لجعل الثقافة شأنا مجتمعيا وليس فعلا نخبويا، ورهانا حضاريا بإمكانه إعادة الاعتبار للعقل والوجدان الجمعيين.
كمال أخلاقي.. الحصيلة ووهم الزمن الثقافي
كيف يمكن إنجاز حصيلة في غياب أنشطة حقيقية وفي غياب دخول ثقافي مؤطر. لا يمكن إنجاز حصيلة ثقافية، وثمة فراغ تقافي كبير ومهول، وهوة تتسع كلّ سنة أكثر فأكثر بين الشأن الثقافي والمجتمع. لا أعتقد أنّ مشجب كورونا يكفي لنعلّق عليه فشلنا في التدبير الثقافي في البلاد (للانتباه فقط: عندما كانت إيطاليا في الحجر الصحي، كان العازفون على الشرفات، وكانت الأغاني والأشعار…) مفيد لنا أن نكتشف أنّ المعرض الدولي للكتاب كان هو الشجرة التي تخفي غابة الهامش الثقافي الذي نعيشه. يبدو أنّ الاهتمام بالرياضة وبالبطولة الوطنية أكثر من الاهتمام بالشأن الثقافي، وإن كان هذا الأمر ليس جديدا. لكن لن يتغيّر وضعنا الثقافي حتى نعترف دون مواربة أنّ الثقافة عندنا مجرّد مسحوق تجميل رخيص جدا. حسنا، من أراد أسئلة قد تسبب جروحا فها هي بعضها: كم نطبع من كتاب في السنة؟ كم نقرأ من كتاب في السنة؟ كم معرض فني؟ وكم مسرحية؟ وكم فيلم سينمائي؟ إنّه بؤس ثقافي عام تستفيد منه بعض لوبيات الفساد التي تنشط في القطاع بأموال ريع ثقافي سنوي. إنّها نفس الوجوه الشاحبة التي تخنق كل حركة ثقافية وإبداعية تحاول في استماتة أن تنشر أنوار المعرفة والإبداع. فكيف سنتحدث عن حصيلة ثقافية والمبدعون والكتاب مهمشون ومقصيون عن ممارسة أدوارهم الطبيعية والضرورية في نشر المعرفة والإبداع.
في مجال الشعر، عاش الشعراء المغاربة هذه السنة في عزلة تامة عن بعضهم البعض، كأنهم في أرخبيل وجودي تحيط بهم مخاوف الوباء من جهة وفقدان الثقة إلى متلقٍ يؤمن بضرورة الشعر، وبجدواه لتحمّل عبء هذا الزمن الجديد الذي فرضته الجائحة، ولم يستطع الأوصياء على الشأن الثقافي والإبداعي ابتكار آليات لتداول الشعر وإيصاله إلى الناس. حتى دور النشر عجزت عن اختراق هذا الصمت، واكتفت بنشر أعمال قليلة لشعراء يحملون أسماء قديمة. كأنّ الشعر المغربي لا يتقدم ولا يقترح أسماء وتجارب جديدة، قد لا تنشر في الغالب إلّا في صفحات الفيس بوك. وهناك من فضّل، مرغما، نشر ديوانه في دور نشر عربية كي لا يتحتّم عليه دفع مبلغ ماليّ إلى الناشر المغربي، الذي لا يرى في المنجز الشعري إلّا سلعة كاسدة بعد تعثر برنامج دعم الكتاب الذي كان يستفيد منه بعض الناشرين.
سؤال الحصيلة الثقافية هو سؤال «الحصلة» الثقافية. ففي كلّ سنة نحاول أن نوهم أنفسنا بالقيام بجرد لبعض الأنشطة الثقافية والفنية، معتقدين أننا نعيش زمنا ثقافيا، وأننا نصنع حياة ثقافية لنا ولأبنائنا. بيد أنّ واقع الحال، يقول إننا نبتعد كثيرا عن كلّ تصوّر ثقافي يمكنه أن يساعدنا في بناء مجتمع الوعي والقيم والتقدم. فهل نحتاج إلى ثورة ثقافية؟ الجواب نعم، والآن قبل الغد.
على سبيل الاقتراح..
يمكن في هذا الصدد تقديم جملة من الاقتراحات لاستشراف غد ثقافي حقيقي وواعد وكفيل بخلق زمن ثقافي وإبداعي:
1-إعادة النظر في برنامج دعم الكتاب باعتماد سياسة دعم المؤلف والمبدع قبل الناشر.
2-تشجيع الكتّاب الشباب من خلال سلسلة الكتاب الأوّل.
3-خلق جائزة للكتّاب الشباب في حقول إبداعية ومعرفية متعددة.
4-إحداث مراكز جهوية للاستثمار الثقافي والفني.
5-وضع خطة وطنية تمكّن من تشجيع القراءة والتداول الثقافي المثمر.
عبد الله بن ناجي.. في الحاجة إلى الفعل الثقافي
ما قد تكون حصيلة الثقافة المغربية خلال هذه السنة والجو حالك وسديم، القيود تقيّد العالم، والخوف يحيط بقلوب الناس ويحجر على الأذهان؟ لا إبداع مُوفّق وسط الموانع… الإبداع قرين الحريّة والانفتاح؛ الأقدام المغلولة لا تُسرع بخطى الأقلام! الإغلاق التام أو الجزئي حتّى، كان مؤثرا على المثقف كاتبا وفنانا؛ الثقافة تحيا بالتفاعل والتدافع؛ ثم هل يمكن اعتبار المشهد الثقافي، استثناءً، قد حقق ما يُذكر خلال هذه السنة الآيلة للأفول؟ يصعب الجزم بذلك!
إن ما حققه الكاتب المغربي من إشعاع بفوزه بجوائز في المشرق ليس تجسيدا لحركية تُرسخ الفعل الثقافي في حياة المجتمع ومؤسساته؛ وبعض المؤسسات الثقافية، بدورها، حين نظمت أنشطتها، بعد فسحة تخفيف القيود، فإنها لم تُفلح في تحريك عجلة هذا الفعل، الذي انزوى في أقصى شعاب الذهن ومسالك الدبّ اليومي في الحياة، لصالح هواجس البقاء والأمن الغذائي الذاتي.
ومادامت الثقافة تتصل اتصالا وثيقا بالإنسان، فمن البديهي أن نعرج على النموذج التنموي الجديد، وذا بدوره احتل فيه المكون الثقافي حيّزا هامشيا، لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ والأمر قد يبدو مُبَرَّراً مادامتْ أولوياتُ السياسة المغربية تتجه نحو النهوض الاقتصادي ومحاربة الهشاشة الاجتماعية عبر مأسسة الدعم وتقويته، لكن حاجة الإنسان المغربي لفعل ثقافي، يُسهم في تنمية القُدرات الإبداعيّة، التي تعدّ أساسا لتقوية مهارات الإنسان الحياتية اللازمة للانخراط الفاعل في جميع جوانب الحياة، ليست حاجة ثانوية، بل ضرورة حتمية، وخلفية لإنجاح مشاريع المؤسسات في مختلف القطاعات.
وفي ظل الجائحة خلال هذه السنة كانت حصيلة الفَقدِ كبيرة وموجعة، وغير متوقعة؛ إذ فقدت الساحة الثقافية كُتّابا وباحثين جادين في الإبداع والنقد على السواء، حيث رحل عنّا، بحرقة المعنى المفتقد في الحياة، الشاعر العزيز حكيم عنكر، والروائي والناقد الأريب إبراهيم الحجري، والكاتب والناقد القدير بشير القمري والمفكر والفيلسوف الحداثي محمد سبيلا، وغيرهم كثير في مختلف المجالات الثقافية؛ إنها سنة حصيلتها الحزن والأسى؛ وإذا كان الموتُ أمرا حتميا، يُغيّبُ الإنسان ماديا لا معنويا، ولا سبيل لرده أو التحكم في مواقيته، فإن ظروف الجائحة قد غيّبت العديد من مظاهر الحياة الثقافية بخيارات بشرية مؤسساتية خلّفت العديد من التساؤلات، منها إلغاء المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء، ولا شك أن المعرض كان يشكل مساحة لتحريك المشهد الأدبي والفكريّ بالمغرب، وخلق دينامية في الحوار الثقافي بين المثقفين المغاربة أنفسهم، وبينهم وبين محيطهم العربي والدولي، بما يسمح به من تداول ورقيٍّ فكريٍّ، علميٍّ وإنسانيٍّ.
وإذا كانت الجائحة قد غيّرت أنماط السلوك البشري في العالم أجمع، ومعه سلوك الإنسان المغربيّ طبعا، فإن الأدب المغربي والفن المغربي عامة بقي رهينا لمتخيّله الشعري والسردي والفني، بعيدا عن سياق الراهن، الذي فرضته ظروف الجائحة، حيث كان من المنتظر أن ينحاز الأدب والفن لعمق هذا العارض الوبائي، والمنفلت منه، لكن سيرورة الأدب والفن تابعتْ خطوها في رتابتها الشعرية والسردية ما بين كواليس الذات ومخرجاتها، إلا ما كان من حِواريات ومَحكيات ظلت نشازا، لم ترق إلا مستوى الكتابة الفاعلة في توصيف الحالة الوبائية واستكناه أبعادها وامتداداتها في حياة الناس أفرادا وجماعات، أو تحويلها إلى حالات إبداعية غايتها تعميق الوعي بالظاهرة والتخفيف من شدة وطأتها.
وبالعودة إلى المحطات الثقافية المغربية السنوية الاعتيادية، لم يحدث ما يشد الانتباه، وذلك أن جائزة المغرب للكتاب ما حملت جديدا في أسمائها، ولسنا هنا في سياق نقد نتائجها، لأن المتوجين كانوا أهلا لها، ولا غرو! لكن السؤال حول أسباب عقم رحم المشهد الأدبي المغربي في قدرته على إنجاب مبدعين وباحثين قادرين على إغناء الثقافة المغربية بقدرات تنافسية ورؤى إبداعية مختلفة، يبقى سؤالا مشروعا؛ الجواب عنه يحيل إلى مسألة الأدوار التي ينبغي أن تضطلع بها المؤسسة الثقافية والكاتب المبدع والباحث نفسه؛ ثم غير بعيد عن المؤسسة الثقافية، احتجبت مشاريع دعم الكتاب والمشاريع الثقافية دون تفسير، إلا ما كان من مبررات إكراهات الجائحة، وتحويل قنوات الدعم للقطاعات الاجتماعية المتضررة.
إجمالا، تبدو الحصيلة الثقافية في المغرب هيّنة الشأن، فلا الحضور أسعف المثقف في الفعل، ولا تقنيات الزوم الرقمية في التواصل عن بعد خففت من وطأة العزلة والانعزال الثقافي، وسادت حالة الترقب والانتظار، لا القدرة على المبادرة لتكسير جدران إحباطات الحجر الصحي بأنشطة تنسجم وواقع الجائحة الراهن أَمْكنَتْ، ولا الركون إلى الركن لإخراج أعمال أدبية وفنية بميسم الاختلاف تحققتْ؛ ويبقى عارض الوباء الحصيلة الواقعية، والفعل المتحقق الذي لا مراء فيه ولا جدال.
عبد الرزاق قرنح: لا وجود لمكانٍ جغرافيّ للتراث الكتابي
أثار فوز الروائي التانزاني عبد الرزاق قرنح بجائزة نوبل للآداب لسنة 2021 مفاجأة كبيرة خاصة في الأوساط الثقافية العربية. الروائي عبد الرزاق قرنح من مواليد زنجبار ومن أصول يمنية وبالتحديد من حضرموت، وسبب هذه المفاجأة أنّ هذا الاسم الكبير ظلّ مجهولا لدى القارئ العربي، ولم تترجم أعماله إلى اللغة العربية، ولم تشر إليه المتابعات النقدية والإعلامية العربية. اضطر عبد الرزاق قرنح إلى اللجوء إلى إنجلترا في مطلع شبابه فرارا من الاضطهاد الذي عانى منه الزنجباريون من أصول عربية وهندية، فكانت جلّ أعماله الروائية تتطرق إلى قضايا اللجوء والاقتلاع القسري من الجذور الأصلية والشرخ العميق في الذاكرة الذي أحدثته مرحلة الاستعمار وما بعدها. يقول عنه رئيس لجنة الجائزة، في تقديمه، إنّ رواياته تفتح أنظارنا على شرق إفريقيا المتنوع ثقافيا وغير المألوف للكثيرين في أجزاء أخرى من العالم، ويضيف أنّ في عالم عبد الرزاق قرنح، كلّ شيء يتغيّر، الذكريات والهويات… ربما يكون هذا لأنّ مشروعه لا يمكن أن يكتمل بأيّ معنى نهائي… هناك استكشاف لا ينتهي مدفوعا بشغف فكري موجود في جميع كتبه، وبارز بنفس القدر الآن، كما هو الحال عندما بدأ الكتابة كلاجئ يبلغ من العمر 21 عاما.
إنّ العالم الروائي لعبد الرزاق قرنح ما زال لم تتح له الوسيلة ليتعرف عليه القارئ العربي، ونكاد لا نجد له سوى النزر اليسير، من بينه المقابلة النادرة التي أجراها معه الصحفي العراقي سعيد فرحان منذ أكثر من عقد من الزمن وبالتحديد سنة 2008. فعن تيمة المنفى وبحث شخوصه دون جدوى عن معنى للوجود ورغم انصهارهم في البيئة الغربية الجديدة ظلوا مرتبطين بموطن الطفولة، يقول قرنح: «ما أقترحه هو أنّه من الصعب جدا بل من المستحيل الانصهار كليا في مجتمع جديد مهما كانت معاني هذا الانصهار. ما تصفه بالضيق وبانعدام المعنى هو الصيرورة المستمرة للخيال الذي ليس له مكان مادي. إنّه يتنقل مع صاحبه. كل شخص له حياة داخلية وخارجية، الخيال والواقع اليومي ولكن المسافة بين الاثنين في حالة المنفي هي بشكل ما كثيرة الاتساع». أمّا السؤال عن أصوله العربية، والتأثير العربي في كتاباته الروائية فيقول: «لا أعتقد أنّ هنالك تأثيرا عربيا في طريقة كتاباتي. لا أتكلم العربية رغم أنني تعلمت قراءة القرآن في طفولتي والكثير من القصص التي سمعتها طفلا والتي تتنقل في رواياتي لها أصل عربي، فارسي وهندي بوجه الاحتمال. زنجبار كانت ولا تزال مكانا لثقافة كثيرة الامتزاج. أما في ما يخص أصولي العائلية فوالدي ينحدر من أسرة يمنية».
في المقابل، لا نجد ما يضيء عالم عبد الرزاق قرنح سوى نصوص قليلة مترجمة هنا وهناك، وبعض الإشارات في انتظار ترجمتها بالكامل والاطلاع عليها بشكل واسع، لعلّ أوضحها نص قمر الضحى بترجمة الكاتب المصري أحمد شافعي: «… كنت في ذلك الحين أحضر حصصه وحدي منذ بضعة أسابيع، فباتت تتاح لي بعض الحريات الصغيرة. نهضت واقتربت أكثر من الجدار. تمهلت أمام المطبوعة، ثم رأيت فجأة أنها خريطة أولية للعالم مقلوبة رأسا على عقب. وكان شكل إفريقيا هو الذي ألهمني الإجابة. قلت «خريطة. لماذا هي مقلوبة رأسا على عقب؟»
ابتسم سعيدا بفضولي. وقال «بتلك الطريقة كانوا يرسمون الخرائط في ذلك الوقت. لا أعرف السبب». كان رسام الخريطة يدعى «فرا ماورو»، وهو راهب عاش في جزيرة صغيرة في خليج فينسيا، ورسم خريطة للعالم دون أن يتحرك قيد أنملة من موضعه. لم أكن سمعت بفينسيا في ذلك الوقت ولا أعرف ما البحيرة، ولا أدرك ما الراهب. وقلت ذلك كله لمعلم حسن فأرجع رأسه إلى الوراء لوهلة، مبتسما أمام ذلك الجهل المطبق. ثم حكى لي عن فينسيا وجزيرة مورانو التي عاش فيها فرا ماورو. تكلم عنهما وكأنهما مكانان عرفهما. أنصت فرا ماورو إلى ما حكاه المسافرون، ونظر في ما توافر له من مصادر، ثم أنتج خريطة للعالم كانت أدق من أي خريطة قبلها. خطر لي أنه لا بد أن يكون بـ«فرا ماورو» شبه قليل بمعلم حسن نفسه، برغم أن معلمي ما كان ليعرف كيف ينتج خريطة للعالم. لكنه شأن الراهب، كان شخصا يعيش في خياله، ويسافر في عقله. فقد كنت أعلم علم اليقين أن معلم حسن لم ير فينسيا قط. ولو فعل لعرفنا جميعا. ودعكم من فينسيا، لقد كنت لأندهش لو كان خرج من أُنجوجا. كان الناس يأتون علينا ويذهبون، ويسهل التعرف على المسافرين من ثقتهم في أنفسهم، واختيالهم الجلي، وحديثهم. وكان يسهل على المرء بالمثل أن يعرف من الذين لم يذهبوا قط إلى أي مكان، ومن أولئك كان معلم حسن، حتى لو كان كثير جدا من قصصه عن البحار.
في المرة التالية التي كلمني فيها عن الخريطة، حكى لي عن الأعلام الصغيرة فيها، والحاوية معلومات من مصادر كثيرة عن أماكن نائية. قال إنه لا يمكن قراءتها في تلك النسخة بسبب ضآلة حجم الخط، فضلا عن أن الكتابة عموما كانت باللاتينية التي لم يكن يجيد القراءة بها. تم تدارك نفسه وتذكر سبب وجودي هناك فأرجعني إلى تمرين القسمة الطويل الذي قاطعه.
لكنه لم يملك إلا أن يرجع إلى الخريطة، ففي المرة الثالثة التي كلمني فيها، حكى لي عن المكتوب في أحد الأعلام الصغيرة. كان عن سفينة رمت بها عاصفة إلى بحر الظلمات، حسب تسمية العرب للمحيط الأطلنطي. في صباح اليوم الذي أبحرت فيه من المكلا إلى الساحل الأسود، رأوا قمر الضحى شاحبا في السماء. كان على متن السفينة ركاب، نساء ذاهبات إلى أزواجهن الذين سبقوهن إلى هناك ورجال ساعون إلى نصيب من كعكة تلك الأرض الخضراء. قالت امرأة إن القمر الشاحب ذلك نذير شر. وقالت إن الجميع يعلمون بأس النذر، وإن الحكيم من انتبه. فلا تهملوا عمل ما لا بد من عمله. صاح فيها من سمعوا تلك الكلمات يطالبونها بالصمت، لكي لا تجلب عليهم النحس. ولكن بعد فوات الأوان وحضور النذير. بعد أيام قليلة في عرض اليم، عصفت بهم الريح فأبعدتهم بعيدا ولم يعد بوسعهم الرجوع إلى البر. كل ما كان بوسعهم هو التوغل إبحارا نحو الجنوب، راجين أن تتبدل الرياح وتتيح لهم الانعطاف إلى الغرب. ولما انعطفوا فعلا، أدركوا أنهم تجاوزوا كل البر، ونأوا إلى ما وراء رأس إفريقيا. ولم يكن أحد يعرف يقينا في تلك الأيام أن لإفريقيا رأسا».

جلال برجس.. دفاتر الورّاق
نال الشاعر والروائي الأردني جلال برجس الجائزة العالمية للرواية العربية لهذا العام في دورتها 14 بفضل روايته «دفاتر الورّاق»، وهي تحكي لنا قصة بطلها إبراهيم بائع الكتب والقارئ الشغوف التي يتماهى مع قراءاته المتعددة وفقدانه لكشكه وتعرضه لحياة التشرد. يقول رئيس تحكيم الجائزة الشاعر اللبناني شوقي بزيع عن الرواية: «قد تكون الميزة الأهم للعمل الفائز -فضلا عن لغته العالية وحبكته المحكمة والمشوقة- هي قدرته الفائقة على تعرية الواقع الكارثي من أقنعته المختلفة، حيث يقدم المؤلف أشد البورتريهات قتامة عن عالم التشرد والفقر وفقدان المعنى واقتلاع الأمل من جذوره، مما يحول الحياة إلى أرخبيل من الكوابيس». ويضيف «مع ذلك، فإن الرواية ليست تبشيرا باليأس، بل هي طريقة الكاتب للقول إن الوصول إلى الصخرة العميقة للألم هو الشرط الإلزامي لاختراع الأحلام، وللنهوض بالأمل فوق أرض أكثر صلابة».
يستلهم الروائي جلال برجس مدينة عمّان، خاصة على المستوى الجغرافي، ويتخذ من شخصية إبراهيم الورّاق رمزا للمثقف الأردني والعربي في ظلّ الوضعية المتردية للثقافة والمثقفين عموما، يقول: «من هنا ولدت شخصية الورّاق المثقف أمام زمن باتت الثقافة فيه تتراجع لتحل محلها أنماط حياتية جديدة، إن العالم يتغير بسرعة مرعبة لا يستطيع الإنسان العربي مجاراتها، لهذا نشأت كثير من الأزمات، إحداها ما مني به بطل الرواية (إبراهيم الورّاق)».
إبراهيم (حمْل شرير)
كنت مثقلا بالحزن كقطعة إسفنج أُشبعت بالماء حينما نظر رجل في السبعين من عمره بوجهي وهو يدفع لي ثمن كتاب اشتراه، ثم قال قبل أن يمضي متوكئا على عكازه واختفى في زحام وسط البلد: (كلّما كثر صمتك كبر حزنك).
بعد كلّ تلك السنين ها أنا أتذكر ما قاله ذلك الرجل وأكتب رغم قناعتي من أن الكتابة لن تجعلني أنجو ممّا وصلت إليه، ولن تردم هوة معتمة تخلقت بي على نحو مبهم، بل لأغطيها فأحظى بسكينة لو حدثت لي ستجعلني أبتسم بوجه أيّ وجع مهما بلغت درجاته. ليتكم تتخيلون حجم سعادتي بهذا الدفتر ذي الورق الأبيض الصافي، وهذا العدد من الأقلام، أثمن هدية في حياتي الغريبة قدمتها لي امرأة حينما رأيتها لأوّل مرة شعرت ببرق يهوي في سماء روحي، أقسم إنّي شعرت بهذا، فعرفت أنّ للحبّ يدا قادرة على انتشال غريق يلفظ نفسه الأخير في بحر هذه الحياة المالح. لكن هل عشت أم متّ؟ سؤال ظل معلّقا منذ تلك السنة أمام عيني وأنا أرى كيف تركتِ الغرابةُ كلّ شيء في هذا العالم، وأتت لتلتصق بي كذرات معدنية تتكوم على قطبي بمغناطيس.
أنا رجل وحيد لا طريق لي غير التي تأخذني من بيتي في (جبل الجوفة) إلى وسط البلد، حيث كشك الوراق الذي كنت أمتلكه. وحيد بشكل لا أدري إن استطعتم فهمه أو لا في مدينة عالية الضجيج. لم أهتم بأحد، ولم يهتم بي أحد إلّا امرأة تجاورني ولا أدري من أين أتت، وما هي قصتها. لم أرها تخرج من بيتها الذي يقع في الطابق الثاني لبناية قديمة تواجه بيتي، رأيتها مرات قليلة في الشرفة لا يظهر من وجهها سوى عينين من وراء النقاب وهي تنشر الغسيل. في إحدى تلك المرات ألقت لي بورقة وأشارت بيدها نحوها، التقطتها وكانت فيها كلمات قليلة: (تعال عندي بعد منتصف الليل، أريدك بأمر هام). لكنني لم أذهب، فلا فضول لديّ لمعرفة ما تريده مني، ولا رغبة جنسية رغم أنّي فكرت مثل غيري من الرجال باحتمال دعوتها لي إلى سريرها، لا يعني هذا أنّي قديس لكني مكتف بطريقة أعرف أنّها سلبية ومنفرة، فما أن يطلق جسدي نداءاته حتى أستلقي في سريري وأستحضر امرأة من روايات أغرمت بها، مثل إزميرالدا الغجرية الفاتنة يوم رقصت في احتفال المهرجين في رواية أحدب نوتردام، أراها تفتح باب الغرفة ورائحة عطرها النفاذ تسبقها، فتفيق تلك النيران المتوارية بي، تدور حول نفسها بفستانها الملون فأرى جسدها المصقول ومؤخرتها اللدنة. ترقص كأنّها تروض نحلا عند فم وردة في روحها، ثم تتعرى وتستلقي بجانبي فنروح في لذة تضرم جسدينا إلى أن ننتفض كوعل تلقى رصاصة في الجبين فارتعش واستسلم للسكون والبياض.
تذكرت جارتي حينما كنت مستلقيا في تلك العصاري، أحدق بطبقة رقيقة من طلاء سقف الغرفة الرطب المتعفن فوق رأسي مباشرة وعلى وشك السقوط، تتأرجح بفعل نسمة تشرين الثاني، الشهر الذي كان قد حلّ للتو. كنت أتخيّل لحظة سقوطها وإلى أيّ شكل ستؤول، وأتساءل عن كلّ ذلك المصير، فالأشياء لا تسقط جزافا. فكرة بدلت مسار العالم حينما هوت التفاحة على رأس نيوتن. يوم قالوا لي إنّ أمّي ماتت سمعت صوتا همس بأذني: (لقد سقطت). تلفت حولي فلم أجد إلّا أبي يبكي بصمت. لقد كان الصوت ذاته الذي أخذ يهمس لي منذ رحلنا من بيتنا الأول قبل خمسة وثلاثين عاما وتحديدا عام 1981. كان يمكنني أن أخبر أيّ واحد من عائلتي بشأنه، لكن من كان سيصدقني…
من البوكر إلى الغونكور.. هيمنة إفريقية ساحقة
لم تكد الأصداء تخفت قليلا بنيل جائزة نوبل للآداب لعام 2021 من قبل الروائي التنزاني الزنجباري تحديدا عبد الرزاق قرنح متخطيا كلّ المرشحين الأبديين لهذه الجائزة الرفيعة مثل هاروكي موراكامي وميلان كونديرا ومارغريت آتوود، حتى فوجئت الأوساط الأدبية بمنح جائزة بوكر لهذا العام إلى الجنوب إفريقي دامون غالغوت Damon Galgut عن روايته «الوعد». المفاجأة أتت من كونه مرشحا سابقا في القائمة القصيرة لسنة 2003 دون الوصول إلى النهاية، وللسنة الحالية، أو ما عبر عنه بقوله: «أأشعر بالقلق مثلما حدث عندما وصلت رواياتي للقائمة القصيرة… فأنت لبضعة أسابيع واحد من ستة فائزين، ثم فجأة هناك فائز واحد، والبقية يطويهم النسيان». رواية «الوعد» تسعى إلى تسليط الضوء على فترة ما بعد الفصل العنصري ومشاعر خيبة الأمل لدى فئة عريضة من شعب جنوب إفريقيا، وأن الوعد بتحقيق المساواة والحرية لم يتحقق على أرض الواقع.
الروائي السينغالي محمد مبوغار سار Mohamed Mbougar sarr وعن عمر 31 سنة يظفر بجائزة غونكور الفرنسية العريقة، وخلافا لكلّ التوقعات بأغلبية الأصوات للدورة الأولى للجنة التحكيم، وعن دار نشر صغيرة وشبه مغمورة، عن روايته «ذاكرة الرجال الأكثر سرية». الروائي السينغالي لم يكن فقط أصغر فائز بهذه الجائزة منذ سنة 1976، بل كان أول فائز إفريقي بهذه الجائزة من جنوب الصحراء. الرواية، فضلا عن حنكتها السردية بشهادة لجنة التحكيم، تستمد قوتها من فكرة مذهلة حقا، فهي تستوحي قضية الكاتب المالي بامبو أولوغيم (1940-2017) الفائز بجائزة روندو الفرنسية سنة 1968، ثم اتّهم بالسرقة الأدبية ما أرغمه على الرحيل من فرنسا، والاختفاء كلية والانقطاع عن الكتابة، أمام عجزه عن الدفاع عن نفسه في مواجهة سلطة الإعلام الفرنسية القوية. الرواية تعود إلى الموضوع الجديد بخصوص علاقة الغرب بإفريقيا على مستوى الإبداع الأدبي خصوصا والثقافي عموما، ونظرة الاستعلاء المتحكمة في هذه العلاقة. لذلك ينبغي أن نفهم جيدا كيف جاء تصريح محمد مبوغار سار عقب فوزه بالجائزة، على هذا النحو من الحذر الشديد والوعي القوي بهذا التوتر القائم بين النظرة الغربية إلى الإبداع غير الأوروبي بصفة عامة والإفريقي بصفة خاصة: «آمل ألا يكون سبب فوزي هو أنني إفريقي، وأرجو أن يكون النص هو الأساس خلف هذا الخيار. أشكر لجنة التحكيم على قرارها، لكنني لست غافلاً عن القضايا السياسية التي قد تكون وراء هذا الاختيار، وآمل أن يكون الأدب هو الدافع الأول وراء اختياري، الأدب الجميل والنبيل والخالد».
أمين معلوف… الثقافة أو الهاوية
بشير البكر
يقرر بطل رواية أمين معلوف الأخيرة، «أخوتنا غير المتوقعين» (الترجمة العربية: أخوتنا الغرباء)، الانسحاب والحياة في جزيرة أعطاها معلوف اسم «انطاكيا». والبطل رسام صحافي يقوم بتدوين يومياته. وعلى أرض الجزيرة ينقطع عن العالم، لكنه يتابع الأخبار من خلال الانترنت. وحين تتوقف الكهرباء يتوقف الانترنت، ويخمن أن كارثة كونية وقعت. وبالفعل كانت على وشك الوقوع لولا تدخل من أتباع فيلسوف يوناني قديم، قدموا الدواء للبشرية. وتشكل الرواية ما يشبه المرثية للعالم الذي أصبح في الأعوام الأخيرة «مجرد ساحة معركة للجشع والكراهية، حيث صار كل شيء مغشوشاً من فن، وفكر، وكتابة، ومستقبل». لذا يحتاج الكوكب إلى أن «يبدأ من الصفر».
يختلف معلوف عن الكثيرين من أقرانه من الكتّاب الفرانكفونيين، من بلدان المغرب العربي ومن لبنان حتى. فهذا الكاتب، الذي يعيش في صمت، فعلاً، ويكرس وقته للأدب، لا يهمه الصخب ولا الظهور الميديوي الذي فتن الكثيرين وأغواهم. كما لا نغفل أن معلوف هو أيضاً كاتب سياسي، بمعنى امتلاكه حساً سياسياً حاداً، يظهر جلياً في مقالاته السياسية والفكرية والتأملية، كما عمل في صحف ومجلات سياسية، وثقافته الشاملة تمنحه قوة الإقناع والجدل، كما أنها مكّنته من فرصة استثمار رائع لقراءته المتعددة، فأعطى القراء نصوصاً عذبة ومذهلة. وهو، فوق كل شيء، لم يسقط في دائرة «عرب الخدمة»، ولا المستعدين للتصديق على النظرات الاستشراقية، التي ما زالت تنظر إلى عالمنا العربي بتعالٍ ودونية واستخفاف. وقدم ذاته على نحو مختلف منذ أن شرع في كتابه «الحروب الصليبية كما يراها العرب»، وهو دعوة لقراءة الآخر، لفهمه ومصالحته، بدلاً من تأجيج حرب الحضارات والديانات. وخلال كتابته لروايته الأولى «ليون الإفريقي»، التي ظهرت العام 1986، وهي رواية حققت نجاحاً كبيراً جداً، اكتشف الكاتب شغفه وانجذابه للتخييل على حساب الصحافة. وتوالت أعماله التخييلية، لكنه لم يكتف بالتخييل، بل تعداه إلى الكتابات الفكرية والتأملات، ومن هنا ظهر كتابه اللافت: «الهويات القاتلة». وهو رد واعٍ وذكي على كل الأطروحات التقسيمية، والتي تريد فرض صراع الهويات والحضارات… وهناك من رأى فيه علاجاً للكثير من الأمراض التي تهدد المجتمعات الديموقراطية. ولعل ما أثير في فرنسا، خلال أعوام حكم نيكولا ساركوزي (2007-2012)، حول نقاشات الهوية الوطنية، يكشف ضحالة الواقع السياسي الفرنسي، مقارنة مع وعي الكاتب اللبناني، وما يدور الآن من حملة تحريض يقودها المرشح الرئاسي إريك زيمور ضد الإسلام والمهاجرين، يعبّر عن أزمة عميقة يعيشها بلد الأنوار بسبب السقوط الحر نحو القاع.
أمين معلوف يقترح مراكمة الانتماءات والانفتاح على الآخر/الآخرين. وليس غريباً اختياره لشخصية ليون الإفريقي، الشخصية الكوسموبوليتية والباحثة عن التعدد. والكاتب، أي كاتب، لا يعرف متى يعود للحديث عن نفسه وجذوره، أو أنه يمارسها، بطريقة مواربة، وهنا يمكن الزعم أن كل كتابة تخييلية هي كتابة أوتوبيوغرافية بامتياز. ولعله عاد إلى أصوله وجذوره اللبنانية، في رواية «صخرة طانيوس»، وهي رواية عن المنفى، منحت صاحبها أرقى جائزة أدبية فرنسية «الغونكور» العام 1993، لتكرسه الكاتب العربي الثاني الذي ينال هذه الجائزة الراقية بعد المغربي الطاهر بن جلون. وكذلك الأمر مع روايتي «التائهون» التي صدرت العام 2013 و«إخوتنا الغرباء» هذا العام. تدور أحداث الرواية الأولى أوائل العام 2001 ، وهي في جزء منها مرثية لعالم ما قبل 11 سبتمبر، قبل أن يتصاعد الضغط للانحياز بين الهويات المتحاربة المفترضة، نحو صدام كارثي. بينما كتب الثانية قبل وصول فيروس كورونا، وعجل بنشرها حين تفشى في العالم، ليطرح رؤية خيالية لإنقاذ العالم، الهاجس الذي لا يفارق هذا الكاتب الكوني.
يحاول أمين معلوف، جاهداً، بكل ما استطاع، وعبر أجناس كتابية متنوعة أن يدافع عن مثله الأعلى في الحياة، التسامح والتصالح مع الآخر المختلف، فهو القادم من بلد فسيفساء وبلد تعددية، يريد لهذه التعددية أن تنجح في كل مكان. وهو القادم من بلد يطل على بحر تقاسمته وتتقاسمه حضارات وثقافات مختلفة، وأحياناً متصارعة، يريد تغليب حوار الثقافات وحوار الحضارات، على كل نزوع لنفي الآخر وسلبه حقه في الحياة وحقه في الاختلاف، من أجل الوصول إلى مصالحة.
كتابة أمين معلوف عالمة وممتعة. لا تحس فيها بأي تنازل لا للقارئ، كي يدخل في لعبة «الجمهور عاوز كده» فيخسر أدبه وينحط، ولا للغرب، باعتباره مقيماً في الغرب.. إنه من طينة كبار الكتّاب الذين لا يعنيهم ما يقول الآخرون. لهم رسالة وسيقولونها، مهما كانت الظروف، وهنا تكمن قدسية الكتابة. نصوص أمين معلوف تخلق قارئها النوعي، الذي يظل وفياً للكاتب، وهو سر الإقبال الكبير الذي تعرفه نصوصه وكتاباته، إن في العالم العربي أو في العالم. ولأن معلوف يريد أن يقول أشياءه، فهو يستخدم مختلف الأجناس الكتابية ليعبر عنها، فها هو كتابه القديم نسبياً: «اختلال العالم»، الذي صدر العام 2009 يضمنه الكثير من أفكاره المبعثرة في مختلف كتاباته وكتبه. نقرأ فيه ثلاثة فصول شيقة وثرية: الانتصارات الخادعة، شرعيات تائهة، ويقينيات متخيلة. بالإضافة إلى خاتمة عنونها: فترة ما قبل تاريخ طويلة. وضمن الانتصارات الخادعة التي يتطرق لها الكاتب معلوف: يعلق على ما يبدو، على الأقل في نظر الغطرسة السياسية الحكومية الأمريكية، من انتصار جيش الاحتلال الأمريكي في العراق.
يكتب، واصفاً حالتنا في الزمن الغابر: «حين يذهب بي تفكيري إلى أن أحد أكابر الشعراء الكلاسيكيين في اللغة العربية يدعى المتنبي، أي من ادعى النبوة (بصفة حرفية)، لأنه كان يجوب في شبابه العراق وأرض الجزيرة وهو يدعي هذا الشيء. في زمنه، في القرن العاشر، كان ادعاء النبوة يسبب عند الناس هزاً لأكتافهم وسخرية وتقطيباً للحواجب، لكنه لم يمنع المؤمنين من الاستماع إلى الشاعر وإظهار الإعجاب بموهبته. لو حدث الأمر، اليوم، لأعدم من دون محاكمة ولتَمّ قطع أطرافه، من دون أي شكل آخر من المحاكمات». ويكتب وكأنه يستشرف اليوم في نهاية العام 2021، بعد رحيل الأمريكيين عن العراق: «لن تُشفى أمريكا من صدمتها العراقية، ولنْ يُشفى العراق من صدمته الأمريكية. سيكون ثمة عشرات الآلاف من القتلى الجدد بين طوائفه. طوائفه الضعيفة لن تعثر أبداً على مكانها في العراق. لا يتعلق الأمر فقط بالمندائيين أو الأيزيديين، لكن أيضاً بالآشوريين الكلدانيين، الذين يكفي اسمهم لتذكيرنا بلحظات رائعة من مغامرتنا الإنسانية الكبيرة»…
ويتحدث في ذلك الكتاب وكأنه يرى أمامه رائد اليمين المتطرف إريك زيمور في فرنسا: «العالم، بالفعل، يعيش ظروفاً صعبة وقاسية وقيماً انعزالية، من قبيل الأنانية «بعدي الطوفان»، في حين أنه يتوجب علينا أن نخرج من «شرعياتنا القديمة»، أي «نحو الأعلى» وليس «نحو الأسفل». ويقترح الكاتب من أجل الخروج «من الأعلى» من هذا «الاختلال» الذي نعيشه: «تبني سُلّم قِيَم مرتكزاً على أولوية الثقافة. بل أقول مرتكزاً على الخلاص عن طريق الثقافة». ولذلك تقترح روايته الأخيرة حلاً من طريق الفلسفة يقوم به أتباع الفيلسوف اليوناني أمبادوقليس (إخوتنا غير المتوقعين) الذين هم «أقل وحشية منا، وأكثر موثوقية، وأكثر احتراماً لمصير الضعفاء. لكنهم أقوياء إلى درجة مثيرة للخوف»، ويعدد الأسباب التي تجعله مؤمناً بوظيفة وأهمية الكتابة: «لهذه الأسباب، وأخرى غيرها، أنا مقتنع بأن سُلَّمنا للقِيَم لا يمكن أن يتأسس اليومَ إلا على أولوية الثقافة والتعليم. وإن القرن الواحد والعشرين، وكي نستعيد الجملة التي ذكرناها سابقاً، ستنقذه الثقافة أو سيهوي». ويفسر رأيه: «قناعتي لا ترتكز على أية عقيدة مؤسسة- بل فقط على قراءتي لأحداثِ عصري. لكني لا أظل لا مبالياً لكون الديانات التقليدية الكبرى التي أعيش معها تتضمن حثاً على الشيء نفسه: يقول نبي الإسلام: «حبر العالِم أقدس من دم شهيد» و«العلماء ورثة الأنبياء» و«اطلبوا العلم ولو في الصين»، و«اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد». وفي التلمود نجد هذه الفكرة القوية جداً والمؤثرة: «العالَم لا يحتفظ بتماسكه إلا بفضل نفَس الأطفال الذين يدرسون».