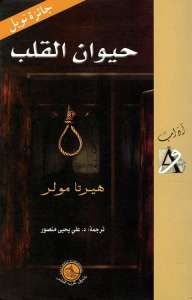إنّ تمثيل المرأة في جائزة نوبل في شتى مجالاتها المعرفية والإنسانية مازال يشكو من الضعف من حيث النسبة والقيمة. كما لا يخفى أنّ جلّ هذه الجوائز، خاصة منها جائزة نوبل للآداب تسير، منذ تأسيسها، في اتّجاه تعزيز نوع من المركزية الغربية أوروبيا وأمريكيا على حساب قارتين متميّزتين آسيا وإفريقيا. وبلغة الأرقام، نكتشف أن جائزة نوبل للآداب على الخصوص، منذ تأسيسها سنة 1901 وإلى حدود السنة الأخيرة، لم تنلها من السيدات سوى 16 أديبة، مقابل ما يفوق 100 أديب، دون إغفال الغياب التام لأيّ حضور لتمثيل نسائي وازن عربيا وإفريقيا. لذلك أصبح من الضروري أن تهتم الأكاديمية السويدية بقضية التنوع وتمثيل الجنسين بطريقة مختلفة وعادلة، والانفتاح على الإبداع الأدبي خارج مركزيته الغربية المحددة في قطبيه الأوروبي والأمريكي.. حتّى لا تكون جائزة نوبل للآداب، كما قال الأكاديمي الأمريكي بروتون فيلدمان، في كتابه (جائزة نوبل.. تارخ العبقرية والجدال والحظوة): «إنّ الجائزة تُرى على نطاق واسع بوصفها سياسية… متنكرة في قناع أدبي».
إعداد وتقديم: سعيد الباز
نالت الكاتبة الفرنسية آني إرنو Annie Ernaux، من مواليد 1940، جائزة نوبل للآداب سنة 2022. انطلقت مسيرتها الروائية برواية «الخزائن الفارغة» التي اعتبرت بأنّها «أكثر مشاريعها طموحاً، والذي أكسبها شهرة دولية ومجموعة كبيرة من المتابعين وتلاميذ الأدب»، كما أشادت لجنة التحكيم لجائزة نوبل للآداب بأسلوبها الروائي قائلة: «الكاتبة الفرنسية تميزت بشجاعة ودقة سريرية في اكتشاف الجذور والابتعاد عن القيود الجماعية للذاكرة الشخصية». أمّا الشاعر اللبناني إسكندر حبش ومترجم روايتها «الاحتلال» إلى اللغة العربية، فيبرز خصائص أسلوبها الروائي وتميّزه عبر مسار طويل بقوله: «تبدو آني إرنو، بدون أدنى شك، واحدة من أكثر الروائيات الفرنسيات حضورا وأكثرهن شهرة على الساحة الأدبية الفرنسية المعاصرة. فكل كتاب من كُتبها لا بدّ وأن يسيل الكثير من الحبر والمتابعات الصحفية والنقد. ربّما يعود ذلك إلى موضوعاتها التي تتقاطع مع سيرتها الذاتية. هذه السيرة التي بدأت العام 1940 في مدينة «ليلبون» حيث نشأت في كنف عائلة متواضعة، في «إيفتو» (منطقة النورماندي). جاء موت شقيقتها البكر بمرض «الدفتيريا» قبل مولدها ليسم حياتها اللاحقة. وبعد أن تابعت دراستها في الآداب المعاصرة، درّست اللغة الفرنسية، وتزوجت في العام 1964 من رجل ينتمي إلى البورجوازية الصغيرة. صدرت روايتها الأولى «الخزائن الفارغة» العام 1974 واستمرت في التدريس حتى العام 1977. وحين انفصلت عن زوجها العام 1980 كانت قد أنجبت طفلين. في العام 1984 نشرت رواية «الساحة»، كتاب سردي صغير استدعت فيه صعودها الاجتماعي الذي جعلها تبتعد عن أهلها، وتفترق عنهم. جاء كتاب «الساحة» ليشكل العمل-المفتاح، لما عُرف في ما بعد باسم تيار «التخييل الذاتي»، وإن كان أول من استعمل هذا المصطلح الكاتب شارل دوبروفسكي… بدءا من ذلك الكتاب، بدأت كتابة إرنو تتركز على سبر أغوار الحميمي، أكان ذلك عبر شكل الرواية «الأوتوبيوغرافية» (السيرة الذاتية) أو عبر شكل اليوميات، إذ تخلّت عن القصة المتخيلة التقليدية، لتركز على تلك الرواية المستمدة أحداثها من سيرتها، حيث تتقاطع فيها التجربة التاريخية مع التجربة الفردية. من هنا أصبحنا نجد أن كل رواية من رواياتها، تدور حول تيمة/ موضوعة معينة. ففي كتاب «امرأة»، تتحدث الكاتبة عن أمّها، وعن الانتظار العاشق في كتاب «شغف بسيط» وعن الإجهاض في كتاب «الحدث»… عبر لغة خالية من أيّ تزيين أسلوبي. في روايتها «الاحتلال»، نجد موضوعة الغيرة التي تنسج حولها قصة جميلة… فلا تشذّ رواية «الاحتلال» عن المشروع الروائي الذي تعمل عليه إرنو منذ بدايتها: أن تقدّم لنا، في كلّ مرة، جزءا من حياة، حدثا عابرا أو بالأحرى تفصيلا عاديا من تفاصيل الحياة التي نمرّ بها والتي تشكل جزءا منها… إلّا أنّها تفاصيل واسمة بكل تأكيد، ربّما لأنّها في النهاية تشكّل مرجعا ما في سلّم الوجود. لحظات هي التي تؤسس بدون شك جوهر الحياة الكبير. «ما من حقيقة أقلّ من أخرى»، هذا ما تقوله آني إرنو في روايتها «الحدث». حياة متقطعة، تقدمها إلينا الروائية الفرنسية من كتاب إلى آخر، لذلك تبدو رواياتها كأنّها لعبة «بازل»، حيث تشكّل كلّ واحدة منها قطعة منفردة، لكن إن جمعناها معا، لظهرت أمامنا الصورة أو اللوحة بشكل متكامل.
ثمة خاصية أخرى تتمتع بها إرنو وهي أسلوبها، فهي بالتأكيد تملك أسلوبا خاصا بها. ربما يعتبره البعض أشبه بأسلوب اليوميات الحميمية، أي أسلوب بدون تزاويق أو ادعاءات، من هنا هذه المهارة في أن تجعلنا نعتقد وكأنّ ما تكتبه، من كتاب إلى آخر، ليس سوى يومياتها الحقيقية ومن دون أيّ تبديل أو تعديل. ومن كتاب إلى آخر، تنجح إرنو في بناء عملها الأدبي، الذي يذهب مباشرة إلى الأساسي إلى الداخلي، إلى الحميمي، من دون أيّ تعقيدات أو التفافات. يذهب عبر هذه الكثافة المكثفة التي تفتح، في الوقت عينه، حقولا متعددة للقراءة الخاصة أمام القارئ.
لويز غليك.. عجلة مشتعلة تمرّ فوقنا
الإعلان عن فوز الشاعرة الأمريكية لويز غليك Louise Glück سنة 2020 كان مفاجئا لعدة اعتبارات، فالشاعرة الأمريكية، وإن كانت معروفة في بلادها ونالت العديد من الجوائز والتقدير على المستويين الرسمي والأكاديمي، ظلت مجهولة خارج أمريكا. وصفت لجنة نوبل قصائد لويس غليك الشعرية: «صوتها الواضح الذي يجعل الوجود الفردي عالميا بجمالها الصارم» وكذلك أنّها «تكتب قصائد تبدو بسيطة بشكل مخادع». كانت لويز غليك المرأة السادسة عشرة التي تحصل على جائزة نوبل للآداب وأوّل شاعرة أمريكية تحظى بها. على المستوى العربي تحضر لويز غليك من خلال بعض المختارات المترجمة، من بينها ترجمة سامر أبو هواش «عجلة مشتعلة تمرّ فوقنا» ولمى سخنيني «قصائد للحب والحياة في أفق الموت». يصف لنا سامر أبو هواش شعر غليك: «تتحرك غليك ضمن مجالين يفصل بينهما خيط رفيع غالبا ما تنجح في الحفاظ عليه: مجال العادي، السردي، الأتوبيوغرافي، اليومي، والواقعي. والمجال الآخر الإيحائي، الملغز، الميتافيزيقي، الخرافي أو الأسطوري». أمّا لمى سخنيني فتصور لنا العوالم الشعرية للشاعرة لويز غليك: «هذا شدّني كثيرا للتعمق في قراءة شاعرة أشاد بها العالم. ولكن عندما بدأت أقرأ لها بعمق كما هو المعتاد لي عند بدء ترجمة أيّ نص لم أترجم منه من قبل، دخلت في عوالم غليك شديدة الواقعية، في الوقت ذاته هي عوالم مسحورة أسطورية شدّتني بشِباك من شوق إلى الأبطال الأسطوريين للإلياذة، إذ أعادت الشاعرة بناء قصصهم بما يتوافق مع خيالها الخصب وتجربتها الحياتية الغنية. فهي توظف تجربة هذه الشخصيات في مواجهة حقائق ينكرها معظم الناس، كالشيخوخة والطفولة المبكرة والموت، والحياة في ظلال الموت فهذا العمل الفذ الهادئ ولكنه الفولاذي لإعادة التكيف مع التجربة الحياتية الحية جعلني أقارن حياتي بحياتها وأقيس تجاربي بتجاربها، لأستنتج بأنّ حياة النساء المبدعات متقاربة في الشكل والمحتوى». وفي العموم فإنّ معظم شعر لويز غليك يرتكز على موضوعات مستمدة من حياتها الخاصة مثل الطفولة والموت والحياة العائلية، نفسُها الشعري مطبوع بذاتية منكسرة ومجروحة واقع مؤلم ومفعم بالخسارات، لكنّه يتخذ أحيانا منحى أسطوريا وميثولوجيا. فوز لويز غليك هو فوز للشعر أوّلا الذي قليلا ما ينال حظه من جائزة نوبل للآداب، وهو أيضا فوز يعيد الاعتبار للمبدعات وينصفهن من الإقصاء المجحف.
أولغا توكارتشوك.. روائية بنفس ملحمي
تمّ تتويج الروائية البولونية أولغا توكارتشوك Olga Tokarczuk سنة 2018 بجائزة نوبل للآداب، وجاء في بيان لجنة التحكيم الوصف التالي لمسيرتها الروائية: «إنّ الخيال السردي الذي يصوّر بشغف موسوعي عبور الحدود بوصفه شكلا من أشكال الحياة». تعتبر أولغا توكارتشوك أكثر الروائيين البولونيين حضورا في بلدها وأكثر غزارة في الإنتاج الروائي وتميزا على مستوى أوروبا الشرقية بصفة عامة. لذلك كان من اللافت للنظر فوزها بجائزة مان بوكر الدولية السنة الماضية عن روايتها «رحّالة»، التي كانت بلا شك السبب في إلقاء الضوء على هذه الروائية التي تحظى في بلادها بشهرة كبيرة بفضل أعمالها الروائية ذات النفس الملحمي والتاريخي خاصة روايتها «كتب يعقوب»، وكذلك بسبب مواقفها المثيرة للجدل ضدّ اليمين المحافظ أو الإشارة في تصريحاتها أو بعض أعمالها إلى أنّ بلدها خلال تاريخه قديما وحديثا ارتكب مذابح في حق الغجر واليهود. الكاتبة البولونية تكاد تكون مجهولة عربيا، إذ لا وجود لترجمات لأعمالها سوى بعض المقتطفات النادرة، وهي في العموم كاتبة ذات توجه ليبرالي مع مسحة يسارية، لكن يبدو من مسارها الروائي المتنوع والغزير أنّها أفضل كتاب جيلها. من جهة أخرى أتت أولغا توكارتشوك إلى الرواية من بوابة علم النفس باعتبارها معالجة نفسية، إضافة إلى الخلفية التاريخية لبلدها بولونيا كما يتأكد في هذا المقطع الروائي: «درست علم النفس في مدينة شيوعية كبيرة وكئيبة. كانت شقتي تقع في مبنى استخدمته الشرطة السرية النازية كمقر خلال الحرب. ذلك الجزء من المدينة كان مبنيا على أنقاض الغيتو، وإذا نظرت جيّدا، يمكنك ملاحظة ارتفاع هذا الحي بثلاثة أقدام فوق بقية الأحياء في البلدة. ثلاثة أقدام من الأنقاض. لم أشعر بالراحة هناك أبدا، وبين المباني الشيوعية والساحات التافهة كانت هناك رياح دائما، وكان للهواء الفاتر طعم خاص بالمرارة، يلسعك في وجهك. في نهاية الأمر كان مكانا للموتى، بغض النظر عن كل محاولات البناء. مازالت لديّ أحلام متعلقة بالمبنى الذي كان يحتوي على صفوف الدراسة: ممراته الواسعة التي لطالما بدت منحوتة في الصخر، وقد هدأ دبيب الأقدام من روعها، الحواف البالية للدرج، الدرابزين المصقول بأيدي العابرين، آثار مطبوعة في الفراغ. ربّما لذلك كنّا مسكونين بتلك الأشباح.
عندما كنّا نضع الجرذان في متاهة، واحد منها فقط كان يناقض بسلوكه النظرية المعتمدة، فيرفض الاكتراث لفرضيتنا الذكية. قد يقف على رجليه الخلفيتين، غير مبالٍ إطلاقا بالجائزة في نهاية الطريق، مزدريا نظرية الإشراط البافلوفي، وقد يصوّب نظره نحونا لمرة واحدة ثمّ يستدير، أو يصرف انتباهه باتّجاه المتاهة متأملا إيّاها بلا عجلة. قد ينظر إلى شيء ما في الرواق الجانبي، محاولا جذب الانتباه. وقد يصدر صريرا مشوشا، بعد ذلك، الإناث تحديدا، بغض النظر عن الواجبات، كنّ يسحبن أنفسهن إلى خارج المتاهة. أما عضلات الضفدعة المفلطحة، فقد تنثني وتستقيم تبعا للنبضات الإلكترونية، لكن على نحو لم يتم شرحه بعد في كتبنا المدرسية. كانت تصدر إيماءة في وجهنا، وأطرافها تعلن التهديد والتهكم، كما لو أنها تهدم إيماننا المقدس بالبراءة الميكانيكية لردات الفعل النفسية.
تعلمنا هناك أنّ العالم قابل للوصف، وحتّى التفسير، بواسطة إجابات سهلة لأسئلة ذكية. كما لو أنّ العالم في نواته كان خاملا وميّتا، محكوما بقوانين أسطورية كانت تحتاج إلى الشرح، والخروج إلى العلن، بمساعدة الرسوم البيانية إذا أمكن ذلك. نُصحْنا بالقيام بالتجارب، وباختراع النظريات لإثبات شيء ما. زُجّ بنا في أسرار الإحصاءات، عُلّمنا التصديق أننا نتسلح بهكذا أداة يمكننا أن نفهم كيف يعمل العالم، وأنّ 95 في المائة أكثر أهمية من الخمسة المتبقية. ولكن إن كان هناك شيء واحد أعرفه الآن هو أنّ أيّ أحد يرغب في فهم العالم، يجب عليه أن يفهم علم النفس. الذهاب إلى الفيزولوجيا وإلى اللاهوت، بالمقابل، سيوفر دعما قويا في مسألة الروح، بدلا من تضاريس السيكولوجيا اللزجة. ثمّة ما يقوله الناس عن علم النفس، كاختصاص يختاره الناس ليس من أجل العمل، ولا بسبب الفضول أو امتهان مساعدة الآخرين. وقد اكتشفت أنّ للاختيار سببا واضحا ومحددا. أعتقد أنّ كل شخص لديه خلل خفي وعميق، ولكن بلا شك الجميع يحب أن يعطي انطباعا بالذكاء والحيوية. لكن الخلل يكون مبطنا ومموها بإتقان، عندما ندخل الامتحان. تنهار طابة المشاعر المعقدة بشدة، مثل تلك الأورام الغريبة التي تظهر أحيانا في الجسد البشري، ويمكن رؤيتها في أيّ متحف يعرض جثثا مشرّحة. ذلك يطرح سؤالا آخر: ماذا لو كان الناس الذين يديرون حياتنا من تلك النوعية، وكانوا يعرفون ما يقومون به فعلا؟ في هذه الحالة، سنكون ورثة على نحو مباشر. عندما ناقشنا في عامنا الثاني، عمل الميكانيزمات الدفاعية، وجدنا أننا نخضع لقوة جزء من روحنا، بدأنا نفهم أنّ الإنكار لم يكن للوصول إلى صورة واضحة وعقلانية، بل كان عبارة عن ألاعيب صغيرة سمحنا لأنفسنا بأن نلعبها، بدلا من أن نرى العالم كما هو، بلا أيّ شيء لحمايتنا، بصدق وشجاعة: أنكرنا، لأن ذلك كان سيكسر قلوبنا.
ما تعلمناه هو أننا مصنوعون من دفاعات، من دروع ومصفحات، هو أننا مدن تقوم في أساسها الهندسي على جدران وأسوار ومعاقل ومخابئ. بمرور الوقت صرنا في الصف الثالث، وبعد كل امتحان واستمارة ودراسة قمنا بها على بعضنا البعض، صارت لديّ تسمية للخطأ الذي أواجهه. كان الأمر بمثابة اكتشاف لاسمي السريّ، الاسم الذي يدعو صاحبه إلى المبادرة.
لوقت طويل تمرّنت على التجارة لكنّي لم أمارسها. في إحدى البعثات العلمية، عَلِقْتُ في مدينة كبيرة من دون أن يكون لدي أيّ مال، وكنت أعمل خادمة، فبدأت الكتابة. كانت قصة رحلاتي التي أضعها في كتاب، وكنت أريد أن يقرأها الناس في القطار لأنّي كنت أكتب لكي أقرأ ما أكتبه. كان كتابا صغيرا بحجم شطيرة صغيرة من ساندويش. وكنت قادرة على التركيز، بغض النظر عن أنّ أذني أحيانا اكتسبت شكلا عملاقا، وصارت تلتقط تذمر الآخرين والأصداء والهمسات. كانت أصواتا مصفّاة تخترق أحد الجدران. أصوات تأتي من بعيد».
سفيتلانا أليكسييفيتش.. ليس للحرب أيّ وجه أنثويّ
حازت سفيتلانا أليكسييفيتش Svetlana Alexievitch، التي ولدت سنة 1948 من أب بيلاروسي وأم أوكرانية، جائزة نوبل للآداب سنة 2015. عملت مراسلة في العديد من الصحف والمجلات الأدبية، ومزجت بين الصحافة والكتابة السردية التي هي بالأساس حوارات مع شهود عيان لأهم الأحداث التي شهدتها بلادها مثل الحرب العالمية الثانية، والحرب السوفياتية الأفغانية وكارثة تشيرنوبل… اضطرت إلى مغادرة بلادها بيلاروسيا سنة 2000 بسبب ما تعرضت له من تضييق واضطهاد.
تعتبر سفيتلانا كتاباتها «وقائع أدبية من التاريخ العاطفي للمواطن السوفياتي»، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي الذي تعتبر تاريخه مظلما وبشعا حيث تقول: «إذا كان لنا أن ننظر إلى الوراء من تاريخنا، سواء ما قبل انهيار الاتحاد السوفياتي أو بعد انهياره، سنجد أنّ هذا التاريخ عبارة عن قبر جماعي ضخم وحمام من الدم الساخن، بل هو محادثة دائمة بين الجلادين والضحايا». نالت سفيتلانا شهرة عالمية بفضل كتابها «ليس للحرب أيّ وجه أنثوي» الذي تقول في مقدمته: «… عامان كنت فيهما أفكّر أكثر ممّا ألتقي وأسجّل. قرأت الكثير. عن أيّ موضوع سيكون كتابي؟ إذا، كتاب آخر عن الحرب… وعلام؟ لقد حدثت آلاف الحروب، قصيرة ومديدة، معروفة ومجهولة. لكن ما كُتب عنها أكثر. كثيرون كتبوا، رجال عن الرجال، وهذا أدركته على الفور. كلّ ما نعرفه عن الحرب، نعرفه من خلال «صوت الرجل». نحن جميعا أسرى تصوُّرات «الرجال» وأحاسيسهم عن الحرب، أسرى كلمات «الرجال». أمّا النساء فيلذن بالصمت. لم يكن أحد ليسأل، باستثنائي أنا، جدّتي أو أمّي. حتّى النساء اللواتي كنّ في الجبهة، يلذن بالصمت. وحتّى إذا ما بدأن يتذكّرن، فيتذكّرن حرب «الرجال» وليس حرب «النساء». يتمسّكن بالقانون. فقط في البيت، يذرفن الدموع مع زميلاتهنّ في الجبهة، ويشرعن بالحديث عن حربهنّ، التي لا أعرفها، ولا أحد يعرفها. في جولاتي ومهمّاتي الصحفية، كنت غير مرّة الشاهدة الوحيدة، والمستمعة الوحيدة لنصوص وأقوال جديدة كلّيا. وكنت أشعر بالصدمة، كما في طفولتي. في هذه القصص كانت تظهر التكشيرة الرهيبة للأسرار… عندما تتحدّث النساء فليس لديهنّ، أو تقريبا ليس لديهنّ ما اعتدنا قراءته وسماعه: كيف قتل بعضهم الآخرين، ببطولة، وانتصروا عليهم. أو انهزموا أمامهم. وأية معدات تقنية لديهم وأيّ جنرالات. القصص والأحاديث النسائية مغايرة تماما، وعن شيء آخر تماما. لحرب «النساء» ألوانها الخاصة، وروائحها الخاصّة، وأضواؤها الخاصّة ومساحات مشاعرها المميّزة، وكلماتها الخاصّة. إنّها تخلو من الأبطال والمآثر القتالية التي لا تُصدّق. وفيها لا يشعر الناس وحدهم بالألم والمعاناة، بل وكذلك الأرض، والطيور والأشجار. وكلّ من يعيش معنا في هذا الكوكب. إنّهم يتألمون بدون كلمات، وهذا أشدُّ وأرهب.
ولكن، لماذا؟ تساءلت غير مرّة في نفسي. لماذا لم تدافع النساء، اللواتي دافعن عن أرضهن وشغلن مكانهنّ في عالم الرجال الحصري، عن تاريخهن؟ أين كلماتهنّ وأين مشاعرهنّ؟ هن أنفسهن لم يصدّقن. ثمة عالم كامل مخفيّ عنّا. لقد بقيت حربهنّ مجهولة…
أريد كتابة تاريخ هذه الحرب، حرب النساء.
…
أمر غريب، المهن الحربية لهؤلاء النسوة: مرشدة صحّية، قنّاصة، رامية رشّاش، قائدة سلاح مضادّ للطائرات، خبيرة ألغام، وهنّ الآن: محاسبات، مخبريات، دليلات سياحية، مدرّسات… أدوار غير متطابقة هناك وهنا. يتذكّرن، وكأنهنّ لا يتذكّرن أنفسهنّ، بل فتيات أخريات. إنّهنّ يشعرن بالذهول من أنفسهنّ. وعلى مرأى منّي «يتأنسن» التاريخ، ويغدو شبيها بالحياة العادية. وتظهر إضاءة أخرى.
نلتقي محدّثات مذهلات، ثمّة في حياتهنّ صفحات يمكنها منافسة أفضل صفحات الأدب الكلاسيكي. الإنسان يرى نفسه بوضوح من الأعلى، من السماء، ومن الأسفل، من الأرض. أمامه الطريق كلّه: طريق إلى الأعلى، وآخر إلى الأسفل، من الملاك إلى الوحش. ليست الذكريات سرد عاطفية أو غير عاطفية للواقع الغائب، بل ولادة جديدة للماضي، عندما يتحوّل الزمن إلى الوراء. بادئ ذي بدء، الذكريات إبداع. ففي ذكرياتهم يبدع الناس، و«يكتبون» حياتهم. وقد «يكملوا» أو «يعيدوا صياغتها». هنا، يجب أن تكون على أهبة الاستعداد، أن تكون يقظا. وفي الوقت نفسه، يذيبُ الألم أيّ زيف ويقضي عليه… اقتنعت بأنّ النساء البسيطات… يتصرفن بصدق وشفافية، وبعبارة أدق، وكأنهنّ يستخرجن الكلمات من ذواتهنّ، من أنفسهنّ، وليس من الصحف والكتب المقروءة».
هيرتا مولر.. حيوان القلب
حصلت هيرتا مولر Herta Müller على جائزة نوبل للآداب سنة 2009 ونوهت بأعمالها الروائية لجنة التحكيم لأنّها «بتكثيف الشعر ووضوح النثر، صورت حياة المحرومين». تنتمي هيرتا مولر إلى الأقلية الألمانية في رومانيا، التي تعرضت كثيرا للاضطهاد في الحقبة الشيوعية. معاناة لم تسلم منها هيرتا مولر وأسرتها، لذلك استمدت مادتها الروائية من حياة هذه الأقلية المضطهدة: «إذا لزمنا الصمت أثرنا الضجر وإن تكلمنا ضحكوا علينا.
قال إدغار: كنّا قد أطلنا الجلوس أمام الصور على الأرض ومن الإطالة في الجلوس أحسست بخدر في ساقيّ.
متى تسكن الكلمات أفواهنا ندوس على أشياء كثيرة بالقدر ذاته الذي تدوس فيه أقدامنا العشب، صمتنا وقعه ثقيل أيضا.
صمت إدغار… !
-لا أستطيع اليوم أن أتخيّل قبرا لكن بإمكاني أن أتخيّل حزاما ونافذة وعقدة ورمٍ وحبلا. أرى أنّ كلّ موت في جميع أشكاله يشبه الكيس.
قال إدغار: متى سمع أحد ذلك، سيحسبك مجنونة. وحين أفكّر بذلك أتخيّل أنّ كلّ ميت يترك خلفه كيسا مليئا بالكلمات. كما أتخيّل أيضا الحلاق ومقص الأظافر لأنّ الموتى لا يعودون بحاجة إليهما، وأنّهم لن يضيّعوا زرا أبدا.
لربما كانوا يحسّون على العكس منّا، أن الدكتاتور خطأ لا غير.
قال إدغار: كان لديهم الدليل، إذ كذلك كنّا خطأ في نظرنا. كنّا في هذا البلد مجبرين تحت وطأة الخوف أن نمشي ونأكل وننام ونحب شخصا ما حتّى نحتاج من جديد إلى الحلاق ومقص الأظافر.
فالإنسان الذي لمجرد أنّه يمشي ويأكل وينام ويحبّ إنسانا ما، ويرتكب فظائع، يصبح عند ذاك مخلوقا موغلا في الخطأ أكثر منّا وخطأ بالنسبة للجميع، وخطأ فاحشا.
العشب ينمو في الرأس، فإن تكلمنا يتمّ قصه وتقليمه غير أنّه يقصّ أيضا إذا صمتنا. ثم تنمو الوجبة الثانية من العشب تليها الثالثة كما تشاء. وبالرغم من كلّ هذا نحن محظوظون.
جاءت «لولا» من جنوب البلاد وكان يبدو عليها أنّها قادمة من منطقة مبتلاة بالفقر. ولا أعلم أين ذلك المكان في جسدها الذي يدل على بلوى الفقر، قد يكون باديا على عظمي الخدين أو حول الفم، أو في عمق العينين. من الصعب قول شيء كهذا سواء أكان ذلك مرتبطا بالمكان أو الوجه. فكل منطقة في البلاد كانت تئن تحت الفقر كما نراه مرسوما على كلّ وجه. أمّا منطقة «لولا» فربما كانت أكثر فقرا كما كانت تبدو للناظر في عظمي الخدين أو محيط الفم أو عمق العينين. كانت تبدو منطقة لا ترتقي إلى منظر طبيعي.
-الجدب يلتهم كل شيء عدا الخراف والبطيخ وأشجار التوت. لكن جدب المنطقة لم يكن الدافع الذي حملها على الهجرة إلى المدينة وعلى قدر معرفتي، تدوّن «لولا» في كراستها، فإنّ الجدب لم يكن بذي تأثير. فهو لا يدرك مدى ما أعرفه بل يقتصر إدراكه على معرفة كينونتي أي من أكون. أن أصبح شيئا في المدينة، تكتب لولا، وأعود بعد أربع سنوات إلى القرية، وبشرط ألّا يتمّ ذلك على الطريق الترابي بل من بين أغصان أشجار التوت.
… قرأت في ما بعد في كراسة «لولا»: إنّ ما يحمله المرء من تلك المنطقة إلى الخارج ينعكس على وجهه من الداخل.
كانت «لولا» تنوي دراسة اللغة الروسية لأربع سنوات. اجتازت امتحان القبول بيسر نظرا لوجود مقاعد شاغرة كثيرة في الجامعة كما هي الحال في المدارس الريفية. لم تكن اللغة الروسية موضع رغبة للقليل من الناس فحسب. فالرغبات صعبة المنال، تكتب «لولا»، الأهداف أسهل منالا. فالرجل الذي يدرس اختصاصا ما، يملك أظافر نظيفة. فهو يأتي معي لأربع سنوات لأنّ رجلا مثله يعلم أنّه سيد في القرية، وأنّ الحلاق يأتي إليه في بيته ويخلع أحذيته أمام الباب. لا خراف بعد اليوم، لا بطيخ بعد اليوم، سوى أشجار التوت لأننا جميعا نملك أوراق الشجر».
دوريس ليسينغ.. سجون نختار أن نحيا فيها
وصفت الأكاديمية السويدية دوريس ليسينغ Doris Lessing (1919-2013) عند منحها جائزة نوبل سنة 2007 بأنّها «شاعرة ملحمية للتجربة النسائية أمعنت النظر في حضارة منقسمة، مستخدمة الشكّ وقوة الرؤية والتوقد». رغم سجلها الروائي الحافل، نالت الجائزة متأخرة جدا عن عمر 88 سنة بسبب ميولاتها الشيوعية وآرائها الحادّة تّجاه المجتمعات الغربية. عاشت دوريس ليسينغ في روديسيا الجنوبية «زيمبابوي» حاليا وكانت من أشدّ المناهضين لنظامها العنصري، يتّضح ذلك في كتابها الشهير «سجون نختار أن نحيا فيها» من مقاطعه: «نشأتُ في بلد كانت تهيمن فيه أقلية بيضاء ضئيلة على الأغلبية السوداء، هي «روديسيا الجنوبية القديمة». كانت مواقف البيض إزاء السود جامحة: متعصبة وبغيضة وجاهلة. والأهم لنا هنا، كان افتراض أنّ تلك المواقف غير قابلة للمنازعة أو التغيير، رغم أنّ نظرة بسيطة على التاريخ كانت ستُنْبِئهم (والعديد منهم كانوا أناسا متعلّمين) أنّ حكمهم حتما سيمضي، وأنّ يقينهم مؤقت. لم يكن مباحا لأيّ عضو في هذه الأقلية البيضاء الاختلاف معها. وكلّ من فعل جوبه بالنبذ الفوري، وبأنّهم لا بدّ أن يعدلوا عن رأيهم، أو يخرسوا، أو يرحلوا. أثناء نظام البيض، الذي استمرّ تسعين عاما، والتي لا تعدّ شيئا في حسابات التاريخ، كان الخارج عليهم كافرا وخائنا. وكما اقتضت قواعد تلك اللعبة المعلومة، لم يكن يكفي أن يقتصر القول على «فلان يختلف معنا، نحن ملّاك الحقيقة الدامغة»، بل لا بد أيضا من إضافة: «فلان شرّير وفاسد ومنحرف جنسيا»، وهكذا.
… قد يقول قائل إنّ هذه نظرة قاتمة للحياة، وإنّ هذا معناه، على سبيل المثال، أننا يمكن أن نقف في قاعة مكتظة بأصدقاء أعزاء، ونحن ندرك أنّ تسعة أعشارهم سيصيرون أعداء لنا إذا رغبت الجماعة في ذلك، وسوف يرشقون نوافذ بيوتنا بالحجارة، إذا جاز لنا القول. كما يعني أنّك لو كنت عضوا في مجتمع وثيق الصلة ببعضه، فعليك أن تعي أنّك باختلافك مع أفكار هذا المجتمع تخاطر بأن تتحوّل في نظرهم إلى تافه ومجرم وشرّير. إنّها عملية آلية تماما، يكاد الجميع يتصرفون هكذا تلقائيا في مثل هذه الأحوال. ولكن هناك دائما أقلية لا تنحو هذا النحو، وأخال أنّ مستقبلنا، مستقبلنا جميعا، يرتكن عليها. وعلينا التفكير في سُبُل نُعلّم بها أبناءنا تعزيز هذه الأقلية وليس تبجيل الجماعة، كما نفعل الآن في أغلب الأحيان.
كلام كئيب؟ أجل هو كذلك، ولكن كما نعلم جميعا، النمو صعب ومؤلم، وما نتحدث عنه هو نمو أنفسنا كحيوانات اجتماعية. فالبالغون الذين يتمسّكون بكل صنوف الأوهام المريحة والمفاهيم المطمئنة لا ينضجون. ويصدقُ ذلك علينا كجماعات أو كأفراد في جماعات، حيوانات جماعية. يسهل عليّ الآن قول «حيوان جماعي» أو «الحيوان الاجتماعي»، فقد أصبح مألوفا الآن قول إننا بني البشر كنّا حيوانات، وأنّ قدرا كبيرا من سلوكنا تعود جذوره إلى السلوك الحيواني السابق».
نادين غورديمر.. سيدة الأدب الإفريقي
حصلت نادين غورديمير Nadine Gordimer سنة 1991 على جائزة نوبل للآداب عن مجمل أعمالها الروائية المناهضة للعنصرية في بلادها جنوب إفريقيا. تُعْتبر غوديمير من كُتّاب الضمير الإنساني والمدافعة عن حقوق الإنسان والمساواة بين البشر، كما عُرِفت بمناصرتها للقضية الفلسطينية. أُطلق عليها لقب «سيّدة الأدب الإفريقي»، أمّا هي فتفضّل أن نلقب بـ«إفريقية بيضاء». في روايتها (شعب يوليو) نقرأ: (العربة «كارفان» من النوع الذي تفضله عائلة بيضاء من جنوب إفريقيا لتقوم بأعمال لا يمكن لعربة المدينة القيام بها، في يوم ميلاده الأربعين قام «بام» بطلائها باللون الأصفر حتى يمكنه استعمالها شتاء في رحلات صيد بالأدغال إلى عمق مائتي كيلومتر، وفي إجازات نهاية الأسبوع… قبل ولادة الأطفال كان «بام» يأخذ «مورين» إلى رحلات صيد بعيدة إلى «بوتسوانا»، ومرة أخرى إلى موزمبيق قبل أن تستقل عن النظام البرتغالي.
شراء العربة كان للمتعة… كالمتعة التي يجدها البعض في اقتناء النساء… عندما أحضر «بام» العربة إلى المنزل، شيء ما في ملامح وجه زوجته جعله يدافع عن شقرائه الجميلة التي تقاوم حرارة الجو بلونها الأصفر البهيج. حول العربة وقفت الزوجة والعائلة والأطفال سعداء كما لو أن امتلاكهم لأي شيء آخر لن يجلب لهم مثل هذا القدر من السعادة. ابتسمت له الابتسامة ذاتها التي تمنحه إياها عندما تندلع رغبته فيها وتتركه يفعل ما يريد.
كلما اختلفت الظروف والملابسات يحدث التحول في الأحياء والأشياء والرهان على البقاء لا يمكن الكشف عنه قبل أن تسفر الأحداث عن وجهها. كيف للمرء أن يعلم؟ … الأحداث المتوالية بالطريقة التي وقعت بها كانت أمرا ليس في حسبان أحد، وعلى غير المتوقع منها، كذلك كانت هوية الأشخاص ممن لهم دور في الأحداث، وأيضا الأغراض المختبئة خلف كل مجموعة من الظروف التي تبدو عادية.
بدأت الأحداث عادية مبتذلة تبعث على التشاؤم. جاءت اضطرابات عام 1980 في بطء وتثاقل… إضراب يلي إضرابا إلى أن أصبحت الإضرابات والانفجارات وإطلاق الرصاص من مفردات الحياة اليومية. وبينما كانت الحكومة في محاولات مستمرة لتقديم تنازلات لاتحاد العمال السود على شكل كلمات متقنة الصنع، تخفي بداخلها قيودا جديدة، كان العمال السود يكابدون الجوع والغضب والبطالة… والمتاجر والمصانع تُشْعل فيه النيران.
لا أحد يدري ما الذي يجري خارج نطاق المنطقة التي يعيش فيها: من أحداث شغب، وإشعال النار في الممتلكات، والاستيلاء على مقار الشركات الكبرى، وانفجارات في المباني العامة، والرقابة على الصحف، والشائعات، وما يجري على الألسنة هو كل ما تبقى للإذاعة والتلفزيون من مصادر تستقي منها المعلومات حول الثورة التي شملت كل أرجاء البلاد، وظل هذا الوضع وقتا طويلا.
محاسب البنك الذي قام «بام» بعمل تصميم لمنزله نقل له أن البنك بصدد وضع قيود على سحب العملاء لودائعهم، إذا لم تبد في الأفق أية علامة تشير إلى تحسن الوضع المتردي. سحب «بام» خمسة آلاف راند عملات ورقية، كذلك «مورين» سحبت 1750 راند من رصيدها في حساب التوفير الخاص بها، وحملته إلى المنزل داخل حقيبة المشتريات…
السأم هو الذي قاد تفكير «بام» و«مورين» إلى أنهما يعيشان طيلة حياتهما في مكان واحد، ووجدا نفسيهما فيه من البيض المنبوذين في قارة سوداء، وإلى أنه لم يعد هناك وقت لتصحيح ذلك… في شبابهما فكرا في السفر والعيش حياة جديدة في بلد آخر. ذلك كان في وقت يمكنهما فيه نفض أيديهما من وضع قائم، السود فيه منبوذون، والبيض يتمتعون بكل الامتيازات).