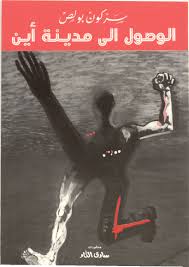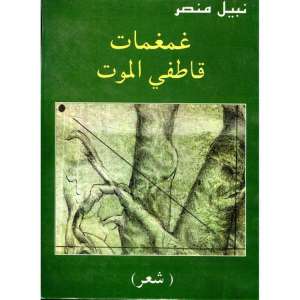عندما نتحدث عن الكتاب الأوّل فإننا نتطرق إلى تلك اللحظة التي ترسم الطريق لمسار أدبيّ متكامل، وملامح الشخصية الأدبية التي ستتشكل من خلال الأعمال اللاحقة. هنا، لا يمكن لنا أن لا نتجاهل الظروف الصعبة بل والمحبطة أحيانا، التي تصاحب هذه اللحظة الأساسية في كلّ حياة أدبية أو إبداعية. من الممكن، كذلك، أن يكون الكتاب الأول مجرّد مشروع يتيم يفقد توهجه وامتداده في الزمن وعبر إنتاج متلاحق تجسده أعمال أدبية أخرى. لكن في كل الأحوال، ومن خلال شهادات العديد من الكُتّاب، يمكن اعتبار الكتاب الأوّل نقطة الانطلاق والمرجع الأساسي لكلّ حياة أدبية، وبتعبير شاعر الشيلي الكبير بابلو نيرودا: «إنّ هذه اللحظة الفاتنة الساحرة المسكرة ذات الأنغام كأنها حفيف أجنحة عصفور يرفرف لأول مرة، ذات الألوان كأنها تفتق برعم يتبدّى في أعلى قمة لأول مرة، لهي الحضور الوحيد في حياة الشاعر».
إعداد وتقديم: سعيد الباز
بابلو نيرودا.. يا لديواني الأوّل
كان الشاعر بابلو نيرودا Pablo Neruda (1904-1973) من الشيلي رمزا من رموز اليسار في أمريكا اللاتينية برمتها، فضلا عن اعتباره شاعرا من كبار شعرائها الذي نال شهرة عالمية أهلته للحصول على جائزة نوبل 1971. كان بابلو نيرودا من أبرز النشطاء السياسيين وشيوعيا متحمسا جمع بين الالتزام بعمله الشعري وعمله السياسي بالجنة المركزية للحزب الشيوعي ومرشحا لرئاسة بلاده ما عرضه إلى النفي. لكن نبض الشعر كان دائما قويا خلال مسار حياته، مثل هذا المقطع من مذكراته الذي يصور فيه لحظة صدور أول أعماله الشعرية:
«في عام 1923، نشر ديواني الأوّل «شفقيات». كي أدفع تكاليف الطباعة كنت أواجه كل يوم صعوبات جمّة وأحقق انتصارات عظيمة، أثاثي القليل بيع إلى دار الرهائن، على عجل مضت ساعتي التي كان والدي قد أهداني إيّاها في وقار وجلال، إذ إنّها كانت ساعته الخاصة به… ولحقت بالساعة بذلة الشاعر السوداء. لقد كان صاحب المطبعة رجلا لا يرحم ولا يشفق إذ إنّه بعد أن أصبحت الطبعة جاهزة والأغلفة ملصقة، قال لي: «لن تأخذ ولا نسخة حتّى تدفع لي قبل كل شيء التكاليف كلها». ساهم الناقد الأدبي (ألونه Alone) في سخاء بدفع ما تبقّى عليّ… فابتلعتها حلاقيم صاحب المطبعة، وخرجت إلى الشارع وكتبي على منكبيّ بحذاء مهترئ ممزق، مجنونا من الغبطة والطرب.
يا لديواني الأوّل ! كان رأيي دائما هو أنّ عمل الكاتب ليس لغزا ولا هو بالمأساوي. بل إنّه، على الأقل بالنسبة للشاعر، عمل شخصي ذو منفعة عامة. إنّ ما هو أكثر شبها بالشعر هو رغيف خبز أو وعاء خزفي أو حفر على الخشب مشغول في طراوة وحنان، ولو أنّ الأيدي التي تصنع هذه التحف كانت بليدة غير متقنة. بيد أني أعتقد أنه ليس ثمة من صانع واحد يشعر، كما يشعر الشاعر، لمرة واحدة في حياته كلها، هذا الشعور الثمل نحو أوّل خلق ابتدعته يداه وجناه تيه أحلامه الذي لما يزل خافقا دافقا لحظة الإبداع. إنها لحظة أبدا لن تعود مرة أخرى، أعني لحظة الإبداع الأولى والفرح الأول بأول كتاب. قد ينشر في طبعات أخرى كثيرة أكثر إتقانا وأجمل مظهرا من طبعته الأولى، قد تنتقل كلماته وأشعاره لتسكب في كأس لغات أخرى مثل نبيذ يغني ويفوح في أمكنة أخرى من الأرض بعيدا عن موطنه، غير أنّ هذه اللحظة التي يولد فيها أوّل ديوان طازج المداد طري الورق، إن هذه اللحظة الفاتنة الساحرة المسكرة ذات الأنغام كأنها حفيف أجنحة عصفور يرفرف لأول مرة، ذات الألوان كأنها تفتق برعم يتبدّى في أعلى قمة لأول مرة، لهي الحضور الوحيد في حياة الشاعر».
(أعترف بأنني قد عشت) ص 63/64
غابريال غارسيا ماركيز.. من البدايات إلى مائة عام من العزلة
يقول غابريال غارسيا ماركيز، عن بدايته الأولى في عالم الكتابة، في كتابه «عشت لأروي»: «قبل أن أتمكن من القراءة والكتابة اعتدت على رسم الكاريكاتير في المدرسة أو المنزل، لكن الشيء المضحك في الأمر هو أنني عندما انتقلت إلى المدرسة الثانوية كانت لدي سمعة وشهرة الكاتب، على الرغم من أنني في الواقع لم أكتب شيئا، جاء ذلك على خلفية قراءاتي الكثيرة وتأبطي المتكرر للكتب حتى إذا ما دخلت الجامعة في بوغوتا (عاصمة كولومبيا) بدأت بتكوين صداقات ومعارف جديدة قدموني إلى كتاب معاصرين، ففي إحدى المرات قدم لي أحد الأصدقاء كتابا هو عبارة عن مجموعة قصص قصيرة كتبها فرانز كافكا، عدت بها إلى القسم الداخلي حيث كنت أقيم وبدأت قراءتها حيث كادت سطورها الأولى تسقطني من سريري، فقد كنت مندهشا حقا وأنا أقرأ «عندما استيقظ غريغوري سامسا ذات صباح من أحلام مضطربة قال إنه وجد نفسه في سريره وقد تحول إلى حشرة بشعة عملاقة». عند قراءتي لهذه السطور قلت لنفسي أنني لم أقرا مثلما قرأته الآن وبدأت على الفور بكتابة قصص قصيرة ذات مضامين فكرية نشرتها في الملحق الأدبي لجريدة «الإسبكتادور» لاقت حينها النجاح ربما لأن لا أحد في كولومبيا كان يكتب بتلك الروحية، كان معظمها يتحدث عن الحياة في الريف… في عام 1950 و1951 حدث أمر آخر أثّر فيّ وبميولي الفكرية حين سألت والدتي مرافقتها إلى «أراكاتاكا» حيث ولدت، كانت رحلتنا إلى منزلنا القديم الذي باعته العائلة وقضيت فيه سنواتي الأولى مناسبة لاستعادة ذكريات الطفولة، لكني صدمت بسبب أن المكان لم يطرأ عليه أي تغيير منذ كنت أعيش فيه وعمري ثماني سنوات واليوم أصبحت في الثانية والعشرين، البيوت، الناس، وكل شيء هناك بقي يعيش قديمه ومع أنني لست متأكدا ما إذا كنت قد قرأت بالفعل فوكنر بجدية أم لا، لكني أمام هذا المشهد لن تكون سوى تقنيته بالكتابة حاضرة أمامي لأكتب ما شاهدت، مع أني أراها مصادفة حيث وجدت ببساطة المواد التي كان لا بد من التعامل معها بالطريقة نفسها التي تعامل فوكنر معها. من تلك الرحلة إلى القرية عدت لكتابة روايتي الأولى «عاصفة الأوراق» حقيقة ما حدث لي في تلك الرحلة إلى «أراكاتاكا» كان أن أدركت أن كل ما وقع لي في طفولتي كان ذا قيمة أدبية تعرفت عليها الآن».
أمّا روايته التي فتحت له الباب إلى الشهرة والمجد الأدبي «مائة عام من العزلة»، فقد تميزت بكونها صاحبة أشهر افتتاحية: «بعد عدّة سنوات وأمام فصيل الإعدام، كان على الكولونيل أورليانو بويندا أن يتذكّر ذلك اليوم البعيد الذي اصطحبه فيه والده ليتعرّف على الثلج». لقد كانت الجملة وحدها إلهاما بعالم أسطوري وخرافي مكّن غابريال ماركيز من تسجيل تاريخ امتدّ لمائة عام لأسلاف غامضين ووقائع امتزج فيها الواقعي والسحري في تناغم كامل، بفضل قدرة ماركيز على السيطرة الكاملة على إيقاع الحكي وانسيابيته التامة. إتمام الرواية اقتضى من ماركيز 18 شهرا من العمل المضني والتفرغ دون موارد مالية سوى تدبير زوجته مرسيدس من خلال ما اقترضوه من الأصدقاء أو ما رهنوا من متاع البيت. عندما دقت ساعة الحقيقة وهمّ ماركيز رفقة زوجته مرسيدس بإرسال النسخة الأصلية للرواية إلى دار النشر «سود أمريكانا» عبر البريد، اكتشف الاثنان معا أنّ ما يمتلكانه لا يتعدّى 50 بيزو، بينما كلفة إرسال الظرف البريدي من حيث الوزن تتطلب 85 بيزو. وحتّى لا يعودان خائبين اهتدى الاثنان إلى حلّ وسط بإرسال الجزء الأوّل في انتظار الحصول على المال لإرسال الجزء الثاني. الحقيقة أنّ ماركيز وزوجته كانا قد استنفدا كل مواردهما المالية وسبل الاقتراض أضحت مستحيلة، وصار من الضروري رهن أيّ شيء في البيت. هنا بلغت الأمور ذروتها وأصبح من اللازم إمّا رهن الآلة الكاتبة أو خاتم الزواج. لكن الآلة الكاتبة مستبعدة جدّا بحكم أنّها المصدر الوحيد لرزق العائلة، أمّا خاتم الزواج، ورغم رفض غابريال لما له من فأل سيئ، فإنّ مرسيدس أصرت على رهن خاتم الزواج وإرسال ما تبقى من الرواية إلى الناشر معلّقة على ذلك بقولها: «الشيء الوحيد الذي ينقصنا هو أن تكون الرواية جيّدة»، وكأنّها تتنبأ بالنجاح غير المنتظر لرواية «مائة عام من العزلة» الذي واكبها منذ اللحظة التي خرجت فيها من المطابع، ما لم يتحقق لأيّ عمل روائي قبلها.
أمبرطو إيكو.. من السيميائيات إلى اسم الوردة
كتب الروائي الإيطالي أومبرطو إيكو روايته الأولى الشهيرة «اسم الوردة» في عقده الخمسين، وكان ذلك بالصدفة. مساره الأدبي بدأ من السيميائيات، روايته الأولى الناجحة قادته إلى خوض مغامرة الكتابة الروائية بعزم وثبات ونجاح متواصل. يحكي عن بدايته الأولى في الكتابة الروائية والظروف التي دفعته إلى الإقدام على هذه المغامرة المثيرة قائلا: «كتبت روايتي الأولى «اسم الوردة» سنة 1980، وبذلك لا يتجاوز عمر ممارستي لكتابة الرواية ثمانية وعشرين عاما، ولهذا السبب أعتبر نفسي روائيا ناشئا، وبالتأكيد واعدا، لم يكتب إلى حدّ الآن سوى خمس روايات، وسيكتب الكثير منها في الخمسين سنة المقبلة… في بداية سنة 1978 قالت لي صديقة كانت تشتغل في دار نشر صغيرة إنها طلبت من غير الروائيين (فيلسوف، سوسيولوجي… إلخ) أن يكتب كلّ واحد منهم قصة بوليسية صغيرة، فأجبتها بأنني لا أهتم بالكتابة الإبداعية، وأنني عاجز عن كتابة حوار جيّد. وقد ختمت ردّي بقول استفزازي: إذا كنت مضطرا لكتابة قصة موضوعها تحرّيات جنائية، فإنّ عدد صفحات الرواية لن يكون أقلّ من 500 صفحة، وستدور أحداث القصة في دير في القرون الوسطى. وشرحت لي صديقتي بأنّها لا تريد نشر كتاب حول التغذية الرديئة، وتوقف الأمر عند هذا الحدّ. وبمجرد ما عدت إلى منزلي بدأت أبحث في أدراج مكتبي لأعثر في النهاية على مسودة تعود إلى السنة التي سبقت هذا الحوار، يتعلّق الأمر بورقة دونت فيها أسماء بعض الرهبان. وقد نظرت إلى ذلك باعتباره دلالة على أنّ الفكرة كانت قد بدأت تختمر في داخلي، لكنني لم أكن واعيا بذلك. وفكّرت في أنّه سيكون مسليا تسميم راهب وهو يقرأ كتابا غريبا، هذا كلّ ما في الأمر. وتلك كانت بداية روايتي: اسم الوردة.
لقد تعلمت أشياء كثيرة وأنا أكتب روايتي الأولى: منها أنّ «الإلهام» كلمة سيئة… وكما يقول المثل القديم «إنّ العبقرية لا تغطي سوى 10 في المائة من الإلهام، أمّا 90 في المائة المتبقية فمصدرها الجهد الفردي».
سركون بولص.. الوصول إلى مدينة أين
…لا أدري إن كنت أكثر حكمة أو حماقة، فالكتاب الأول كان بالنسبة لي عاصفة عاطفية، فكرية، وجودية، ولا تنس أنّها بقايا ما أتيت به إلى أمريكا، وفي أمريكا بدا لي أن الكتابة باللغة العربية نوع من العبث، لذلك فقدت ثقتي باللغة العربية، لذا حينما عدت إلى الكتابة بعد سنوات من التوقف والانقطاع، أردت أن ألتهم كل شيء، أن أكتب عن الماضي والحاضر والمستقبل، وعن الموضوع الذي أعيش فيه، كل هذا دفعة واحدة، لذلك أعتبر كتاب «الوصول إلى مدينة أين» يعني فعلا ما أعنيه، أي أنك لن تصل أبدا، أي أنني لم أصل إلى أيّ مكان، وهذا ما أردت أن أقوله، ولكن بطريقة تشاكس اللغة العربية وأقانيم الشعر العربي، بحيث إنني أردت الوحشية في اللغة، فالصوت هناك صوت شاب مُدمر لكنه مليء بالعاطفة ويخاف أن يفقد علاقته بالماضي فقدانا كاملا، فهذه القطيعة كانت موجودة ومشروعة. لذا كان كتابي هذا هو حربي الخاصة ضد هذا الانقطاع والاندثار للأشياء والذكريات والبلاد واللغة.
لكن بعد «الوصول إلى مدينة أين» صدر لي «الحياة قرب الأكروبول» وهي مجموعة كُتبت معظم قصائدها في اليونان، وقرب «الأكروبول» فعلا، وبهذا المعنى كنت أقصد أن أخفف من الغربة، غربة الاغتراب المطلق، ولذلك أعتقد أن المناخ المتوسطي أفادني بحيث أصبح نوعا من الجسر بين الشرق الحقيقي وهو بالنسبة إليّ (العراق) وبين الغرب المطلق وهي (أمريكا). لذلك فإنّ المناخ المتوسطي أو الروح المتوسطية أعطتني فكرة (القلب) وهي الأكروبول. فهو نوع من المأوى للروح. وفي هذا الكتاب انفتحت تلك الاشتباكة مع الهوج، مع العصف، مع التحارب الروحي، مع المعركة التي كنت أخوضها أثناء وجودي في أمريكا، بين الشرق المطلق الذي هو الطفولة والماضي الحقيقي والواضح وبين الغرب المطلق-أمريكا.
أما في «الأول والتالي» فهناك انفتاح كامل، لأنني وجدت في الشعر شيئا جميلا هو (الإيقاع المنشرح) لاستجلاب الأشياء من العالم إلى القصيدة، لذلك تجد في هذا الكتاب، وقبله في «الحياة قرب الأكروبول» النفس الطويل، والأبيات الطويلة المنسرحة التي تجتذب أشياء وتفاصيل كثيرة في نفس واحدة. وبدأت أستثمر الشكل الجديد الذي وجد لبوسه الجديد في الكتاب الأخير، وهو أن تكون القصيدة عالما قائما بذاته، والكتاب مجموعة من العوالم المتجانسة.
… إنني أكتب ببطء شديد ولا أستعجل النتائج. هذا ليس نوعا من التفاخر على الإطلاق، هو نوع من الرذيلة التي أحاول أن أجعل منها فضيلة… في تجربة الكتابة ببطء، أجد عبر السنين، أشياء تعترضني وأتركها تتخمر. هذا التخمر هو السرّ عندي في إيجاد الثغرات في القصيدة بين الكلمات، التفاصيل الدقيقة، العلاقات. القصيدة عندي هي خريطة من العلائق بين الكلمات الموجودة على هذه الصفحة. هذه العلائق تكون في النهاية نوعا من الطاقة التي تُدوّن في هذا الشكل. كل قصيدة هي، إذا، عالم يكاد أن يكون كاملا. وإذا لم يكتمل أتركه كما هو إلى أن أجد العلامات التي تقودني بطريقة سرية وغير منطقية على الإطلاق. ليس في الشعر منطق، ولكن ما يمكن أن أسميه غياب المنطق هو نوع من السعي أيضا إلى إيجاد الأشياء المتكاملة، أي هذه العلاقات بين المسميات… بين الأماكن الحسية والأماكن الباطنية أو الأحاسيس… سمّها ما شئت. هي في النهاية ما يؤلف حدسي أنا ويحمل صوتي…
لطيفة باقا.. الجزء المليء من الكأس
يشبه الحديث عن الكتاب الأول، الحديث عن العشق الأول وفي بعض الحالات قد يشبه الحديث عن الطفل الأول. في أحد الأفلام الفرنسية القديمة، سمعت أحدهم يقول إنّ «الطفولة هي مجموعة من المرات الأولى» أحببت على الفور هذا التعريف وتبنّيته منذ ذلك الحين. يندرج الكتاب الأوّل، إذن، ضمن تلك التجارب الخارقة التي نعيشها للمرة الأولى، تلك التجارب المفعمة بدهشة البدايات.
لمجموعتي القصصية الأولى «ما الذي نفعله؟» حكاية طريفة جدا. فهي لم تكن أبدا عبارة عن مخطوط أوّلي يضم أوراقا كثيرة مبعثرة مشدودة بحبل، كما في أفلام الأبيض والأسود، أو محفوظة داخل ظرف كبير كما يصف ذلك بعض الكتاب الكبار في حديثهم عن إصدارهم الأوّل (كان غارسيا ماركيز، مثلا، يبهرني وهو يتحدث عن المسار العجيب الذي قطعه مخطوط مائة عام من العزلة). كتابي لم أرقنه أبدا، كان عبارة عن نصوص كتبتها بخط يدي الرديء الذي لا يفكّ طلاسيمه أحد غيري وأرسلتها متفرقة لبعض الجرائد الوطنية. كنت في تلك الأثناء سنة 1991 أجري تدريبا صحفيا بجريدة «أنوال» في القسم الثقافي. عندما أخبرني الأستاذ سعيد يقطين عن جائزة اتّحاد كتاب المغرب للأدباء الشباب التي كانت تتهيأ لدورتها الثانية. شروط المسابقة كانت تتوفّر فيّ باستثناء شرط واحد «أن يكون النصّ مرقونا»، كان عدد من النصوص قد نشر على صفحات الجرائد وبعضها لم ينشر بعد. لم أكن أتوفر على حاسوب في ذلك الزمن ولا آلة كاتبة (وكم كنت أحلم في ذلك الوقت بامتلاك آلة كاتبة أحملها معي أينما ذهبت، مثل روائيي النصف الأول من القرن العشرين)، بعد تفكير «عميق» سآخذ بعين الاعتبار كل الإكراهات المرتبطة بضيق الوقت وضيق ذات اليد، سوف أكتفي بقصّ نصوصي من الجرائد والعمل على تكبيرها بواسطة النسخ أمّا بالنسبة للنصوص غير المنشورة والتي كانت لا تزال حبيسة خط يدي، فقد لمعت في ذهني فكرة اللجوء إلى سكرتيرة «النادي النسوي» التابع لحزب الاستقلال بحيّنا، سترقن لي تلك السيدة الطيبة النصوص مقابل درهمين للورقة الواحدة وبعد الانتهاء سأحمل المجموعة إلى إحدى القريبات بمقرّ عملها لتستنسخ لي منها خمس نسخ مع تجميعها وتغليفها.
كتابي الأوّل اقترن بالجائزة، أو ربما كانت الجائزة هي التي ستجعله يرى النور أساسا، كما سيمنحني أيضا عضوية اتحاد كتّاب المغرب… سوف تظلّ لحظة لمس «ما الذي نفعله؟» لأوّل مرّة لحظة راسخة في الذاكرة. ما زلت أتذكر مكالمة الشاعر محمد الأشعري الذي اتصل من مكتبه بجريدة الاتحاد الاشتراكي ليطلب مني المجيء لتسلّم النسخ. في تلك اللحظة الفارقة التي كان يناولني فيها كتابي شعرت أنه يسلمني طفلي الأول (يبدو أنّ مشاعر الأمومة المتضخمة لديّ منذ البداية) وفي غمرة ذلك الفرح الفريد من نوعه والكاسح، احتضنت النسخ الثلاثين ونزلت أكاد أطير فوق أدراج العمارة حيث مكتب الجريدة بالرباط. المسافة التي تفصلني عن محطة الأتوبيس الحافلة بالواقع والضجيج، كانت قد تلاشت تماما… يحلو لي اليوم أن أتذكر مشهدا جميلا لن يتكرر أبدا في حياتي: في مقعد خلفي في الحافلة «العادية» رقم 16 المتّجهة من باب الحد بمدينة الرباط إلى حي تابريكت بمدينة سلا، كانت تجلس فتاة مغربية سمراء من الطبقة الوسطى تضمّ إلى صدرها نسخا من كتابها الأول… وتبتسم بسعادة.
هذا هو الجزء المليء من الكأس. هناك جزء فارغ بالتأكيد: انعدام التوزيع، الاستقبال النقدي البارد، غموض المسار الذي سيقطعه الكتاب، ضرورة اقتنائه بمالي الخاص من حين لآخر من المكتبة الوحيدة التي تتوفر على نسخ منه، لأمنحها للأصدقاء الظرفاء الذين يفضلون الكتب المُهداة، الموقعة والمجانية… التي لا يقرؤونها طبعا.
هناك، بالتأكيد، ما يُفسد علينا لذة الكتاب الأوّل.
محمد حمودان.. ديواني الأول
في خريف 1992، نشرت كتابي الأول بباريس وكان ديوانا شعريا، بعدها بثلاث سنوات غادرت المغرب إلى فرنسا وكان رحيلا مصيريا لم أدر كيف سترسم خلاله حياتي ولا حتى مسار كتاباتي. أذكر أنني حشوت في حقيبتي، ضمن ملابسي، بالإضافة إلى بعض الكتب وقاموس قديم، حفنة من النصوص. إنّها كتابات هجينة أو أنها غير مصنفة تفيد أنني كنت أكتب عندما كنت مستقرا بالمغرب. وعلى الرغم من أني أكتب بطريقة متقطعة فإني فلحت في الاستئناس بالكتابة حتى إذا استقررت بفرنسا، وأمام حقائق غير منتظرة انتصبت أمامي، واصلت الكتابة بمواظبة وإفراط كبيرين وكذلك بجنون أحسست معه بألم في الرسغ وتشنج في العضلات.
كنت أكتب في كل مكان، في الحانات وخلال تتبعي للمحاضرات في الجامعة كما في العمل. ومع تراكم النصوص بدأ يراودني إغراء النشر بإصرار إلى أن قررت أن أتقدم بمخطوطي إلى ناشر. ولم أكن لأقدم على المغامرة لو أنّي لم أتيقن في داخلي بأنّ الأشعار التي يتضمنها الديوان تشكّل عقارا أدبيا متميزا. وقد تعززت قناعتي مع الرسالة المتحمسة والمادحة التي خصّني بها المدير الأدبي لدار النشر وهو نفسه شاعر وبعدها التقديم الذي شرفني به الشاعر عبد اللطيف اللعبي قائلا: «كيف لنا أن لا نرافق حمودان في هذا الحفل الغرائبي للكلمة؟»… سأرافقه فلا أدع الكلمات تلدغه… إنه في رحلة استكشاف أساسية، في هذا الطريق المحفوف بالمخاطر والمبتوت بكل الكلام الذي تجاوزه الزمن». كلام احتفالي غريب. شعائر لفظية. كلمات. لدغ. أسنان حادة. قطع لحم ممزق. فم ملطخ بالمداد والدم.
أكتب كما لو أني أصارع أطياف اللغة. على ركح اللغة نفسها وتحت وطأة اللعنة والرحيل والتيه: «أخرجْ، تِهْ في كل ردهات السكر/عاودْ احتلال الفراغ الأبيض/ المظلم/ البعيد/ والعميق. التيه والرحيل/ روحي والعالم في مبارزة/ روحي والعالم على نحيب… أو ارحلْ على وطأة الرجم/ صوتك/ يستسلم/ للقصيدة/ في الحين، أتمثلني ملاكا ساقطا، بدل آدم في «الجنة المفقودة» القصيدة الفاتحة، كما هو الحال في قصائد أخرى. منحرف وغير ممتثل: «لطيف/ أب الوطن/ يضع الغلال على يدي/ ينخر عيني/ هذه الليلة/ لطخت أسوار روما/ بقصيدة أهديتها/ لسبارطكوس/».
كان العالم يغير وجهه. رأس المال –المال المثمر- له الغلبة على عكس أوهام الأتوبيات. لقد انتصر. ضربت عاصفة الصحراء في الشرق وأفرزت نظاما عالميا جديدا.
لقد أضحى الحب ضربا من خيال، وأمّا المنفى فإنها تجثم مزيدا مزيدا. تبقى الكلمة. هشة لكنها ثمينة. وأخيرا لأنّ القصيدة التي سأشيد كشجرة بلوط صعبة الهدم. كما شجرة بلوط/ تنتصب القصيدة/ يوقف الزمن لعبة المروع/ كما شجرة بلوط/ تنتصب القصيدة/ كل الفضاءات تتسع/… كما شجرة بلوط تنتصب القصيدة/ كما لو أني مأخوذ/ مع رجع الضوء.
كما شجرة بلوط/ تنتصب القصيدة/ أتكلم/ يتهادى صوتي مع الريح/ كما يحلو لإعصار مكسّر للمرايا.
عبد الرحيم الخصار.. أخيرا وصل الشتاء
حين اتّصل بي من هاتفه المحمول رئيس مصلحة النشر في وزارة الثقافة ليخبرني أنّهم سيطبعون مجموعتي الشعرية الأولى «أخيرا وصل الشتاء» ضمن سلسلة الكتاب الأوّل، ظننت الأمر مزحة من طرف أحد أصدقائي، ذلك أنّه كان صعبا أن تطبع الوزارة لنا نحن –الشعراء المبتدئين- كتابا، وحين طبعنا صرخنا قليلا كي تخرج الدواوين من مخابئ الوزارة وتصل إلى المكتبات، المكتبات التي لم تعد ترحب بالشعر.
لقد قضينا سنوات نكافح من أجل أن نرى أسماءنا في الملاحق الثقافية الوطنية الأساسية، أرسلنا الكثير من المظاريف إلى صناديق البريد التي يفتحها المشرفون على تلك الملاحق، لكننا لم نر نصوصنا هناك، كانت تُحال في أحسن الأحوال على الصفحات الشبابية. رضخنا للأمر وقلنا ربما سنبقى «شبابا» في الشعر لمدة طويلة، فقد جرت العادة في المغرب حينها وقبلها أن تمر بقصائدك من صفحات الشباب أولا ثم تتحول بالتدريج إلى الملحق الثقافي، إنّه أمر شبيه بالترقية في العمل، فلم يكن مقبولا أن ينشر الملحق لشاعر في عامه الثامن عشر مثلا، والذين سبقونا هناك سبقونا أحيانا لأنهم أكبر منا تجربة وأحيانا لأنهم أكبر منا سنا فقط. دفعنا ضيق النشر نحن مجموعة من الشباب إلى تغيير الوجهة نحو أماكن بعيدة عن صناديق البريد بالعاصمة. بدأت حينها أنشر بمجلات وجرائد في إسبانيا ولندن والنمسا.
كان خبرا سعيدا جدا بالنسبة لي أن تطبع وزارة الثقافة ديواني الأول، إنها سعادة خاصة لم يكن يحسّها سوى أولئك الذين مرّوا بالتجربة، تجربة الكتاب الأول، إنّه بمثابة باب تفتحه نحو إقامة كبيرة قد تطول وقد تقصر، قد تتنامى وتتطور وقد تتوقف، المهم أنّها إقامة في منزل الأدب.
كان الأمر شبيها بانتصار صغير وسرّي وفردي بعد فترة من تسكع النصوص هنا وهناك، فقد نشرت أول قصيدة لي في الصحافة سنة 1994 بجريدة جهوية كانت تصدر بالدار البيضاء اسمها «الموقف» أعتقد أنها توقفت في الأعداد الأولى، كان صاحبها يتردد على المؤسسة التي كنت أدرس بها في الدار البيضاء، وهي تابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، قدمني المدير له وقال له: «هذا شاعر» فطلب مني نصوصا ونشر أحدها. لم أكن راضيا بشكل كبير على تلك النصوص، ومن حسن الحظ أنها لم تنشر في الكتاب الأول. لقد كانت بلا لون، فهي أحيانا متأثرة بلافتات أحمد مطر، وأحيانا بغزليات نزار قباني، وفي حالات قليلة بقصائد محمود درويش، وفي ما بعد ستتأثر كثيرا بالتجربة الصوفية لدى العديد من الشعراء. عشرات النصوص تخليت عنها دون أسف، لأنها لم تعد تعني لي شيئا أكثر من كونها عتبات يدوسها المرء قبل الدخول فعلا إلى إقامة الكتابة، لكنني بالمقابل لا أستطيع أن أتخلى اليوم عن جملة واحدة في ديواني الأول «أخيرا وصل الشتاء»، لم أنشر فيه سوى النصوص التي كتبتها ما بين 2000 و2003، ومعظمها كتبته في خلوتي بجنوب المغرب، في السنوات الأولى للعمل، في حديقة صغيرة للمكان الذي كنت أقيم فيه، وتحديدا تحت شجرة ليمون. وثمة شيء مما أشرت إليه تحمله كلمة «أخيرا»، كأنني أقول حينها «أخيرا وصل الشعر».
كان ديواني الأول الذي طبعته وزارة الثقافة قد صدر في البداية بخطأ كبير في المطبعة، لم يتعلق الأمر بتلك الأخطاء التي تعرفها الكتب عادة، بل صدر كتابي بشكل غريب، فقد تداخل مع كتاب شعري آخر، حيث يجد القارئ صفحة لي والصفحة الأخرى لشاعر آخر إلى نهاية الديوان. قرر بيت الشعر بالمغرب حينها منحي تنويها عن هذه المجموعة، ولا أعرف إن كان قد استند إلى المجموعة المصححة أم إلى المجموعة المختلطة.
في الأمسية التي نظمتها الوزارة من أجل تقديم هذه الإصدارات الجديدة… نبهت رئيس مصلحة النشر تلك الليلة لهذا الخطأ، ووعدني بتدارك الأمر. بعدها بأشهر استلمت ثلاثين نسخة من المجموعة، وبدلا ماديا قيمته خمسة آلاف درهم، كان هذا المبلغ مهما بالنسبة لي، بغض الطرف عن قيمته، ذلك أننا كنّا نتراهن نحن مجموعة من الشعراء الشباب على طبع كتبنا على الأقل بالمجان، في مغرب تعوّد الناشرون على أخذ المال من الشعراء مقابل نشر كلماتهم.
نبيل منصر.. الكتاب الأول
كانت لي قصائد، مجرد قصائد عارية تبحث عن مسكن. كان ذلك في بداية عقد التسعينات. ملاحق الثقافة بالمغرب اعترفت بي ناقدا، وتلكأت قليلا في أن تعترف بي شاعرا. لذلك عولت، منذ البداية، على أن أحمل حقائبي الشعرية وأيّمم صوب المشرق العربي، في ما يشبه هجرة رمزية، أردت من خلالها إيجاد محتضن لقصائدي الوليدة. في وقت كانت «القابلة» الشعرية بالمغرب تشترط بطاقة حزبية. كنت كشاعر وليد ملزما بأن أقطع حبل ولادتي بنفسي، وأنا أصرخ مستنشقا هواء لم يكن نقيا تماما.
كان الفضاء ملبّدا، وكنت مجبرا على المشي أطول وقت ممكن، منفردا باتجاه الشرق. كان لبنان بالنسبة لي ولصداقات ستتوطد لاحقا، مكانا شعريا بامتياز.
جيل الحرب الأهلية كان على الأبواب. وهو لم يكن يطالب فقط بحقه في الهواء الشعري، بل تمكّن بسرعة من خيوط تدبير الصفحات الثقافية لإعلام حداثي ومتنور. وكانت مغامرة «الناقد» التي احتضنتني وليدا، فغسلت دمائي ووضعت بداخلي شمسا لا تأفل. هذا مسكني الأول، الذي جعلني أتحرّر وأتدفأ وأكتب وأشرئب بعنقي بعيدا باتجاه بيوت ثقافية أخرى.
ارتبط عملي بالجبل، بقرية تزارين بزاكورة، كنت لسنوات، أعيش فوق جبل. كنت أشرف من عزلتي الصغيرة فوق قمته، على سماء زرقاء وواحة ملبّدة هجرها الماء. كانت «حوامة» الشعر كثيرا ما تحلّق فوق بيتي، دافعة إيّاي إلى مضاعفة العزلة وكتابتها على ضوء الشمعة، بعد أن تنام القرية ويستنفد أهل الجبل نصيب ليلتهم من كهرباء البنزين، كان حظي الملكي من الليل. كان أزيز الكهرباء وضوؤه الشاحب في الحديقة، يجتذب حشرات مجنحة، كثيرا ما استأنست بحضورها قبل أن ينطفئ العالم وتمدّ الشمعة لسانا من لهب آخر. في هذا الوقت بالذات، كنت أخرج قلما لأخط كلمات أنتزعها من عتماتي، فكانت تتراءى لي بين مشي وتعثر مثل عقارب سوداء تعترضها حواجز لا مرئية في الطريق، فتضطر للوقوف لحظات، قبل أن تستأنف سيرا بإبرة متأهبة. لقد كان هذا السمّ الزعاف هو ترياق عزلتي الصغيرة، التي أثمرت كتابي الأول.
الاستئناس بلهب الشمعة على الكتابة لم يكن مفصولا عن لهب القراءة. خيالات ملتهبة كانت تندلع بالداخل، بينما أمرّر عينين متوقدتين على خطوط قادمة من أصقاع مختلفة. الشعر والرواية والفلسفة ونظريات الأدب كانت تمدّني بترياق البقاء، في وجودٍ عار استعنت عليه ببعض الكؤوس. لم أضع حدّا لعطش قديم، من دهاليزه انبثقت قصائدي الأولى، عاقدة مع الجفاف هدنة تساعد على البقاء.
خضرة غابرة للواحة المترامية، انبعثت طراوةً صعبةً في كلماتٍ امتصت وجودي. هكذا، أستحضر قصائد أهملتُ كثيرا منها، قبل أن أعقد العزم على أن أختار منها ما يصلح كتابا شعريا، أدخل به إلى بانتيون الشعر العربي.
إنّه كتابي المخطوط الأول. صرت أقضي أوقاتا في قراءته وإعادة ترتيبه، حالما بأن أجد له العنوان المناسب.